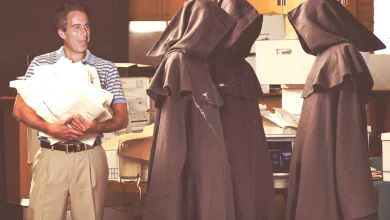بقلم: أ. د. عباس علي شلال
مدير مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
يشهد العالم المعاصر تحولات غير مسبوقة في مجال الاتصال وتدفق المعلومات، بفعل ثورة الإنترنت والفضاء الرقمي المفتوح، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على بنية التفكير والسلوك الاجتماعي والسياسي والثقافي للأفراد والجماعات، لقد أتاح الانفتاح التكنولوجي فرصًا هائلة للتواصل والمعرفة، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام أنماط جديدة من الاختراقات الفكرية التي تستهدف العقول أكثر مما تستهدف الأجساد.
يرى عالم الاجتماع مانويل كاستلز(Manuel Castells) أن المجتمع الشبكي الذي أفرزته التكنولوجيا الرقمية قد أوجد فضاءً جديدًا للقوة، فباتت السيطرة لا تُمارس عبر العنف المباشر بقدر ما تُمارس عبر تدفق الرموز والمعلومات وإعادة تشكيل المعنى، أما الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) فقد شدّد على أن الفضاء العام –الذي كان في السابق مجالًا للحوار الناقد بين المواطنين– قد تحول بفعل الإعلام المعولم إلى ساحة تتنازعها قوى السوق والدعاية السياسية، مما يجعل الرأي العام أكثر عرضة للتأثير غير العقلاني.
وتبعًا للمنظور النفسي يشير الباحث الأمريكي روبرت سيالديني (Robert Cialdini) في دراسته عن الإقناع إلى أن العقول البشرية قابلة للتأثر عبر آليات دقيقة مثل التكرار، والمرجعية الاجتماعية، والجاذبية العاطفية، وهي آليات توظفها المنصات الرقمية على نطاق واسع لتعزيز أنماط معينة من التفكير والسلوك.
هذا التلاقي بين النظرية الاجتماعية والفلسفية والنفسية يوضح أن الاختراق الفكري في زمن الانفتاح الرقمي ليس حدثًا عابرًا، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين التكنولوجيا، والبنية الاجتماعية، والاحتياجات النفسية، والسلطة السياسية والاقتصادية، وفي العراق والعالم العربي عمومًا، تتضاعف خطورة الظاهرة بسبب هشاشة البنية التعليمية والإعلامية، فضلا عن الأزمات السياسية والاجتماعية التي تجعل المجتمعات أكثر عرضة للاختراقات الأيديولوجية والفكرية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة لهذه الظاهرة في ضوء مفهوم “الأمن الفكري”، بعدّه خط الدفاع الأول ضد محاولات التشويش والتفكيك والهيمنة، إذ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الاختراقات الفكرية في زمن الانفتاح والفضاء الرقمي، من خلال تفكيك مفاهيمها وأنماطها، واستعراض أبعادها الاجتماعية والنفسية والسياسية، مع تقديم توصيات عملية للمواجهة قد تسهم في رؤية مستقبلية نحو بناء أمن فكري رقمي مستدام.
لمحة تاريخية
على الرغم من أن مصطلح “الاختراق الفكري” أصبح شائعًا في زمن الفضاء الرقمي، فإن جذوره تمتد إلى قرون مضت، حيث كانت الأنظمة السياسية والدينية والثقافية تسعى لتوجيه الفكر العام عبر أدوات مختلفة، من الدعاية السياسية والدينية إلى التعليم الموجه والمنابر الأدبية، فقد استخدمت الإمبراطوريات القديمة، مثل الإمبراطورية الرومانية والفارسية، الكتب والخطب الرمزية لتشكيل وعي الشعوب وإضفاء الشرعية على سلطتها.
وفي العصر الحديث -قبل انتشار الإنترنت- اعتمدت الدول والمؤسسات الإعلامية على وسائل مثل الصحف، والإذاعة، والتلفزيون، لنشر رسائلها وتوجيه الرأي العام، كما لاحظ بعض الباحثين كيف يمكن توظيف علم النفس والإعلام لإقناع الجماهير وتشكيل السلوكات الاجتماعية الجديدة والمطلوبة.
ومع دخول عصر الانفتاح الرقمي، تحولت هذه العمليات من أدوات مركزية وسيطة إلى شبكات مفتوحة ومتعددة الاتجاهات، حيث يستطيع أي فرد أو جماعة نشر الرسائل والتأثير على جمهور واسع بسرعة غير مسبوقة، ومن هنا يصبح الاختراق الفكري اليوم أكثر تعقيدًا، لأنه لم يعد يعتمد على قنوات رسمية فقط، بل يشمل فضاءات غير منظمة، وخوارزميات رقمية، وأساليب تأثير نفسية متقدمة.
هذا البعد التاريخي يوضح أن الاختراق الفكري ليس وليد العصر الرقمي فقط، بل هو امتداد طبيعي لتقنيات قديمة تم تطويرها وتكييفها وفقًا للتكنولوجيا الحديثة، مما يجعل فهم أصوله وتاريخه أمرًا ضروريًا قبل محاولة تحصين المجتمعات أو بناء سياسات مواجهة فعالة.
المفهوم والأنماط
اولًا: مفهوم الاختراقات الفكرية
الاختراق الفكري هو عملية توجيه أو إعادة تشكيل الوعي الجمعي أو الفردي من خلال معلومات، رسائل، أو رموز، تهدف إلى التأثير في القيم والمعتقدات والاتجاهات، ويختلف الاختراق الفكري عن مجرد التأثير أو الإقناع، لأنه غالبًا يتسم بالمنهجية والهدفية، وقد يستخدم أساليب خفية أو مضللة لاستمالة الأفراد والجماعات.
وفقًا لـ Borum (2011) وMoghaddam (2005)، الاختراق الفكري هو مدخل أساسي للتطرف والعنف، لأنه يمهد الطريق لتغيير القيم والمفاهيم قبل أن تتحول إلى أفعال، سواء كانت سياسية، اجتماعية، أو دينية.
ثانياً: أنماط الاختراقات الفكرية
يمكن تصنيف الاختراقات الفكرية وفقًا للوسيلة والهدف كالآتي:
-
اختراقات ايديولوجية: تهدف إلى فرض رؤى سياسية أو دينية معينة، أو إضعاف الأنظمة القائمة، ومن أمثلتها خطاب متطرف يُروّج للكراهية، رسائل تحريضية على العصيان المدني.
-
اختراقات ثقافية واجتماعية: تهدف إلى تغيير القيم والسلوكات الاجتماعية، وزعزعة الهُوية الثقافية، ومن أمثلتها ترويج أنماط حياة مخالفة للثقافة المحلية والدينية عبر وسائل الإعلام، إنتاج محتوى يعزز القيم الاستهلاكية على حساب التضامن الاجتماعي.
-
اختراقات رقمية: تعتمد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الرسائل بسرعة وانتشار واسع، ومن أمثلتها الأخبار المزيفة، الحملات المدفوعة، الحسابات الآلية، واستهداف شرائح معينة بخوارزميات دقيقة.
-
اختراقات اقتصادية/إعلانية: استخدام الحملات الدعائية التجارية أو الاقتصادية لتشكيل وعي المستهلكين وربطه بمواقف فكرية معينة، ومن أمثلتها حملات دعائية تستغل الرموز الوطنية أو الدينية لتسويق منتجات، مما يخلق رابطًا عاطفيًا يؤدي لاحقًا إلى تأثير فكري.
ثالثاً: آليات الاختراق
-
التكرار: توظيف الرسائل المتكررة لإرساء فكرة معينة في العقل الجمعي، كما أشار Cialdini (2001) في نظرية الإقناع.
-
استهداف العاطفة: استغلال الخوف، الغضب، الفخر، أو الانتماء العاطفي للضغط على التفكير العقلاني.
-
الإيهام بالشرعية: تقديم المعلومات على أنها مصدر رسمي أو موثوق، حتى لو كانت مضللة.
-
التفكيك التدريجي للقيم: إذ يُستهدف الفرد بمحتوى متنوع يزرع الشكوك أو الانقسامات في المعتقدات القائمة.
-
شبكات التأثير الرقمية: استخدام الخوارزميات، الحسابات الوهمية، والروبوتات لزيادة الانتشار والوصول إلى جماهير محددة بدقة عالية.
الخصائص الجوهرية للفضاء الرقمي
قبل العصر الرقمي، كانت الاختراقات الفكرية محدودة بالكتب، الصحف، والخطب الرسمية وما يعرض في التلفاز، أما اليوم، فقد أصبح كل مستخدم محتوى محتمل، وكل منصة وسيلة انتشار، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان اكتشاف الحملات الاختراقية، لا سيما إذا كانت مموهة أو مختبئة تحت محتوى ترفيهي أو ثقافي، ويتميز الفضاء الرقمي بمجموعة من الخصائص التي تجعله بيئة خصبة للاختراقات الفكرية:
-
العولمة الفورية للمعلومات: القدرة على نقل الأفكار والرسائل عبر الحدود الزمنية والجغرافية في ثوانٍ.
-
التفاعلية الثنائية: حيث يمكن للأفراد المشاركة في إنتاج المحتوى وتعديله ونشره، ما يزيد من انتشار الرسائل الاختراقية.
-
الخصوصية والنسبية: صعوبة مراقبة أو ضبط المعلومات الفردية، ما يتيح تمرير محتوى موجه أو مضلل بدقة عالية.
-
خوارزميات التوجيه والتصفية: منصات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب و X (تويتر سابقا) وانستكَرام تستخدم خوارزميات تحلل سلوك المستخدم وتعرض له ما يتوافق مع اهتماماته، ما يعزز الانعزال الفكري ويزيد من قابلية الفرد للتأثر بالرسائل الاختراقية.

تأثير الفضاء الرقمي على طبيعة الاختراقات الفكرية
الفضاء الرقمي لم يخلق الاختراقات الفكرية فحسب، بل غيّر طبيعتها بشكل جوهري:
-
من الاختراق التقليدي إلى الرقمي، التحول من الكتب والخطب الرسمية إلى شبكات رقمية مفتوحة، حيث يمكن لأي فرد أو جماعة نشر محتوى يؤثر على الرأي العام بشكل سريع وواسع الانتشار.
-
الاستهداف الدقيق: تحليل البيانات الضخمة لتحديد الجمهور الأكثر تأثرًا، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو الثقافي.
-
تسريع دورة انتشار الرسائل: الرسائل المختبرة عبر الفضاء الرقمي يمكن تعديلها وإعادة نشرها في دقائق، ما يجعل مواجهة الحملات أصعب.
-
إخفاء المصدر والهوية: الحسابات المزيفة والروبوتات تخفي الجهة الفاعلة، ما يزيد من صعوبة المساءلة وكشف الأهداف الحقيقية.
مظاهر الاختراقات الفكرية الرقمية
-
الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة: تخلق سرديات مشوشة حول القضايا السياسية والاجتماعية.
-
الحملات الدعائية المنظمة: تمولها جهات داخلية أو خارجية لتوجيه الرأي العام أو إشعال الانقسامات.
-
التضليل العاطفي: استغلال المشاعر القوية كالخوف والغضب أو الفخر، لتعزيز قبول رسائل معينة دون وعي.
-
التطرف الرقمي: نشر خطاب متطرف يخاطب الشرائح الأكثر هشاشة نفسيًا أو اجتماعيًا، ويؤسس لمواقف عنيفة لاحقًا.
أمثلة عملية
إن انتشار خطاب متطرف على منصات التواصل الاجتماعي يمثل تجليات واقعية للاختراق واستهداف الشباب الذين يقضون ساعات طويلة على الإنترنت، واستغلال ميولهم العاطفية لدفعهم إلى تبني أفكار متشددة، كذلك حملات التضليل السياسي قبل الانتخابات، وتحليل بيانات المستخدمين لتحديد مناقشاتهم وميولهم السياسية، ثم إرسال رسائل موجهة تهدف إلى التأثير على اختياراتهم.
ومن الأمثلة الواقعية إعادة إنتاج السرديات الثقافية أو الوطنية بشكل مشوه، واستخدام الفيديوهات أو الصور المعدلة رقميًا لبث مشاعر الخوف أو الاستفزاز بين الجماعات المختلفة.
التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي
-
سرعة الانتشار مقابل بطء الرقابة: فالمحتوى ينتشر أسرع بكثير من قدرة السلطات أو المؤسسات على رصده والتحقق منه.
-
تعدد المصادر وصعوبة التحقق: فهناك صعوبة بالغة في التمييز بين محتوى موثوق ومضلل.
-
الانقسام المعرفي: فالخوارزميات الرقمية تعزز فقاعات الرأي، ما يزيد من صعوبة مواجهة الاختراقات الفكرية بأساليب تقليدية.
الفضاء الرقمي هو ساحة مزدوجة الوجه، يوفر فرصًا هائلة للتواصل والمعرفة، لكنه في الوقت ذاته يمثل بيئة خصبة للاختراقات الفكرية بسبب سرعة المعلومات، خوارزميات التوجيه، وقابلية الأفراد للتأثر العاطفي، وهذا الواقع يفرض على المجتمعات ضرورة بناء مناعة رقمية وفكرية متكاملة عبر التربية، الإعلام الواعي، التشريعات المناسبة، والمشاركة المجتمعية الفعالة.
الأبعاد الاجتماعية والسياسية للاختراقات الفكرية
أولاً: البعد الاجتماعي
الاختراقات الفكرية لا تؤثر على الفرد فقط، بل تمتد لتشكل ديناميات المجتمع بأسره، فهي تعمل على إعادة تشكيل القيم المشتركة، وإضعاف الروابط الاجتماعية، وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع، ومن أبرز مظاهر هذا البعد:
-
تفكك الهُوية الثقافية: المحتوى المضلل أو الموجه رقمياً يمكن أن يشجع على تبني أنماط ثقافية أو سلوكية مخالفة للتقاليد المحلية، ما يؤدي إلى صراع داخلي بين الأجيال والقيم.
-
الاستقطاب الاجتماعي: تُستغل المنصات الرقمية لنشر أفكار متباينة أو متطرفة تستهدف تقسيم المجتمع إلى مجموعات متنافسة، ما يزيد من الصدامات الاجتماعية.
-
تراجع الثقة بالمؤسسات: الحملات المضللة تستهدف أحيانًا المؤسسات التعليمية، الإعلامية، والسياسية، مما يقلل من ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ويضعف التضامن المجتمعي.
وكما أشار أحد الباحثين فإن المجتمعات التي تواجه اختراقات فكرية متكررة بدون استراتيجيات مواجهة مناسبة تعاني من شرذمة القيم والمعتقدات، وتصبح أكثر عرضة للتطرف والعنف لاحقًا والصراعات.
ثانياً: البعد السياسي
على الصعيد السياسي، تعمل الاختراقات الفكرية على تغيير مواقف الجمهور وإضعاف الاستقرار الوطني، من خلال عدة آليات:
-
التأثير على الرأي العام: الحملات الرقمية المنظمة تهدف إلى توجيه اتجاهات التصويت، التأثير على السياسات العامة، أو خلق انقسامات حول القضايا الوطنية الحساسة.
-
تقويض شرعية الدولة: من خلال نشر معلومات مضللة عن أداء الحكومة أو المؤسسات الرسمية، ما يولد شعورًا بعدم الكفاءة أو الفساد.
-
استهداف الحركات السياسية أو المجتمعية: تسريب المعلومات المغلوطة أو المضللة حول قادة جهات معينة يؤدي إلى إحباط القواعد الشعبية وزعزعة استقرار التنظيمات المحلية.
وفي العراق يبين الواقع أن الأزمات السياسية والاجتماعية المستمرة تجعل المجتمع أكثر هشاشة أمام الحملات الموجهة، سواء كانت خارجية أو داخلية، ما يعزز تأثير الاختراقات الفكرية على الاستقرار الوطني.
ثالثاً: التفاعل بين البعدين الاجتماعي والسياسي
الاختراقات الفكرية تعمل في توازي على المستويين الاجتماعي والسياسي، حيث أن الاستقطاب الاجتماعي يؤدي إلى انقسام سياسي، والعكس صحيح، على سبيل المثال نشر سرديات متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يقتصر على زرع القيم الفردية فقط، بل يخلق تحالفات ومواقف سياسية متطرفة بين المجموعات.
وايضا فقدان الثقة بالمؤسسات التعليمية والإعلامية يولد أزمة سياسية وثقافية معًا، ما يصعب على الدولة فرض سياسات ضبط أو توجيه المجتمع بشكل فاعل.
الاختراقات الفكرية في الأبعاد الاجتماعية والسياسية تشكل تهديدًا مزدوجًا، فهي تعمل على تفكيك القيم المجتمعية من جهة، وتوجيه العملية السياسية من جهة أخرى، ولذا فإن مواجهتها تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التربية، الإعلام، السياسة، والأمن الفكري، لضمان حماية المجتمع من الانقسام الاجتماعي والسياسي، وتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على الصمود أمام الحملات الموجهة داخليًا وخارجيًا.
الآثار النفسية والثقافية على الفرد والمجتمع
أولاً: الآثار النفسية على الفرد
الاختراقات الفكرية الرقمية لا تؤثر فقط على سلوك الأفراد، بل تصل إلى مستويات عميقة من تكوين الوعي والمعتقدات، ومن أبرز هذه الآثار:
-
تشويش الهُوية الذاتية: عندما يتعرض الفرد باستمرار لمعلومات متناقضة أو مضللة، ينشأ شعور بعدم اليقين تجاه معتقداته وقيمه، مما يؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس وانقسام داخلي.
-
القلق والخوف المزمن: الحملات المخادعة التي تستخدم الرموز العاطفية، مثل التهديد أو الصور الصادمة، تولد ضغطًا نفسيًا مستمرًا.
-
الانعزال الاجتماعي: الأفراد الذين يتأثرون بالرسائل المضللة قد ينسحبون من الحوار المجتمعي أو يختارون الانضمام إلى مجموعات مغلقة تعزز أفكارهم، ما يزيد من الانعزال الفكري والنفسي.
-
استعداد للتطرف أو العنف: الدراسات النفسية تشير إلى أن تغيير المعتقدات على المستوى العاطفي قد يمهد الطريق لتبني مواقف متطرفة أو سلوك عنيف، خصوصًا عند استغلال الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية.
ثانياً: الآثار الثقافية على المجتمع
-
تراجع القيم المشتركة: مع انتشار محتوى موجه أو مضلل، تصبح القيم التقليدية المشتركة أقل تأثيرًا، وتظهر نزعات فردية أو ثقافات فرعية متباينة.
-
التغيير في السلوك الجمعي: المجتمع يصبح أكثر عرضة للتأثر بالانفعالات الجماعية، مثل الذعر أو الغضب أو التحريض على الكراهية، ما يعزز الانقسام الاجتماعي.
-
هشاشة الهُوية الثقافية الوطنية: خاصة في المجتمعات التي تشهد انفتاحًا رقميًا سريعًا دون مناهج توعية ثقافية، إذ يصبح المواطن أكثر تقبلاً للأفكار والثقافات الأجنبية على حساب تراثه المحلي.
-
تأثير على الحوار المجتمعي: الاختراقات الفكرية تُضعف من قدرات الأفراد على النقاش العقلاني، وتزيد من الاستقطاب، ما يجعل الحوار المجتمعي أقل إنتاجية وأكثر انفعالية.
التفاعل بين الأبعاد النفسية والثقافية
الآثار النفسية والفكرية للأفراد تتكامل مع التحولات الثقافية على مستوى المجتمع، على سبيل المثال القلق وعدم اليقين النفسي للأفراد يجعلهم أكثر تقبلاً للسرديات الموجهة، مما يعزز الانقسام الثقافي والاجتماعي، كذلك الانعزال أو الانتماء إلى مجموعات مغلقة يزيد من تقبل الرسائل المضللة ويعمّق الانقسام بين الفئات المختلفة، فضلا عن تأثير هذه الاختراقات على الهُوية والثقافة يمهد الطريق لتغييرات سياسية واجتماعية لاحقة.
ومن الأمثلة الواقعية انتشار الرسائل المضللة بين الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤدي إلى تشويش مفهومهم عن القيم الوطنية والتاريخية، كذلك المجموعات المغلقة التي تنشر خطابًا متطرفًا أو تحريضيًا والتي تولد شعورًا بالأمان الزائف والانتماء، لكنها تزيد من الانعزال النفسي وتضعف القدرة على التفاعل النشط.
وهناك حملات التشكيك بالمؤسسات التعليمية أو الإعلامية التي تسبب فقدان الثقة بالمصادر الرسمية وتزيد من القلق المجتمعي حول المستقبل.
الآثار النفسية والثقافية للاختراقات الفكرية تمتد من الفرد إلى المجتمع، وتؤثر على الهوية والقيم والسلوك، ما يجعلها تحديًا مركبًا، ولذا فإن مواجهتها تتطلب دمج التربية على التفكير السليم، الإعلام الواعي، والمناخ الثقافي الداعم للهوية الوطنية والقيم المشتركة، لضمان مقاومة التأثير السلبي على المدى الطويل.
نماذج ودراسات حالة (عالمية وعراقية/عربية)
حملات التضليل قبل الانتخابات الأمريكية 2016، فقد استخدمت جماعات رقمية، بعضها مرتبط بدول أجنبية، منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مضللة واستهداف الناخبين بشكل دقيق عبر تحليل البيانات الشخصية، وقد تم استخدام خوارزميات التفاعل لتوجيه الرسائل حسب اهتمامات المستخدمين، ما أدى إلى تضليل قطاعات واسعة من الجمهور، وتفاقم الاستقطاب السياسي.
وإن تحليل Allcott & Gentzkow (2017) أظهر أن الأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير ملموس على الرأي العام، وتوضّح كيف يمكن للاختراق الفكري الرقمي التأثير على القرارات السياسية.
أما التطرف الرقمي في أوروبا، فهناك جماعات متطرفة استغلت الفضاء الرقمي لاستقطاب الشباب عبر حملات منظمة تستخدم الرموز الدينية والقصص العاطفية، وفي دراسة Horgan (2009) أبرزت أن هذه الحملات تعمل على تغيير المعتقدات والقيم تدريجيًا، ما يمهد الطريق لتبني سلوك عنيف لاحقًا.
وفي العالم العربي تجلت حملات اختراق الرأي العام أثناء ما يعرف بالربيع العربي منذ 2011 ، فقد تم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر شائعات وأخبار مضللة تهدف إلى تشويه صورة بعض الانظمة السياسية والحزاب والجماعات والشخصيات المرتبطة بها، وهذه الاختراقات أسهمت في تعزيز الانقسام المجتمعي، وإضعاف الثقة بالمؤسسات الرسمية والإعلام التقليدي، وأظهرت دراسة Lynch (2012) أن الفضاء الرقمي أصبح سلاحًا مزدوجًا، يستخدمه كل من القوى السياسية المعنية للتأثير على الرأي العام، مما يزيد من هشاشة الأمن الفكري.
الدراسات في مصر والمغرب وسوريا تشير إلى أن المحتوى الرقمي الموجه أو المضلل أسهم في إعادة تشكيل القيم الاجتماعية والثقافية للشباب، مثل تقبل السلوكات العنيفة أو الانسحاب من المشاركة المدنية التقليدية.
واشارت دراسات حالة في العراق أن حملات إعلامية مضللة خلال الانتخابات المحلية والوطنية، وقد استخدمت بعض الأطراف السياسية وسائل التواصل الاجتماعي لبث معلومات مختلقة حول المرشحين الآخرين، مستغلة ضعف الوعي الرقمي بين بعض الناخبين، وهذه الحملات أدت إلى استقطاب المجتمعات المحلية، وخلق شعور بعدم الثقة بين الفئات المختلفة، وفقًا لمتابعات محلية ودراسات استطلاعية من مؤسسات بحثية عراقية.
وايضا كانت هناك الاختراقات الفكرية المرتبطة بالتطرف الديني وقد استهدفت الجماعات المتطرفة بعض الشباب عبر الفيديوهات والمواد التعليمية الرقمية، مستغلة ضعف الرقابة الأسرية والتعليمية على الإنترنت، وهنا أشارت دراسة مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية (2023) أن نسبة كبيرة من الشباب الذين تعرضوا لمثل هذا المحتوى يظهرون تغيرًا في المعتقدات والسلوكات، مما يعزز خطورة التطرف على المجتمع العراقي.
الرؤية المستقبلية نحو بناء أمن فكري رقمي مستدام
الأمن الفكري الرقمي
الأمن الفكري الرقمي ليس خيارًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع والدولة في زمن الانفتاح الرقمي، والاستثمار في التعليم، الإعلام، التشريعات، والتقنيات الرقمية يعزز القدرة على مواجهة الاختراقات الفكرية، ويضمن استدامة وعي بناء ومتماسك قادر على التعامل مع تحديات المستقبل.
والأمن الفكري الرقمي هو قدرة المجتمع والفرد على حماية وعيهم وقيمهم ومعتقداتهم من الاختراقات الفكرية المضللة أو المتطرفة في الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على الانفتاح على المعرفة والابتكار، ويجمع هذا المفهوم بين:
-
الوعي الفردي بالنقد والتحليل.
-
التربية القيمية والثقافية.
-
سياسات وتشريعات رقمية فاعلة.
-
تقنيات حماية المعلومات ومكافحة المحتوى الضار.
مبادئ بناء الأمن الفكري الرقمي
-
الشمولية: مواجهة الاختراقات الفكرية لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل التعليم، الإعلام، الدولة، المجتمع المدني، والمنصات الرقمية.
-
التوازن بين الانفتاح والحماية المتشددة: السماح بالوصول إلى المعرفة والمعلومات دون تعريض المجتمع للاختراقات الفكرية.
-
التقنية في خدمة الإنسان: استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الرصد لتحليل التهديدات، مع احترام الخصوصية وحقوق الأفراد.
-
المتابعة والتحديث المستمر: تطوير سياسات واستراتيجيات مرنة تتكيف مع سرعة التغير الرقمي وانتشار أساليب الاختراق الجديدة.
توصيات استراتيجية
-
على وزارة التربية تعليم انماط تفكير متقدمة كالتفكير التحليلي والناقد، يجب إدماج مناهج التفكير الناقد والتحليل المعلوماتي منذ المراحل التعليمية المبكرة، لتمكين الطلبة من التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة.
-
على وزارتي التربية والتعليم العالي تعليم الطلبة كيفية التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف الى الأخبار المزيفة وخوارزميات التوجيه.
-
على هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي والمؤسسات الاعلامية الرصينة تعزيز دور الإعلام الرسمي وغير الرسمي في تقديم محتوى دقيق وشفاف يعزز المناعة الفكرية للمجتمع.
-
استخدام وسائل الإعلام للكشف عن الأخبار المضللة والاختراقات الفكرية قبل انتشارها على نطاق واسع.
-
استثمار المنصات الرقمية لنشر محتوى تثقيفي وجاذب، بحيث يقدم بديلًا للفكر المضلل ويستهدف الفئات الأكثر عرضة للاختراق.
-
على مجلس النواب العراقي والمؤسسات القضائية وضع أطر قانونية تمنع نشر الأخبار المزيفة أو المحتوى التحريضي، مع ضمان حقوق الحرية الرقمية.
-
تعزيز قوانين الخصوصية للحد من الاستهداف الرقمي الممنهج للأفراد.
-
دعم المؤسسات الحكومية والأهلية في رصد الحملات الرقمية وتقديم توصيات فاعلة للحد من الاختراقات الفكرية.
-
على الحكومة العراقية والمؤسسات البحثية والتكنلوجية كافة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى المضلل أو الحملات الدعائية المنظمة قبل انتشارها.
-
تثقيف المستخدمين على التحقق من المصادر، عدم الانسياق وراء الأخبار العاطفية، وحماية الحسابات الرقمية.
-
تطوير أدوات للكشف عن الحسابات الوهمية التي تنشر رسائل اختراقية على نطاق واسع.
-
تشجيع الجمعيات والمنظمات على المشاركة في التثقيف الرقمي ومبادرات الكشف عن الحملات المضللة.
إن مواجهة الاختراقات الفكرية تتطلب نهجًا متكاملًا يشمل التربية، الإعلام، التشريعات، الأمن السيبراني، والمشاركة المجتمعية، فالجمع بين هذه العناصر يوفر مناعة فكرية تمكن الفرد والمجتمع من التعامل بوعي وفاعلية مع التحديات الرقمية، ويحد من قدرة الحملات المضللة على التأثير في القيم والسلوك والهُوية.
المصادر
-
حسين، ع. (2021). التطرف الرقمي وتأثيره على الشباب العربي. القاهرة: مركز الدراسات الاستراتيجية.
-
علي، م. (2019). الأمن الفكري والتحولات الرقمية في المجتمعات العربية. عمان: دار الفكر العربي.
-
مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية. (2023). الاختراقات الفكرية والشباب العراقي في الفضاء الرقمي. بغداد: مركز الفيض العلمي.
-
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). الإعلام الرقمي، التضليل الرقمي، والرأي العام في العالم العربي. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
-
اليونسكو. (2018). مهارات الإعلام والمعلومات لعصر الرقمنة. باريس: اليونسكو.
-
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.
-
Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psychologist, 60(2), 161–169.
-
Horgan, J. (2009). Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements. Routledge.
-
Lynch, M. (2012). The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. PublicAffairs.
-
European Commission. (2020). Media Literacy and Digital Skills for Citizens. Brussels: EC.
-
Pew Research Center. (2019). Social Media Use in 2019. Washington, D.C.: Pew Research.
 Loading...
Loading...

 Loading...
Loading...