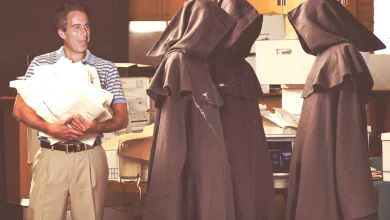بقلم: د. محمد عبد كاظم غلام
تمثل مرحلة الصف الأول الابتدائي لحظة فاصلة في حياة الطفل، إذ ينتقل من بيئة الأسرة أو الروضة إلى فضاء مدرسي منظم يفرض قواعد وأدوارًا جديدة. هذه المرحلة ليست مجرد بداية دراسية، بل هي تحول شامل يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والبيولوجية والتربوية للطفل، ويضع الأسس الأولى لشخصيته المستقبلية. إذ تعد الطفولة المتوسطة، بين سن ست إلى ثماني سنوات، مرحلة حرجة لتطوير الاستقلالية والانضباط الذاتي، وتكتسب فيها المهارات الاجتماعية الأولى، بالإضافة إلى تنمية القدرات العقلية الأساسية. المدرسة تمثل هنا المجتمع الأول خارج الأسرة، حيث يتعلم الطفل قيم التعاون والمشاركة واحترام القوانين .
كما أن المحيط الاجتماعي الأوسع، بما في ذلك الأسرة والأقران والمجتمع، يلعب دورًا حيويًا في تشكيل شخصية الطفل ورسم ملامحها.
من الناحية النفسية، يمثل التحاق الطفل بالصف الأول تجربة انفصال لأول مرة عن الأهل، وهو ما قد يثير مشاعر القلق والخوف، فيوضح إريك إريكسون أن الطفل في هذه المرحلة يواجه صراعًا بين المثابرة والشعور بالنقص، فالنجاح في المهام يعزز شعوره بالكفاءة، بينما يؤدي الفشل المتكرر إلى شعور بالنقص (Erikson, 1993, p. 112) .
ويرى جيروم برونر أن الفضول والرغبة في الاكتشاف هما الأساس لأي تعلم ناجح (Bruner, 1973, p. 27)، لذلك فإن الأطفال يحتاجون إلى أنشطة عملية تساعدهم على التكيف النفسي، مثل تكليفهم بمهمة صغيرة في الصف أو ألعاب التركيز مثل “الصمت دقيقة” أو “تنظيم الصف وادارته”.
كما يلعب دعم الأسرة دورًا كبيرًا في تهدئة الطفل، وتعزيز شعوره بالأمان من خلال مشاركة الحماس للمدرسة أو قراءة قصة قصيرة قبل النوم.
على الصعيد الاجتماعي، يمثل الصف الأول أول مجتمع رسمي للطفل، حيث يبدأ تعلم قواعد الانضباط، تكوين الصداقات، وفهم القوانين داخل الصف. تشير الدراسات إلى أن المدرسة قناة أساسية لنقل القيم الاجتماعية وتنظيم العلاقات بين الأطفال، وأن الطفل يبدأ بفهم مفهوم السلطة واحترام القوانين من خلال التفاعل مع المعلم .
ولكن هناك أخطاء شائعة قد تقع فيها الأسرة أو المعلمون، مثل مقارنة الطفل بالآخرين، أو تقييد فرصه في التفاعل الاجتماعي، أو عدم إشراكه في أنشطة جماعية. يمكن تفادي ذلك من خلال الألعاب الجماعية التي تتطلب التعاون، مثل تمرير الكرة مع ذكر الاسم، أو تخصيص مقعد ثابت لكل طفل لتعزيز شعوره بالانتماء، وتشجيع النشاط الاجتماعي داخل الصف وخارجه، مثل دعوة صديق للمنزل أو المشاركة في مشاريع جماعية بسيطة.
من الناحية البيولوجية، يشكل النمو الجسدي والعصبي للطفل قاعدة هامة لاستعداده المدرسي، وفق بياجيه، يدخل الطفل في مرحلة العمليات العيانية، ويصبح قادرًا على التفكير المنطقي الملموس (Piaget, 1973, p. 84)، لذلك يحتاج الأطفال إلى فواصل حركية قصيرة بين الدروس، مثل تمارين التمدد أو “قفزة الأرنب”، وأنشطة تعليمية حسية مثل تشكيل الحروف بالعجين أو الرمل.
كما أن التغذية الصحية والنوم الكافي وفحص النظر والسمع تعد عناصر حيوية لضمان استجابة الطفل للتعلم بشكل كامل، والأخطاء الشائعة في هذا المجال تشمل إجبار الطفل على الجلوس لفترات طويلة، تكليفاته بأنشطة تتجاوز قدراته، أو تجاهل حاجاته الحركية والنفسية.
أما على الصعيد التربوي المتكامل، فالصف الأول هو المرحلة التي تُؤسس فيها المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، وهو ما يشكل حجر الأساس للتعلم المستقبلي، فيشير جون ديوي إلى أن التعلم يكون أكثر فاعلية عندما يربط بالخبرات اليومية وليس بالحفظ فقط، لذلك فإن ربط الرياضيات بالحياة اليومية، مثل عد خطوات الطفل أو قطع الفاكهة، وتهيئة البيئة الصفية الغنية بالألوان والقصص والأنشطة العملية، يساهم في تنمية الفضول والاكتشاف لدى الطفل.
ويبرز فيغوتسكي أهمية التفاعل مع الكبار في “المنطقة القريبة من النمو”، حيث يحقق الطفل أفضل تقدم عند حصوله على دعم مناسب من المعلم والأسرة (Vygotsky, 1978, p. 86).
يلعب معلم الصف الأول الخاص دورًا جوهريًا في ضمان تجربة تعليمية متكاملة، فالمعلم المتخصص قادر على تخصيص التعليم وفق الفروق الفردية، وتطبيق أساليب تربوية مناسبة لعمر الطفل، مع تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتخفيف القلق، وتطوير المهارات الأساسية بطريقة ممتعة ومتدرجة، ويمكن للمعلم أن ينظم زوايا متعددة في الصف، مثل زاوية القراءة، ركن الرسم، وركن الألعاب التعليمية بطريقة تربط بين المعرفة واللعب، بحيث يشارك كل طفل بما يناسب اهتماماته وقدراته. في العراق، فقد استحدثت الجامعات العراقية قسمًا علميًا متخصصًا لمعلمي الصفوف الأولى منذ سنين، بهدف إعداد معلمين أكفاء قادرين على تطبيق أحدث الأساليب التربوية والنفسية، وقد تبنت كثير من الجامعات لاحقًا هذا التخصص لتعزيز جودة التعليم الابتدائي (uomustansiriyah.edu.iq).
ويأتي “الأسبوع التمهيدي” ليكمل هذه المنظومة، باعتباره مرحلة انتقالية تُهيّئ الطفل نفسيًا واجتماعيًا للاندماج في البيئة المدرسية الجديدة. فهو يقلل من مشاعر القلق والخوف، ويُسهم في بناء اتجاه إيجابي نحو المدرسة وتعزيز الدافعية للتعلم. وتشير الدراسات التربوية إلى أن تهيئة بيئة تعليمية آمنة وداعمة خلال هذا الأسبوع تساعد الأطفال على التكيف والانسجام مع متطلبات الحياة المدرسية .(الشمري، 2018: 217)
إن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي يمثل رحلة نمو متكاملة تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والبيولوجية والتربوية، والطفل الذي يجد بيئة صفية دافئة، معلمًا متخصصًا، وأهلًا داعمين يتجاوز قلق الانفصال ويصبح متعلمًا نشطًا ومندمجًا اجتماعيًا، بينما الأخطاء الشائعة من المحيطين- الضغط الزائد، المقارنات المستمرة، إهمال اللعب أو النشاط الحركي- قد تقلل من أثر هذه المرحلة الحيوية، وكما قالت ماريا مونتيسوري: “كل طفل يحمل في داخله بذور التعلم، وما على الكبار إلا أن يهيئوا التربة المناسبة لنموها” (Montessori, 1967, p. 41).
المصادر
-
الشمري، محمود، علي (2018) الأسبوع التمهيدي وأثره في تهيئة تلاميذ الصف الأول الابتدائي، مجلة العلوم التربوية، العدد (2).
-
المنال. (2021). الأسس النفسية في تنشئة الطفل. مجلة المنال.
-
أكاديمية دي بلان. (2020). التنشئة الاجتماعية للطفل في المرحلة الابتدائية.
-
وزارة التعليم السعودية. (2022). المرحلة الابتدائية: النمو البدني والاجتماعي والعاطفي.
-
مدرسة الصدق. (2021). أهمية منهج الصف الأول الابتدائي.
-
الجامعة المستنصرية. (2014). قسم معلمي الصفوف الأولى- كلية التربية الأساسية.
-
Berk, L. E. (2018). Development through the lifespan (7th ed., pp. 110-115). Boston, MA: Pearson.
-
Bruner, J. (1973). To understand is to invent: The future of education (pp. 27-30). New York: Grossman.
-
Erikson, E. H. (1993). Childhood and society (Rev. ed., pp. 112-114). New York: W. W. Norton & Company.
-
Montessori, M. (1967). The discovery of the child (p. 41). New York: Ballantine Books.
-
Piaget, J. (1973). To understand is to invent: The future of education (p. 84). New York: Grossman.
-
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (p. 86). Cambridge, MA: Harvard University Press.
-
Weber, M. (1947). The theory of social and economic organization (p. 53). New York: Oxford University Press.Top of FormBottom of Form
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...