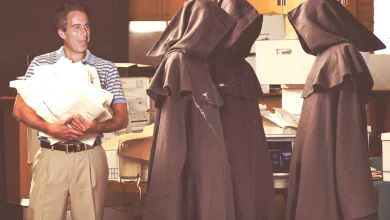بقلم: د. مصطفى سوادي جاسم
مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
في صباحٍ هادئٍ يلفّه الضباب، جلس “حيدر” على كرسيّه في الدائرة الحكومية، يراقب عقارب الساعة كما لو كانت خصمًا عنيدًا، هذا هو نفسه الذي طرق أبواب المسؤولين، وأرهق نفسه بالبحث عن واسطاتٍ وشهاداتٍ وتوسّلاتٍ ليحصل على هذه الوظيفة التي حلم بها أعوامًا طويلة، يومَ بُشِّر بقبوله، بكى من الفرح وتعهد لنفسه أن يكون نموذجًا للجدّ والإخلاص، ولكن لم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى تغيّر المشهد، صار يتفنن في اختلاق الأعذار، يوقّع حضوره ثم يتوارى، أو يفتعل الاجتماعات الوهمية لينجو من أعباء العمل، وكل صباح يحمل في جيبه “كلاو” جديد، حكاية صغيرة ينسجها ليهرب من مسؤولياته، ناسياً أو متناسياً أن هذا المكتب الذي تخلّى عنه لحظة الجدّ كان بالأمس حلم حياته، هكذا تصبح الوظيفة التي حارب لأجلها ميدانًا للتحايل بدل أن تكون ميدانًا للعطاء.
وتتكرر في المشهد العراقي حكاية هذا الموظف الذي ناضل سنوات للحصول على وظيفة حكومية، ثم سرعان ما بدأ بالتهرّب من مسؤولياته أو البحث عن طرق لتخفيف عبء العمل، هذا التناقض لا يمكن عزوه إلى الكسل وحده، بل هو نتاج منظومة من العوامل التاريخية والنفسية والاجتماعية، ولأن “الكلاوات“- كتحايل روتيني شائع- صارت رمزاً ثقافياً لهذه الظاهرة، فإن تحليلها يتطلّب التوقف عند خلفيات متعددة الأبعاد لفهمها بشكل أعمق.
1. الأبعاد النفسية: صراع بين التوقعات والواقع
على المستوى النفسي، يواجه الموظف العراقي صراعاً داخلياً حاداً بين الصورة المثالية التي رسمها للوظيفة الحكومية والتجربة الواقعية التي يعيشها بعد التعيين، وإن البيئة التي تُعلي من شأن الوظيفة الحكومية وتعدها ذروة الاستقرار الاجتماعي، تُغرس في الأفراد منذ الطفولة، فتتكوّن لديهم توقعات مرتفعة لا تتناسب غالباً مع واقع بيروقراطي مرهق، وان هذا التناقض يخلق حالة ضغط نفسي تُفسَّر جيداً في إطار نظرية التنافر المعرفي؛ ولفهم السلوك المتناقض للأفراد، نلجأ إلى نظرية التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance) التي وضعها عالم النفس ليون فيستنجر، والتي تقوم على فكرة أن الأفراد يسعون لتحقيق التوافق والانسجام بين معتقداتهم وسلوكياتهم، وأي تناقض بينهما يخلق حالة من الضغط النفسي أو “التنافر”، الذي يحاول الفرد تقليله عبر تغيير أحد المعتقدات أو السلوكيات أو تبرير التناقض.
تطبيق النظرية على الحالة العراقية:
التوقعات (المعتقد): في مجتمع يعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي وضعف القطاع الخاص، تُعد الوظيفة الحكومية ملاذاً آمناً، ويغرس المجتمع في الأفراد فكرة أنها مصدر الدخل الوحيد الذي يضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي، بل وتُعد مؤشراً للنجاح الشخصي.
الواقع (السلوك): بعد الحصول على الوظيفة، يصطدم الفرد بواقع مرير، إذ يجد نفسه في بيئة عمل بيروقراطية مملة، تفتقر إلى الحوافز المادية والمعنوية، وقد يكون العمل غير متوافق مع مؤهلاته أو طموحاته، والترقيات تعتمد على الواسطة لا على الكفاءة.
حل التنافر: يواجه الفرد الآن تناقضاً حاداً بين إيمانه بأن الوظيفة الحكومية هي الحل المثالي وبين شعوره بالإحباط وعدم الرضا، للتعامل مع هذا التنافر، يقوم الفرد بتبرير سلوك التهرب من الدوام عبر لوم النظام. بدلاً من أن يلوم نفسه لاختياره هذه الوظيفة، يقول: “العمل لا فائدة منه”، “الكل يفعل ذلك”، أو “لا أحد يقدّر جهدي”، هذا التبرير يقلل من الضغط النفسي ويبرر سلوكه المتمثل في التهرّب.
مصطلح “الكلاوات” لا ينشأ من فراغ، بل يعكس ذاكرة تاريخية من انعدام الثقة بالأنظمة وتعاقب السلطات، عبر أجيال متعاقبة، طوّر قسم من العراقيين مهارات التحايل كآلية دفاع نفسي واجتماعي في مواجهة مؤسسات يُنظر إليها بعدها غير عادلة..
2. الأبعاد الاجتماعية: صراع الأدوار والبحث عن الأمان
المجتمع العراقي، عبر عقود من الأزمات وعدم الاستقرار، أعاد صياغة معايير النجاح الشخصي والاجتماعي بحيث ارتبطت الوظيفة الحكومية بالمكانة والاحترام أكثر من ارتباطها بالإنتاجيةـ وهذا السياق جعل الشباب ينظرون إلى التوظيف الحكومي ليس كوسيلة خدمة عامة، بل كبطاقة عبور إلى الاعتراف الاجتماعي، وحين تتحقق الوظيفة، يبدأ التناقض بين الدور الاجتماعي المفروض والدوافع الفردية العميقة بالظهور.
من منظور علم الاجتماع، يمكن فهم الظاهرة عبر نظرية الدور الاجتماعي (Social Role Theory). تحدد هذه النظرية الأدوار التي يتوقعها المجتمع من الأفراد، وكيفية تأثير هذه التوقعات على سلوكهم.
الدور الاجتماعي المحدد: المجتمع العراقي يفرض على أفراده، ولا سيما الشباب، دوراً اجتماعياً محدداً: “الحصول على وظيفة حكومية”، ويُنظر إلى هذا الدور كمعيار للنجاح، وهو ما يفسر سعي الخريجين الشديد للحصول عليها، حتى لو كانت لا تناسب تخصصاتهم، وهذا الدور لا يُركّز على الإنتاجية، بل على تحقيق “الاستقرار الوظيفي”.
صراع الأدوار (Role Conflict): عندما يحقق الفرد هذا الدور الاجتماعي، يكتشف وجود صراع بين ما يُطلب منه كـ “موظف ملتزم” وما يراه كـ “فرد يسعى للتحقيق الذاتي أو زيادة دخله” في بيئة لا تحفّزه، هذا الصراع يُدفعه لتقليل الالتزام بالدور الرسمي، والبحث عن حلول خارج الإطار التقليدي.
الحراك الاجتماعي: تُعد الوظيفة الحكومية الوسيلة الأساسية لتحقيق الحراك الاجتماعي الصاعد (Upward Social Mobility)، والانتقال من حالة البطالة إلى التوظيف الحكومي يمثل قفزة نوعية في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهذا التركيز على الوظيفة كأداة للارتقاء الاجتماعي يُقلل من أهمية العمل المنتج، ويبرر سلوك التهرب بمجرد تحقيق الهدف الأساس وهو “الوصول إلى المنصب”.
3. الأبعاد الاقتصادية والسياسية: هشاشة القطاع الخاص وغياب العدالة المؤسسية
لا يمكن فهم الظاهرة دون النظر إلى السياق الاقتصادي والسياسي الذي يغذيها، فالاقتصاد الريعي القائم على النفط جعل الدولة ربَّ العمل الأكبر، فيما بقي القطاع الخاص ضعيفاً وغير قادر على استيعاب الطاقات البشرية، وهذه الهشاشة، مقترنةً بالفساد والمحسوبية، خلقت بيئة يرى فيها المواطن أن الالتزام بالقواعد لا يضمن حقوقه، بينما التحايل- أو “الكلاوات”- قد يفتح الأبواب المغلقة.
الاعتماد المفرط على الدولة: ضعف القطاع الخاص والاقتصاد الريعي جعل الوظيفة الحكومية وسيلة وحيدة للعيش، فباتت هدفاً بحد ذاتها لا وسيلة للإبداع.
الفساد المؤسسي: غياب الشفافية والمحاسبة جعل “الكلاوات” أداةً للبقاء، والموظف يرى الفاسدين الكبار يفلتون من العقاب، فيفقد الحافز للالتزام.
اقتصاد الريع النفطي: وفّر الدولة ريعيةً تُغطي الرواتب دون ربطها بالإنتاجية، ما غذّى التناقض بين الدخل والإنجاز.
4. “الكلاوات”: تجسيد ثقافي لغياب الثقة
مصطلح “الكلاوات” لا ينشأ من فراغ، بل يعكس ذاكرة تاريخية من انعدام الثقة بالأنظمة وتعاقب السلطات، عبر أجيال متعاقبة، طوّر قسم من العراقيين مهارات التحايل كآلية دفاع نفسي واجتماعي في مواجهة مؤسسات يُنظر إليها بعدها غير عادلة، ومع مرور الوقت، تحوّل هذا السلوك إلى عنصر من عناصر الثقافة الشعبية، يُحتفى به أحياناً كرمز للدهاء والقدرة على البقاء.
لا يمكن إكمال التحليل دون فهم “الكلاوات”، وهو ليس مجرد سلوك فردي، بل ثقافة فرعية نشأت وتطورت في بيئة معينة، هذا المصطلح يعكس منهجاً للتعامل مع الحياة قائمًا على تجاوز القواعد والضوابط الرسمية بطرق غير مباشرة، أو ما يمكن أن يُسمى بـ”التحايل الروتيني”.
تتعدد أسباب انتشار هذه الثقافة لتشمل:
-
الفساد المؤسساتي: عندما يصبح الفساد والواسطة والمحسوبية هي القاعدة بدلاً من الاستثناء في مؤسسات الدولة، يدرك المواطن أن الالتزام بالقواعد والضوابط الرسمية لن يؤدي به إلى تحقيق مصالحه أو حقوقه. بل إن التحايل يصبح وسيلة للبقاء والنجاح في بيئة غير عادلة.
-
ضعف الثقة بين المواطن والدولة: التاريخ الطويل من الأنظمة غير المستقرة أدى إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة. هذا التاريخ يبرر سلوك “الكلاوات” كوسيلة لحماية المصالح الشخصية في مواجهة نظام غير موثوق.
-
الظروف الاقتصادية: في ظل غياب فرص العمل في القطاع الخاص، تصبح الوظيفة الحكومية الملاذ الأخير. “الكلاوات” هنا هي استراتيجية للحفاظ على مصدر الدخل بأقل جهد ممكن.
-
غياب المحاسبة والمساءلة: على الرغم من وجود هيئات رقابية، إلا أن ضعفها في تطبيق القانون وملاحقة الفاسدين (خاصة الكبار) يجعل الأفراد يشعرون بأنه لا توجد عواقب حقيقية لسلوكياتهم. عندما لا يُعاقب الموظف المتقاعس، ولا يُكافأ الملتزم، يصبح “الكلاوات” هو السلوك الأكثر منطقية.
5. الأبعاد التنظيمية والإدارية: فشل الحوكمة وقصور الإصلاح
حتى لو أدرك الأفراد أهمية الانضباط الوظيفي، فإن بيئة العمل ذاتها قد تدفعهم إلى العكس، فالروتين الطويل، وغياب الحوافز، وعدم وجود أنظمة تقييم شفافة، كلها عوامل تضعف الالتزام وتُشجع على السلوكيات الملتوية، الإصلاحات الشكلية التي لا تمسّ جذور المشكلة تزيد من الشعور باللاجدوى، ما يُكرس ثقافة “الكلاوات” كخيار عقلاني في بيئة غير محفّزة.
6. الخلاصة: من التناقض إلى الإصلاح
إن النظر إلى ظاهرة “الكلاوات” كعيب أخلاقي فردي يُغفل الطبيعة البنيوية للمشكلة، فالتناقض بين التطلعات والواقع هو انعكاس لعقود من الأزمات السياسية والاقتصادية والثقافية التي أنتجت سلوكيات دفاعية جماعية، ومع الإصلاحات الشاملة يمكن تحويل هذه الظاهرة من رمز للإحباط إلى حافز للتغيير.
إن ظاهرة الاستقتال على الوظيفة الحكومية ثم التهرب منها ليست نتاجاً لكسل الأفراد، بل هي نتاج بيئة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، وإنها تعكس فجوة كبيرة بين الاحتياج والواقع، حيث يبحث الأفراد عن الأمان والاستقرار، ليصطدموا بنظام لا يحفزهم ولا يُقدر جهدهم، وإن معالجة الظاهرة تتطلب إصلاحات هيكلية تبدأ من مكافحة الفساد، مروراً بتعزيز سيادة القانون، وتطوير القطاع الخاص، وانتهاءً ببناء ثقة متبادلة بين الفرد والدولة، عندها فقط، قد يتحول السعي إلى الوظيفة من غاية بحد ذاتها إلى وسيلة للإنتاج والمشاركة في بناء المجتمع.
المصادر
-
أحمد، س. م. (2021). الثقافة الشعبية العراقية: التحايل الاجتماعي بين الضرورة والهوية. بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر.
-
البستاني، ل. ك. (2022). سوسيولوجيا الوظيفة الحكومية في العراق: قراءة نقدية في ثقافة العمل. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
-
عبد الله، م. ح. (2023). “الكلاوات” كظاهرة اجتماعية: قراءة في سلوكيات التحايل المؤسسي. مجلة الدراسات الثقافية العراقية، 12(1)، 77-96.
-
العزاوي، ر. ك. (2019). الاقتصاد الريعي وأثره في بنية الوظيفة العامة في العراق. مجلة دراسات اقتصادية، 8(3)، 101-124.
-
فتحي، ن. ح. (2020). تأثير الفساد الإداري على الأداء المؤسسي: دراسة ميدانية في مؤسسات الدولة العراقية. مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، 15(2)، 55-83.
-
Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
-
Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
-
Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.
-
North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.
-
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, NY: Simon & Schuster.
-
World Bank. (2021). Iraq Economic Monitor: Seizing the Opportunity for Reforms. Washington, DC: World Bank Publications.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...