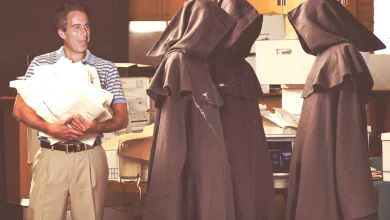د. مصطفى سوادي جاسم
مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
المقدمة
جلست الجدة في ركن الدار، تحيط بها حفيداتها وأحفادها، كأنها كتاب مفتوح يقرأون فيه ذاكرة زمن مضى، بدأت حديثها بصوت رخيم يحمل دفء الحكمة وملح التجربة، فقالت: «كنا نعيش بالقليل فنحس بالكثير، نقتصد في المعيشة فلا نهدر لقمة ولا نضيع درهماً، نرتدي الثوب مرات ومرات، في الأفراح والأعياد، ثم نُرقّعه إذا بلي، فلا نخجل من أثر الزمان عليه، بل نعدّه وسام صبر ورضا، كنا نأكل مما تطبخه أيدينا، طعام البيت الذي تباركه البساطة وتحيطه البركة، فلا نبحث عن المطاعم ولا نلهث وراء ما يُعرض في واجهات المتاجر، كان الماء عندنا نعمة لا تُهدر، نغرفه بقدر حاجتنا، ونطفئ سراجنا عند النوم، كأننا نحرس النعمة من الضياع»
ثم سكتت هنيهة، لترفع بصرها إلى أحفادها بنبرة عتاب: «أما أنتم اليوم، فصرتم تغيّرون الملابس مع كل موضة، وكأن الثياب لا تُلبس إلا مرة واحدة، وتستبدلون الهواتف كما يُبدَّل الحذاء، وتتركون طعام البيت لتلجؤوا إلى المطاعم الفارهة، أنسيتم أن الإسراف يبدد الرزق؟ أن التبذير يطفئ بركة النعمة؟»
كلمات الجدة ليست مجرد حكاية من الماضي، بل هي مرآة تعكس الفارق بين ثقافة جيلٍ تربى على القناعة والاقتصاد، وجيلٍ يعيش في دوامة الاستهلاك والتبذير، ومن هذه المفارقة تنطلق هذه الدراسة العلمية لتسلّط الضوء على ثقافة الاستهلاك عند العراقيين في مجالات الطعام، الكهرباء، الماء، الملابس، الحلاقة والتجميل، ولتكشف عن جذور الظاهرة في ضوء نظريات علم النفس والاجتماع، مع ربطها بالأبعاد الثقافية والدينية، وصولاً إلى مقترحات تسهم في ترشيد السلوك الاستهلاكي وبناء وعي اجتماعي رشيد.
تُعد ثقافة الاستهلاك من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تعكس طبيعة التحولات الاقتصادية والثقافية في المجتمعات الحديثة، فهي لم تعد تقتصر على كونها استجابة لحاجات بيولوجية أو مادية، بل أصبحت سلوكاً رمزياً متشابكاً مع مفاهيم المكانة الاجتماعية، والهوية الفردية، والتمثلات الثقافية.
في السياق العراقي، يكتسب موضوع الاستهلاك أهمية خاصة نتيجة لعوامل متراكمة: الحروب والحصار وما خلفته من ندرة، ثم الانفتاح الاقتصادي وما رافقه من إغراق للأسواق، فضلاً عن ضعف السياسات الاقتصادية والخدمية، هذه العوامل أنتجت سلوكاً استهلاكياً متذبذباً يتراوح بين الإسراف في بعض المجالات (كالطعام والملابس) واللاجدوى في مجالات أخرى (كالكهرباء والماء).
إن دراسة ثقافة الاستهلاك عند العراقيين تكشف عن صورة بانورامية للمجتمع؛ فهي تعكس البنية النفسية التي تدفع الفرد إلى التقليد أو المباهاة أو تعويض النقص، كما تكشف عن البنية الاجتماعية والثقافية التي تضفي معنى على الأكل واللباس والمظهر، وبذلك يصبح الاستهلاك نافذة لفهم التغير الاجتماعي، ومؤشراً على مستوى الوعي والثقافة العامة.
أولاً: الإسراف والتبذير في ضوء القرآن والسنة وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام)
الإسراف والتبذير ليسا مجرد سلوكيات فردية في الاستهلاك، بل هما ظاهرة ذات انعكاسات واسعة حذّر منها القرآن الكريم بوضوح، إذ قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31)، كما وصف المبذرين بأنهم ﴿إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (الإسراء: 27)، وفي السنة النبوية جاء قول الرسول ﷺ: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة» ، ليؤكد أن التوازن هو الأساس، وأكد أهل البيت (عليهم السلام) هذا المبدأ، إذ قال الإمام علي (عليه السلام): «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة»، فيما أوضح الإمام الصادق (عليه السلام): «السرف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغنى».
وتكشف هذه النصوص عن أبعاد متعددة للإسراف:
-
البعد الديني والأخلاقي: الإسراف خروج عن طاعة الله وتضييع للنعمة، وهو يناقض قيمة الاعتدال التي تُعدّ من جوهر الأخلاق الإسلامية.
-
البعد الاجتماعي: التبذير يخلق فجوة بين الطبقات، ويؤدي إلى مظاهر تفاخر فارغة تضعف أواصر التكافل، وتشجع التقليد الأعمى بين الأجيال الشابة.
-
البعد الاقتصادي: الهدر في الموارد – سواء الطعام أو الطاقة أو المال – يضعف قدرة المجتمع على تحقيق التنمية المستدامة، ويزيد من أزمات الفقر والبطالة.
-
البعد النفسي: كثير من أنماط الإسراف ترتبط بمحاولة تعويض شعور بالنقص أو إثبات الذات أمام الآخرين، وهو ما ينسجم مع نظريات المقارنة الاجتماعية وإدارة الانطباعات.
-
البعد البيئي: الاستهلاك المفرط يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية (الماء، الكهرباء، الغذاء)، ويسهم في التلوث والتغير المناخي، مما يجعل الاعتدال ضرورة لحماية البيئة.
وعليه فإن التوجيه الإسلامي إلى نبذ الإسراف ليس فقط نصيحة دينية، بل هو مشروع متكامل لإقامة مجتمع متوازن يحترم النعمة ويستثمر الموارد بشكل رشيد، وهو ما يحتاجه الواقع العراقي المعاصر لمواجهة ضغوط الفقر، شح الموارد، وتحديات البيئة.
ثانياً: الاستهلاك الغذائي
يمثل الطعام في المجتمع العراقي عنصراً مركزياً في الهوية والعلاقات الاجتماعية، فالولائم الكبيرة ليست مجرد طقس غذائي، بل وسيلة للتعبير عن الكرم والمكانة؛ غير أن هذه الثقافة غالباً ما تؤدي إلى الإسراف والهدر، ووفق نظرية الاستهلاك التظاهري لثورستين فبلن، يتحول الطعام من وسيلة لإشباع الحاجة إلى وسيلة لعرض المكانة الاجتماعية، ومن منظور علم النفس الاجتماعي، فإن ضغط الجماعة يدفع الفرد إلى الإفراط في الإنفاق على الطعام تجنباً للنقد أو حفاظاً على صورته أمام الآخرين.
ثالثاُ: الكهرباء
على الرغم من أزمة الكهرباء المزمنة، إلا أن سلوك الاستهلاك يتسم بالتناقض: هناك هدر في استخدام الأجهزة الكهربائية، وعدم اكتراث بترشيد الطاقة، ويمكن تفسير ذلك من خلال نظرية العجز المتعلم لـ سيلغمان، إذ يشعر المواطن بأن جهوده في الترشيد بلا جدوى في ظل غياب سياسات حكومية فاعلة، فيستسلم لسلوك استهلاكي غير رشيد.
رابعاً: الماء
الماء مورد حيوي يعاني العراق من تراجعه بسبب التغير المناخي والسياسات المائية الإقليمية، لكن الثقافة العامة ما زالت تتعامل معه بعده متوافراً بلا حدود، فغسيل السيارات بالمياه الجارية أو الإسراف في الاستخدامات المنزلية من الاستحمام، وترك الماء مفتوحا في مبردات الهواء تعكس غياب الوعي بقيمته، إذ تفسر نظرية الموارد المجانية ذلك بأن الموارد المتاحة تاريخياً بلا كلفة تُستهلك بقدر من التبديد، بينما من منظور اجتماعي فإن غياب التربية البيئية وضعف التثقيف الإعلامي يؤديان إلى ترسيخ عادات غير رشيدة.
خامساً: الملابس
تُظهر أنماط اللباس في العراق ازدواجية بين الزي التقليدي والموضات العالمية المتغيرة، ووفق تصور زيغمونت باومان عن الحداثة السائلة، فإن الأزياء أصبحت مرآة لهويات متحركة وسريعة التغير، نفسياً، يرتبط اللباس بمفهوم صورة الذات، حيث يسعى الفرد إلى بناء صورة مقبولة اجتماعياً حتى لو تطلب ذلك استهلاكاً يفوق إمكاناته المالية.
سادسًا: الحلاقة والمظهر الشخصي والتجميل
لم يعد الاعتناء بالمظهر في المجتمع العراقي يقتصر على الحلاقة التقليدية أو التزيين البسيط، بل توسّع ليشمل الإقبال الكبير على مراكز التجميل وعيادات الجراحة التجميلية، سواء لدى النساء أو الرجال، فقد أصبح تجميل الأنف، وحقن البوتوكس، والفيلر، وتغيير ملامح الوجه، بل وحتى عمليات نحت الجسم، شائعة بشكل متزايد، وغالباً ما تكون مبالغاً فيها.
يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال عدة أطر نظرية:
-
إدارة الانطباعات (غوفمان): حيث يسعى الأفراد إلى بناء صورة مثالية أمام المجتمع، معتقدين أن المظهر المتجدد أو “المحسّن” يرفع من مكانتهم الاجتماعية أو يزيد فرصهم في القبول.
-
الاستهلاك التظاهري (فبلن): فالعمليات التجميلية ليست دائماً حاجة طبية، بل قد تُستخدم كرمز للرفاهية والقدرة المالية، لتأكيد التميز الاجتماعي.
-
نظرية المقارنة الاجتماعية (Festinger): حيث يقارن الفرد مظهره بغيره من خلال ما يراه في الإعلام ووسائل التواصل، فينشأ شعور بالنقص يدفعه إلى عمليات تجميل متكررة.
-
المنظور النفسي – الجمالي: بعض الأفراد يسعون عبر التجميل إلى تعويض مشاعر داخلية مرتبطة بعدم الرضا عن الذات، فيدخلون في حلقة لا تنتهي من التغييرات الشكلية التي قد تصل إلى ما يسمى بـ”اضطراب تشوه الجسم” (Body Dysmorphic Disorder).
وعليه، فإن التجميل في صورته المبالغ فيها لا يعكس مجرد اهتمام بالصحة أو الجمال، بل يتحول إلى مظهر من مظاهر الثقافة الاستهلاكية المعاصرة التي تعيد تشكيل الجسد كسلعة قابلة للتعديل والتحسين المستمر.
سابعاً: الاستهلاك والثقافة العامة
لا ينفصل السلوك الاستهلاكي عن المنظومة الثقافية السائدة في العراق، تُعد قيم الكرم والمظهر من أبرز المحركات التي تبرر الإنفاق المفرط، ووفق نظرية الثقافة المادية، فإن الأشياء المستهلكة تحمل معاني ورموزاً تتجاوز وظيفتها، ومن ثم فإن الإفراط في الولائم أو اقتناء الملابس المستوردة ليس مجرد استهلاك، بل تعبير ثقافي عن المكانة والانتماء.
يلعب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً مزدوجاً: فمن ناحية ينشر صوراً للترف والاستهلاك المبالغ فيه (المطاعم الفاخرة، الماركات العالمية، عمليات التجميل)، ومن ناحية أخرى يفتقر غالباً إلى برامج منهجية لترسيخ الوعي بالاقتصاد والترشيد..
ثامناً: الاستهلاك والوعي الاجتماعي
يُعد الوعي الاستهلاكي أحد المؤشرات الرئيسة على مستوى تطور المجتمع ومدى قدرته على التفاعل العقلاني مع موارده وإمكاناته، وفي الحالة العراقية، يبدو أن الوعي الاستهلاكي يعاني ضعفاً بنيوياً متجذراً في الثقافة الاجتماعية، ويتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية وتربوية متراكبة.
-
ضعف التنشئة الاستهلاكية: لم تحظَ مسألة الترشيد والتخطيط الاستهلاكي بمكانة واضحة في المناهج التعليمية أو البرامج الإعلامية الرسمية، غياب التنشئة الاستهلاكية منذ الطفولة يجعل الأجيال تتبنى عادات استهلاكية قائمة على الإسراف أو التقليد دون إدراك للعواقب، وهنا يمكن استدعاء نظرية التعلم الاجتماعي لــ باندورا، التي تؤكد أن الأفراد يتعلمون السلوك بالملاحظة والتقليد؛ فإذا غاب النموذج الرشيد، تبنّى الناشئة أنماطاً غير واعية في الإنفاق.
-
الأزمات والوعي الآني: الواقع العراقي المليء بالأزمات (انقطاع الكهرباء، شح الماء، تقلبات الأسعار) أنتج وعياً استهلاكياً آنياً يركّز على “إشباع الحاجة الفورية” بدلاً من التفكير بعيد المدى، من منظور علم النفس المعرفي – السلوكي، يُفسر ذلك بظاهرة الإشباع الفوري (Immediate Gratification) التي تدفع الفرد إلى استهلاك غير عقلاني، حتى لو كان على حساب المستقبل.
-
تأثير الإعلام وثقافة التقليد: يلعب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً مزدوجاً: فمن ناحية ينشر صوراً للترف والاستهلاك المبالغ فيه (المطاعم الفاخرة، الماركات العالمية، عمليات التجميل)، ومن ناحية أخرى يفتقر غالباً إلى برامج منهجية لترسيخ الوعي بالاقتصاد والترشيد، وهنا تبرز الآراء المستندة الى نماذج الاستخدامات والإشباعات الاعلامية التي تشير إلى أن الأفراد يستهلكون الإعلام لتحقيق حاجات نفسية واجتماعية، مثل تقليد النماذج الناجحة أو مواكبة الموضة، ما يرسّخ الوعي الاستهلاكي السطحي.
-
البعد الثقافي والقيمي: الوعي الاستهلاكي في المجتمع العراقي مرتبط أيضاً بالنظام القيمي السائد فمثلاً، الإسراف في الطعام يُنظر إليه بوصفه “كرماً”، بينما يُنظر إلى الاقتصاد على أنه “بخل”، هذا التداخل بين الاستهلاك والقيم الاجتماعية يجعل من الصعب إعادة صياغة الوعي دون إعادة تفسير القيم نفسها، من هنا يمكن الافادة من نظرية رأس المال الثقافي لـ بورديو، التي ترى أن الثقافة تحدد أنماط التذوق والاستهلاك، بحيث يُصبح الإنفاق المفرط جزءاً من رأس المال الرمزي الذي يمنح المكانة الاجتماعية.
-
فجوة الوعي بين الأجيال: يُلاحظ أن الشباب العراقي أكثر اندماجاً في ثقافة الاستهلاك العالمي (موضة، تجميل، مطاعم، كافيهات)، بينما الأجيال الأكبر تميل إلى استهلاك أكثر تقليدية، هذا الاختلاف يعكس فجوة في الوعي الاستهلاكي بين جيل يعيش وفق معايير محلية تقليدية وجيل آخر يعيش وفق معايير عابرة للحدود.
-
البعد البيئي والاستدامة: يُظهر ضعف الوعي الاستهلاكي أيضاً في المجال البيئي؛ إذ يُنظر إلى الماء والكهرباء كموارد لا تنضب، رغم أزمات الشح والتغير المناخي، وهذا يتعارض مع مبادئ نظرية التنمية المستدامة، التي تربط الوعي الاستهلاكي بمسؤولية الفرد تجاه الأجيال المقبلة.
إن ضعف الوعي الاستهلاكي في العراق ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو انعكاس لخلل في منظومة التربية والإعلام والقيم الاجتماعية، ولذا فإن تطوير الوعي الاستهلاكي يحتاج إلى إصلاحات تربوية وإعلامية وثقافية تزرع لدى الفرد إدراكاً بأن الاستهلاك ليس فعلاً شخصياً معزولاً، بل مسؤولية اجتماعية وأخلاقية واقتصادية.
ويتضح من استعراض هذه المحاور أن ثقافة الاستهلاك عند العراقيين ليست سلوكاً عشوائياً بل نتاج منظومة معقدة من العوامل:
-
اقتصادية: الاقتصاد الريعي وتذبذب الدخل أدى إلى غياب ثقافة الادخار.
-
سياسية: الأزمات المستمرة أضعفت السياسات العامة التي تعزز الترشيد.
-
ثقافية: القيم الاجتماعية مثل الكرم والمباهاة غذّت الاستهلاك المفرط.
-
نفسية: البحث عن المكانة والهروب من ضغوط الواقع عززا الإسراف.
الاستنتاجات
-
الاستهلاك في العراق يتجاوز إشباع الحاجة إلى تمثيل رمزي وثقافي للمكانة.
-
الإسراف في الموارد (طعام، ماء، كهرباء) يرتبط بغياب وعي بيئي واقتصادي متجذر.
-
الملابس والحلاقة تحولا إلى أدوات لإدارة الانطباع وبناء الهوية في مجتمع متغير.
-
الثقافة العامة والوعي الاجتماعي يلعبان دوراً محورياً في تشكيل أنماط الاستهلاك.
-
غياب سياسات عامة رصينة يترك السلوك الاستهلاكي رهينة للأمزجة الفردية والقيم التقليدية.
التوصيات
-
تربوية: إدماج مفاهيم الوعي الاستهلاكي والبيئي في المناهج الدراسية على نحو منهجي.
-
إعلامية: إطلاق حملات توعية تستهدف تغيير صورة “الكرم المفرط” بوصفه قيمة اجتماعية نحو “الكرم الواعي”.
-
اقتصادية: تشجيع ثقافة الادخار من خلال سياسات مصرفية وحوافز ضريبية.
-
تشريعية: وضع قوانين تلزم بترشيد استخدام الموارد مثل الماء والكهرباء، مع فرض عقوبات على الهدر المفرط.
-
ثقافية: تعزيز دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في نشر قيم الاعتدال، وربط الاستهلاك بالقيم الأخلاقية والدينية.
-
نفسية واجتماعية: توفير برامج تدريبية في إدارة الذات والإنفاق، خاصة للشباب، لمساعدتهم على مقاومة ضغوط الموضة والإعلانات.
-
بحثية: تشجيع الدراسات الأكاديمية حول ثقافة الاستهلاك في المجتمع العراقي وربطها بالتحولات الاجتماعية والسياسية.
المراجع
-
باومان، ز. (2018). الحداثة السائلة (ترجمة: حجاج أبو جبر). المركز القومي للترجمة.
-
الجمعية العراقية للبيئة والتنمية المستدامة. (2020). تقرير الاستهلاك المائي في العراق: الواقع والتحديات. بغداد: وزارة البيئة.
-
سيلغمان، م. (1992).
-
الشريف الرضي، م. بن الحسين. (1998). نهج البلاغة. بيروت: دار المعرفة.
-
الطباطبائي، م. حسين. (1997). الميزان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
-
الطبرسي، ف. بن الحسن. (1995). مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
-
الطوسي، م. بن الحسن. (2005). التبيان في تفسير القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
-
غوفمان، إ. (2008). عرض الذات في الحياة اليومية (ترجمة: محمد الحاج سالم). المنظمة العربية للترجمة.
-
فبلن، ث. (2009). نظرية الطبقة المترفة: الاقتصاد في المجتمع (ترجمة: جورج طرابيشي). المنظمة العربية للترجمة.
-
الكليني، م. بن يعقوب. (1986). الكافي. طهران: دار الكتب الإسلامية. القرآن الكريم.
-
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). (2021). التقرير الإقليمي عن الأمن الغذائي في العراق. روما: FAO
-
Helplessness: On depression, development, and death. New York: W.H. Freeman
-
Douglas, M., & Isherwood, B. (1996). The world of goods: Towards an anthropology of consumption (2nd ed.). Routledge.
-
Ritzer, G. (2011). The McDonaldization of society (6th ed.). Pine Forge Press.
-
Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139–168.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...