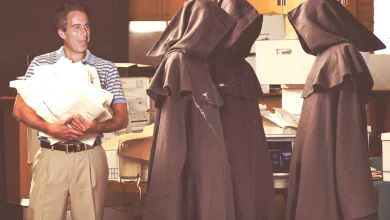بقلم: د. حسن هاشم حمود
باحث في مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
مقدمة
إن حالة التقدم التي تشهدها الثورة الرقمية، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي التي وصلت إلى مرحلة من التطور المستمر التي أعادت تشكيل طرائق تفاعل الأفراد مع محيطهم، إذ وفرت لهم العديد من التطبيقات والخدمات التي جعلتهم مضطرين للإفادة منها، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، كما إن هذه التقنيات تتيح نوافذ يمكن من خلالها متابعة المستجدات الإقليمية والدولية بسهولة، كما ساعدت سهولة استخدامها وانخفاض تكاليفها على جعل الأفراد متفاعلين معها بشكل شبه دائم، حتى وصلت إلى حد الهوس بها، وما احدثته تقنيات الوسائط الجديدة مثل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة، من ثورة في طرائق التواصل والوصول إلى المعلومات، ودورها في زيادة التفاعل وتبادل الأفكار، وفتحت آفاقًا جديدة للتعلم والتعاون بين الأفراد، ومع ما تقدمه من خدمات إلا إنها لا تخلو من آثار سلبية على المجتمع، لقد فتحت بابًا واسعًا امام جميع الأفراد بمن فيهم اولئك الذين لا يجرؤون في الحياة الواقعية على التصرف بشكل سيء أو إضرار الآخرين قولًا وفعلًا اما خجلًا أو خوفًا من عقوبة أو قانون فيجدون في وسائل التواصل الاجتماعي متنفسًا يفرغون فيه بواطنهم من احقاد وضغائن، فضلًا عن اثر الإدمان على هذه المواقع، وانتشار المعلومات المضللة، وتآكل الخصوصية وبحسب هابرماس، فإن الإنسان كفاعل على المسرح العام قد نُفي إلى فضاء موحّد ومعزول عن المجال المنزلي؛ حيث أدى تقليص المجال الخاص إلى حدود الحياة الزوجية الأكثر حميمية، وفقدانه لدوره وتراجُع سلطته، إلى مجرد وهم بوجود مجال شخصي خاص كامل، إذ إن الناس، بعدهم أشخاصاً عاديين، تخلّوا عن دورهم كمالكين، وهو الدور الذي ينطوي على ممارسة شكل من أشكال الرقابة الاجتماعية، مفضلين موقع المستخدمين المحايدين للترفيه فقط، وبهذا، صاروا خاضعين بشكل مباشر لتأثير السلطات شبه العامة، من دون الافادة من الحماية التي يوفّرها فضاء أسري محمي رسميًا، وفي ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري التركيز على الاستخدام الأخلاقي للوسائط الجديدة، من خلال مراعاة خصوصية واستقلالية الآخرين، والانتباه لتأثير الأفعال على الإنترنت، وتعزيز التواصل الدقيق والصادق، كما أن فهم التأثيرات الاجتماعية لهذه الوسائط والتعامل معها على وفق مبادئ أخلاقية يعد أمرًا جوهريًا، لا سيما وأن هذه التقنيات خلقت فضاءات افتراضية تعمل كبديل للتفاعل الاجتماعي المباشر، مما يستدعي وعيًا أكبر بكيفية استخدام هذه الأدوات بشكل مسؤول.

أخلاقيات الإعلام في العصر الرقمي
شهد العالم المعاصر تحولات جذرية في البنية الاتصالية والإعلامية بفعل الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي غيّر طبيعة إنتاج وتداول المعلومات والخطاب الإعلامي، ومع هذا التحول، برزت تحديات أخلاقية غير مسبوقة تتعلق بالصدق والدقة والموضوعية وحماية الخصوصية، فضلاً عن قضايا التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية وانتهاك الملكية الفكرية، ويجب ان تكون اهم محكات اخلاقيات الاعلام في العصر الرقمي هي:
-
المصداقية
أحد التفسيرات المهمة أن الإعلام هو السلطة الرابعة، وأُضيف إليه اليوم بفعل التقدم والتطور في استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المدونين على هذه الشبكة العنكبوتية، وهذان النظامان اليوم يملكان سلطة مراقبة ذوي السلطة والنفوذ لصالح الشعب، فالشعوب في الدول الديمقراطية تريد أن تعرف ما إذا كان أصحاب السلطات الثلاث الأخرى – التشريعية والتنفيذية والقضائية – يؤدون عملهم الذي أنابهم الشعب عنهم على أكمل وجه. فإذا كان الشعب قد فوض أصحاب السلطات الثلاث في إدارة شؤونه من تشريع وتنفيذ وقضاء، فإنه يريد أن يطمئن على أن هؤلاء يعملون لصالحه، أي إن القوانين توضع ويتم تنفيذها لمصلحة الشعب لا لأغراض خاصة، وأن رجال القضاء يحكمون بالعدل. العين التي تراقب هذا بالنيابة عن الشعب هو الإعلام، وكذلك يتفاعلون مع المعلومة التي تُنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تسير اليوم بالتوازي مع عمل الإعلام. من هنا بات يمثل الإعلام السلطة الرابعة، فهو الجهة الموجودة لتطمئن الشعب بأن الأمور تسير على ما يرام أو لتنبهه إلى أن هناك خللاً يحدث. وأن تفعل ذلك يتطلب بالضرورة صدق نقل الأخبار، فالمصداقية تُعد من أهم أسس أخلاقيات الإعلام، إذ تكمن في تقديم المعلومات الدقيقة والتحقق من صحتها قبل نشرها، كما تعتمد على الالتزام بالحقائق وعدم تضليل الجمهور، وكذلك تعزز الثقة بين وسائل الإعلام والمتلقين. في العصر الرقمي، حيث تنتشر الأخبار بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا تصبح المصداقية ضرورة ملحّة لمنع تداول المعلومات المضللة والشائعات التي قد تؤثر على الرأي العام وتسبب اضطرابات اجتماعية.
-
الموضوعية
وهنا يتعين على الإعلامي وكذلك المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي الالتزام بالموضوعية في نقل الخبر أو الواقعة أو الشريط الإخباري، والموضوعية مقصود بها عرض المادة الإعلامية من شتى جوانبها، لا عرضها من جانب واحد، كما تعني عدم تدخل الإعلامي أو المدون على شبكات التواصل الاجتماعي بأهوائه أو ميوله في اختيار جانب معين يعرض من خلاله الموضوع. وإذا ما تم عرض المادة الإعلامية من زاوية محددة؛ لأنه يرى أن هذه هي الزاوية الصحيحة التي من خلالها يتم عرض مادته عرضًا أمينًا، فعليه أن يضع دائمًا إمكانية أن تكون هناك زوايا أخرى من الممكن تفسير الموضوع من خلالها. كذلك تعني الموضوعية ضرورة تحقق الإعلامي من صحة وشمولية مصادره، فالموضوعية مبدأ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصداقية والحيادية، وتقوم على عرض الوقائع والحقائق كما هي، بعيدًا عن التأثير الشخصي أو الأجندات الخاصة. فالموضوعية تساعد في توفير محتوى إعلامي موثوق يمكن الاعتماد عليه، وتعزز القدرة النقدية للجمهور في تقييم المعلومات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة والحقائق، بدلًا من الانجراف وراء المواقف المتطرفة أو المعلومات المضللة.
-
الخصوصية
هناك من يميل عادةً لافتراض أن اقتحام الخصوصية يعد شكلاً من أشكال الاعتداء عليها إذا ما تم من دون موافقة صاحبها، سواء تم هذا الغزو بواسطة الصحفي أو البرامج الإعلامية أو ما يُثار في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم فهو مرفوض أخلاقيًا، إذ إن أدنى ما يعنيه هذا هو عدم احترام أحد حقوقنا بوصفنا أفرادًا. ولهذا السبب فإن القوانين تكفل للفرد صيانة حرمة المنزل والأوراق الخاصة، فليس لأحد الحق في معرفة خصوصياتنا. إن جزءًا مما تعنيه الصداقة هو حقنا في الكشف للأصدقاء فقط عن بعض خصوصياتنا، ومن هنا تكمن قيمة الخصوصية في أنها تمنع الآخرين من ممارسة أي حقوق تضر بنا. ومن هنا كان غزو الخصوصية لا يعني فقط الحصول من دون إذن على معلومات خاصة بنا، بل يعني معرفة الآخرين بالعلاقات والنشاطات والاهتمامات التي نراها لا تهم أحدًا سوانا. ثم إن الخصوصية تمكننا من تنمية هويتنا وشخصيتنا بوصفنا أفرادًا، وإقامة علاقات وصداقات خاصة، بحيث إنه إذا ما قلنا لكل الناس كل شيء يخصنا أو سلكنا المسلك نفسه مع الأصدقاء والغرباء والزملاء، فإن دلالة الكثير من الأفعال الخاصة والأقوال التي نخص بها بعضهم دون بعضهم الآخر ستتلاشى. نحن عادة نختار أن نكشف فقط لبعضهم عن جوانب خاصة من جوانبنا، وهو ما يساعدنا على إقامة علاقات تثري حياتنا.
إلا أن هناك من يرى أنه قد لا يكون لدينا حق في خصوصية بعض المعلومات أو النشاطات التي نمارسها متى كان يجب أن يتم عرض هذه المعلومات والنشاطات في إطار عام، ومتى كان ما يتم ممارسته بصورة خاصة يندرج تحت المصلحة العامة، هنا يزول حق الفرد في الخصوصية. فحق السياسي في الخصوصية لا نقول إنه تم غزوه أو الاعتداء عليه متى قام أحد الإعلاميين أو الصحفيين بالتحري والبحث في أحد شؤونه السياسية الخاصة تحققًا من واقعة فساد مثلًا. ولو اعتبرنا حق السياسي في الخصوصية حقًا مطلقًا، فإن هذا سيعطي الفساد الفرصة للازدهار والتفشي. من هنا لا يُعد بحث الصحفي في الأوراق الخاصة لرجل السياسة اعتداءً على خصوصيته، خاصة إذا كانت هذه الأوراق هي التي ستكشف عن بعض تفاصيل واقعة فساد معينة، بل هو فعل مبرر من أجل المصلحة العامة. إذ لا يمكن إدراج الفساد السياسي مثلًا ضمن الشؤون أو الأفعال الخاصة لأي شخص والتي لا يجب لأحد الاقتراب منها. ومن هنا كان هناك ما يسوّغ البحث في الشؤون الخاصة لذوي السلطة متى كان لدى الصحفيين مسوغ قوي للاعتقاد في تورطهم في إحدى وقائع فساد، كأن يكون هناك اعتقاد أن أحد رجال السلطة هؤلاء قد تلقى مثلًا أموالًا لاستخدام سلطته السياسية. وما يسوغ لرجال الإعلام هذا البحث والتدخل في خصوصية ذوي السلطة أن جمهور العامة قد أنابهم لمعرفة ما إذا كان ممثلو الشعب. لكن حماية الخصوصية في بعض القضايا الشخصية للأفراد هي عنصر أساسي من أخلاقيات الإعلام، وتتمثل في احترام حياة الأفراد وحقوقهم، ومنع الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو استخدامها بطرق تضر بهم. في العصر الرقمي، ومع ازدياد تبادل البيانات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يصبح الالتزام بحماية الخصوصية أكثر أهمية لضمان بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة، وللحفاظ على كرامة الأفراد ومنع استغلال معلوماتهم الشخصية لأغراض تجارية أو سياسية أو اجتماعية.
أما اليوم، وبوجود الكم الهائل من القنوات التلفزيونية والحرية المطلقة أمام النقل والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أضعف ذلك من أهمية هذه القيم والمحكات المهمة أمام نقل المعلومة. بل إن بعض هذه المنصات الإعلامية أصبحت منصات لغرض الابتزاز واستحصال الأموال من بعض الضحايا تحت تهديد النشر أو الفضيحة، مما خلق حالة من تشويه لأهمية هذه القيم، وبعضها يشيطن الآخر من أجل الحصول على أكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات على حساب الضحايا من أفراد المجتمع.
إنّ ظاهرة “الأخبار الزائفة” تُعَدّ من أكثر المواضيع تداولًا في عصر التكنولوجيا المتقدمة، أو العمل على نقل حقائق مجتزئة ضد مكون أو جهة محددة مع إهمال وعدم انتقاد ما يحدث من حوادث مماثلة لمكونات وجهات أخرى.
تشويه الوعي عبر القصف الإعلامي وشيطنة الآخر
تلعب عملية الشيطنة (Demonization) دورًا خاصًا في بنية الحملات الإعلامية المدعومة بالعلاقات العامة والضغط (Lobby). فهي تُعد من المحركات الأساسية لنشر الأخبار الزائفة (Fake News). إن تصوير هدف الحملة الإعلامية على أنه “شيطان” يؤدي مباشرة إلى خلق تصور سلبي جماعي عنه في أقصر وقت ممكن، ويقوض تقريبًا أي فرصة للدفاع عن نفسه، حتى وإن تمكن من إثبات براءته أمام القضاء. هذه الممارسة قديمة الجذور، تعود إلى العصور القديمة، وظلت تُستخدم باستمرار وبأكثر النتائج فعالية. فالشيطنة اليوم أصبحت تقوم على أدوات “تبعد نقرة واحدة” عن الجمهور المستهدف في الحملات الإعلامية، وقد استُخدمت على نطاق واسع في خلق ودعم الفضائح السياسية. كما يمكن ملاحظة كيف يُستثمر ردّ فعل الرأي العام (الرأي الجمعي) في خلق حاجة جماعية لمساندة “قوى الخير” في صراعها مع “الشخصيات الشيطانية”. وعمليًا، فإن تحليل هذه الظاهرة، بمعزل عن أي انخراط سياسي مباشر، يقودنا إلى رؤية شمولية توضّح أن هذه الاستراتيجية في العلاقات العامة هي أساس آليات التلاعب الجماهيري عبر “الأخبار الزائفة”، سواء من خلال الأخبار الزائفة بحد ذاتها، أو عبر استثمار السياقات الناتجة عن شيطنة الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب السياسية أو حتى الدول، باعتبارها مولّدة للأخبار الكاذبة.
إنّ ظاهرة “الأخبار الزائفة” تُعَدّ من أكثر المواضيع تداولًا في عصر التكنولوجيا المتقدمة، أو العمل على نقل حقائق مجتزئة ضد مكون أو جهة محددة مع إهمال وعدم انتقاد ما يحدث من حوادث مماثلة لمكونات وجهات أخرى. وليس ببعيد ما أثاره الإعلام ومواقع السوشال ميديا عن حادثة الدكتورة بان، وفي الوقت القريب هناك حوادث مماثلة حدثت، مثل اغتيال دكتورة في صلاح الدين بالجرم المشهود دون أن يكون هناك أي إدانة أو تصريح واضح يدين الحادثة، كما حصل مع الدكتورة بان. فهذه الانتقائية في التعامل مع الحوادث المتشابهة تشير أصابع الاتهام إلى أن هناك من يحاول شيطنة الآخر.
ومن الجدير بالذكر الاستشهاد بالكاتب الأمريكي سيد فيلد، عراب كتابة السيناريو في هوليود، مستندًا إلى نموذج السرد السينمائي لتوليد التعاطف مع البطل، وبالتالي الرفض الصريح أو الضمني للخصم. من الضروري خلق ديناميكية مواجهة حتى لو لم تكن موجودة في الواقع، باستخدام أدوات التعاطف والنقل النفسي (transference). وهكذا، تتكوّن العملية الخطابية للشيطنة على النحو التالي:
-
استكشاف اهتمامات الجمهور، مما يسمح بتعميقها وتحقيق التعاطف عبر الخطاب.
-
مواجهة اهتمامات المجموعة المراد شيطنتها، بناء نقاط خلاف بين الجمهور المستهدف والمجموعة المراد شيطنتها.
-
الدفاع عن مصالح الجمهور، حيث تُتهم المجموعة المشطنة بالعمل ضد المصلحة العامة أو على الأقل مصلحة الأغلبية.
-
إدخال عبارات قصيرة تمييزية في الخطاب، يجب أن تكون الصفات قصيرة، قليلة، قوية، وسهلة التذكر.
-
تكرار الصفات بشكل متكرر في الخطاب، فالتكرار هو مفتاح الإقناع وإضفاء الطابع المؤسسي على الواقع.
-
تصعيد الهجمات إلى درجة وصم الطرف المقابل.
في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى مفهوم غوفمان حول “الهوية المعطوبة” فيما يتعلق بالوصم (stigmata). يقدّم المؤلف دراسة شاملة لجميع أنواع الوصم، ويركز تحديدًا على القواعد، موضحًا كيف يراقب الفرد الآخر وفق المعاني التي يبنيها المجتمع؛ وهذا ما يسميه غوفمان بـ “رموز الوصم”، والتي تمثل أي إشارات أو دلائل أو علامات ظاهرة تجعل هوية الشخص الموسوم (المُوصَم) قابلة للكشف من قبل الآخرين، وتُستخدم لتمييزه اجتماعيًا بشكل سلبي. هذه الرموز قد تكون مادية أو سلوكية أو لغوية، وتعمل كـ “أدوات اجتماعية” تُذكّر الآخرين بوصمة الشخص، كالعلامات الجسدية والملابس واللغة واللهجة والسلوك الاجتماعي، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخفض قيمة الفرد من قبل المجتمع، الذي يستهلك المعلومات، ويكوّن واقعًا اجتماعيًا، ويصدر الوصم استنادًا إلى هذه العلامات الشائعة.
فضلاً عن ذلك، تقسم هذه الوصوم بين “نحن” (المتكاملون أو الطبيعيون) و “هم” (المنحرفون، المهمشون، “الآخرون”)، وهو تحديد لا يعتمد فقط على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بل أيضًا على القراءة التي يُجريها الأفراد لأنفسهم وللآخرين. ومن خلال هذا المفهوم، يسعى غوفمان إلى توضيح وضع الأفراد المعوقين للحصول على قبول اجتماعي كامل. تُشجع هذه الوصوم على التقليل من قيمة الفرد. في هذا الصدد، تستفيد الشيطنة من هذه الوصوم لتعزيز استخدام الصفات التمييزية وتصعيد الهجمات ضد الموصومين، مما يجعل فصل الآخر عن الطبيعة الأخلاقية المتساوية لنا أمرًا أبسط، وإضفاء صفة الكراهية عليه من خلال الخطاب، المتمثل بخطاب الكراهية والتحريض ضد فئة أو مكوّن أو مجموعة من الأفراد، من خلال التمييز في التعامل مع بعض الحوادث وشيطنتها، وإكسابها صفة رأي عام، وعدم تفاعل أو طرح حوادث مشابهة لها في مكان آخر مختلف مذهبيًا أو قوميًا.
أدوات القصف الاعلامي وشيطنة الوعي
-
العناوين المثيرة (Clickbait)
تشير العناوين المثيرة إلى محتوى أو عناوين مُبالغ فيها تهدف إلى إثارة فضول القراء أو مشاعرهم (عادة الغضب أو الفضول). والغاية الأساسية من ذلك، كما يوحي الاسم، هي دفع القراء إلى التفاعل مع المحتوى لزيادة عائدات الإعلانات، وغالبًا ما يكون هذا النوع من المواد فقيرًا في المحتوى والمعلومات، حيث يُوزَّع النص الهزيل على عدة صفحات من أجل زيادة عدد الإعلانات التي تُعرض للمستخدم.
والأسوأ أن هذا النوع قد ينشر معلومات كاذبة، فيثير غضب القراء ويدفعهم لمشاركة محتوى مكتوب بطريقة رديئة مع شبكاتهم الاجتماعية، مما يؤدي إلى انتشار الأخبار المضللة بين عدد أكبر من الناس.
-
العناوين المضللة (Misleading Titles)
تشبه العناوين المضللة أسلوب العناوين المثيرة في الاعتماد على العاطفة والفضول لجذب القراء، إلا أنه حتى لو كان النص الأساسي مكتوبًا بشكل جيد وصحيح من الناحية الواقعية، فإن العنوان قد يُعطي انطباعًا خاطئًا، مما يجعله نوعًا من “Clickbait” غير المباشر. وتشير الدراسات إلى أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون الأخبار استنادًا إلى العنوان فقط، دون قراءة النص، ومن ثم، إذا لم يعكس العنوان الواقع بدقة، فإنه قد يكون له التأثير ذاته الذي تُحدثه المقالات الزائفة.
-
الدعاية (Propaganda)
تشير الدعاية إلى المعلومات المنحازة والتي قد تكون مضللة، ويتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة بغرض إقناع الجمهور المستهدف باعتناق مواقف أو آراء محددة، وغالبًا ما ترتبط الدعاية بأهداف سياسية أو أيديولوجية، إذ تهدف إلى تشكيل الرأي العام أو توجيهه نحو اتجاه معين، وتستخدم الدعاية مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب الاتصالية، من أبرزها:
-
التلاعب بالعاطفة (Emotional Manipulation): الاعتماد على إثارة مشاعر قوية مثل الخوف، الغضب، أو الفخر من أجل دفع الجمهور إلى تبني موقف محدد دون التفكير النقدي في الحقائق.
-
تشويه صورة الخصم (Demonization) : تصوير الطرف الآخر أو الخصم السياسي على أنه شرير أو خطر يهدد المجتمع، مما يعزز مناخ الكراهية والرفض تجاهه.
-
التكرار (Repetition)::إعادة نشر الرسائل أو الشعارات الدعائية مرات متعددة لتعزيز حضورها في الذاكرة وترسيخها كحقيقة بديهية في أذهان المتلقين.
-
الانتقائية في المعلومات(Selective Presentation): عرض أجزاء من الحقائق التي تدعم وجهة نظر معينة، مع إغفال أو إخفاء الأدلة التي قد تناقضها.
-
استخدام الشعارات والرموز (Slogans and Symbols): الاعتماد على كلمات بسيطة، شعارات رنانة، أو رموز وطنية/دينية تُثير انتماءات الجماهير وتدفعهم إلى الاستجابة دون تحليل منطقي.
-
الاستدعاء الزائف للإجماع (False Consensus): الإيحاء بأن “الجميع” يؤمنون بفكرة معينة، مما يخلق ضغطًا اجتماعيًا على الأفراد للانضمام إلى الأغلبية المتصوَّرة.
-
الربط السببي المضلل (Misleading Causation): نسب نتائج أو أحداث معينة إلى خصم سياسي أو جماعة ما دون أدلة واضحة، لتعزيز الانطباعات السلبية.
الخاتمة
درس هذه المقالة عملية الشيطنة، وعواقبها، وكيف تسهم بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ترسيخ قيمها، من خلال استغلال هذه النظم المعلوماتية من قبل البعض بهدف تشويه الآخر وشيطنة كل ما يقع من فعل أو حادث يتم التعامل معه بازدواجية وانتقائية، بهدف التشهير والتشويه، اللذين يجعلان الإدراك والوعي الجمعي موجهًا نحو هدف محدد بحيث يؤدي إلى تفسير موحّد لأي رسالة، سواء كانت نصية أو منقولة عبر الصورة، من خلال ما يُعرف بـ “القصف الإعلامي”، باعتبار الصورة بناءً ذهنياً، أي تمثيلاً يُنشئه الأفراد حول كيفية إدراكهم للأشياء أو الأحداث أو الأشخاص، خالقًا بذلك رأيًا عامًا يجعل الجمهور يعتقد أن الزيف حقيقة.
المصادر
-
درويش، بهاء، اخلاقيات الميديا، مجلة الاستغراب، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، العدد11، السنة الرابعة، 2018.
-
coman@unitbv.ro , corresponding author, CHANGING PERCEPTION THROUGH MEDIABOMBARDMENT AND DEMONIZATION, Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 14(63) No. 1 – 2021.
-
Sabina Civila and other, The Demonization of Islam through Social Media:
A Case Study of #Stopislam in Instagram, Correspondence: luis.romero@urjc.es, Received: 22 September 2020; Accepted: 24 November 2020; Published: 1 December 2020.
-
JOE ATKINSON, METASPIND: EMONISATIOONF MEDIA MANIPULATION, Political SCIENCE, VOL. 57, NO. 2, DECEMBE2R0 05,.
-
Shakuntala Banaji and Ramnath Bhat, Social Media and Hate, First published 2022by Routledge4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...