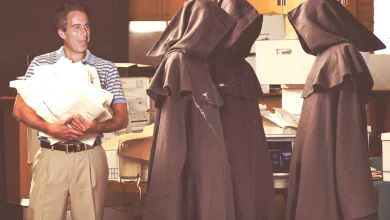بقلم: د. مصطفى سوادي جاسم
باحث في مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
المقدمة
شكّل صعود القوى المدنية والتشرينية في العراق، بعد حراك تشرين 2019، حدثًا استثنائيًا أعاد تشكيل الخريطة السياسية، وفتح أفقًا واسعًا أمام إمكان ولادة طبقة سياسية جديدة تتكئ على الغضب الشعبي والرغبة في بناء دولة عادلة، ومع ذلك، فإن النتائج الانتخابية اللاحقة لم تحقّق الطموح الذي حملته ساحات الاحتجاج، إذ خسر المدنيون والتشرينيون كتلتهم التصويتية المتوقعة، وتراجع حضورهم بل انعدمت تقريبا داخل البرلمان رغم التعاطف الشعبي الكبير مع خطابهم.
هذه الخسارة ليست مجرد “نتيجة صناديق” بقدر ما هي مؤشر عميق على تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية معقّدة، تكشف عن طبيعة المجتمع العراقي، وحدود قدرة الحركات الاحتجاجية على التحول إلى قوة مؤسساتية منظمة وقادرة على إدارة منافسة انتخابية شديدة التعقيد.
أولاً: الخلفيات الاجتماعية لخسارة المدنيين والتشرينيين
-
تشتّت القاعدة الاجتماعية نفسها
لا تمتلك القوى المدنية والتشرينية قاعدة اجتماعية متجانسة يمكن البناء عليها انتخابيًا، فجمهورها يتكوّن من شرائح مختلفة ومتباعدة في خلفياتها واهتماماتها، فهناك الشباب العاطلون عن العمل الذين يبحثون عن فرصة حياة أفضل، والطبقة الوسطى الناقمة على الفساد وتدهور الخدمات، فضلًا عن الفئات المهمشة في الأطراف التي ترى في الاحتجاج وسيلتها الوحيدة لإسماع صوتها، فضلا عن الخريجين الجامعيين الذين يشعرون بالاغتراب عن الطبقة السياسية التقليدية وعدم تمثيلها لطموحاتهم، كما ان الجمهور الكبير الذي خرج في حراك تشرين لا يمثل الجانب المدني فقط بل شمل اغلب فئات الشعب العراقي وتوجهاته بما فيهم الإسلاميين والعقائديين بمختلف انتماءاتهم، وهذا التنوع، ورغم أنه كان مصدر قوة في ساحات الاحتجاج، إلا أنه تحول إلى نقطة ضعف في المجال الانتخابي، لأن غياب رؤية تنظيمية واضحة وموحدة جعل هذه الاتجاهات تتحرك بشكل متباعد، من دون قدرة على توجيه أصواتها نحو هدف سياسي واحد.
-
ضعف الارتباطات الاجتماعية التقليدية
في مجتمع مثل العراق، ما تزال الروابط العشائرية والمناطقية وشبكات النفوذ والزبائنية تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل السلوك الانتخابي، فالقوى المدنية لم تستطع اختراق هذه البنى أو مزاحمتها، ليس لأنها بلا مشروع فقط، بل لأنها بلا أدوات اجتماعية وخدمية قادرة على منافسة نفوذ الأحزاب التقليدية.
-
غياب الموارد المالية وضعف النفوذ الخدمي
واجهت القوى المدنية والتشرينية تحديًا بنيويًا خطيرًا تمثَّل في ضعف الموارد المالية وغياب النفوذ الخدمي، وهو أحد أهم العوامل التي قللت من قدرتها على المنافسة الانتخابية بجدية، فالقوى التقليدية تمتلك منذ سنوات طويلة شبكات مالية راسخة، وواجهات اقتصادية، وأذرعًا خدمية واجتماعية، تُستخدم في تعزيز حضورها داخل المجتمع، وبناء علاقة مباشرة مع المواطن، وتأمين قاعدة انتخابية ثابتة لا تتأثر بسهولة.
في المقابل، اعتمدت القوى المدنية على العمل التطوعي والحماسة الأخلاقية والاندفاع القيمي دون أن تمتلك بنية تنظيمية مالية أو خدمية قادرة على الصمود في بيئة انتخابية شديدة التنافس.
وفي المجتمعات التي تتشابك فيها الاحتياجات المعيشية مع التفضيلات السياسية، يصبح النفوذ الخدمي- المتمثل بالمساعدات، الوظائف، التعيينات، الوساطات، الدعم الصحي والإنساني- عاملًا حاسمًا في توجيه أصوات الناخبين، والقوى المدنية، بطبيعتها الاحتجاجية وغير المرتبطة بمراكز النفوذ، بقيت بعيدة عن هذا المجال، ما جعلها تحضر بقوة في الخطاب، وتغيب بقوة في النتائج.
فضلا عن، غياب التمويل أدى إلى عدم القدرة على استمرار النشاط بين دورة انتخابية وأخرى، فالقوى التقليدية تعمل طوال السنوات الأربع، بينما يظهر معظم المدنيين في موسم الانتخابات فقط، بسبب محدودية الموارد وانعدام المؤسساتية، وهذا الغياب المستمر عن الشارع جعل التواصل مع الناس ضعيفًا ومناسباتيًا، وفقدت هذه القوى القدرة على بناء علاقة ثقة طويلة المدى مع جمهورها.
ثانيًا: اختلالات بنيوية داخل القوى الاحتجاجية
-
كثرة القوائم والتنازع الداخلي
شكّل التشظّي الداخلي واحدًا من أبرز المشكلات التي واجهت القوى التشرينية والمدنية في الانتخابات، إذ دخلت هذه القوى السباق الانتخابي وهي موزّعة على قوائم متعددة وتحالفات صغيرة او كبيرة لكن ضمن تحالفات الأحزاب التقليدية التي كانت تدينها وتتظاهر ضدها والتي تفتقر إلى رؤية مشتركة أو هيكل تنظيمي موحّد، هذا التشتت جعلها تفقد أهم عناصر القوة الانتخابية: تجميع الأصوات.
فبدلًا من خوض المعركة السياسية تحت مظلة موحدة تُعطي الناخب صورة واضحة عن قيادتها وبرنامجها، تفرّقت القوى بين مشروع وآخر، وبين تحالف صغير وآخر أصغر، مدفوعة غالبًا بخلافات شخصية أو تنافس على الزعامة، أو اختلاف في تعريف الهويّة السياسية التشرينية نفسها، وهكذا تحوّل الزخم الشعبي الذي كان يمكن أن يتحوّل إلى كتلة برلمانية مؤثرة، إلى أصوات متناثرة غير قادرة على بلوغ العتبة المطلوبة للفوز في الدوائر الانتخابية، وفي نظام الدوائر المتعددة، الذي يعتمد على كثافة الأصوات ضمن جغرافيا محددة، تصبح وحدة القوى السياسية شرطًا حاسمًا للبقاء. فكل قائمة صغيرة تدخل الدائرة منفردة تزيد من احتمالات تشتيت جمهور الاحتجاج، وتُسهم في إهدار الأصوات التي كان يمكن أن تصبّ لصالح مشروع تغييري واحد لو جرى توحيد الصفوف.
الأدهى من ذلك أن التنازع الداخلي لم يكن مجرد اختلاف تنظيمي، بل تحوّل أحيانًا إلى صراع إعلامي وتخوين متبادل واتهامات بالتمويل والاختراق، مما شوه صورة هذه القوى أمام الجمهور، وأضعف ثقة الناخبين بجدّيتها وقدرتها على إدارة الدولة وهي عاجزة عن إدارة تحالف انتخابي واحد.
-
غياب القيادة الجامعة
شكّل غياب القيادة الجامعة أحد أعمق أسباب ضعف القوى المدنية والتشرينية انتخابيًا؛ فطبيعة الحراك الاحتجاجي التي قامت على البنى الأفقية غير الهرمية منحت التشرينيين قوةً في الشارع، لكنها حرمتهم القدرة على إنتاج قيادة مركزية واضحة تقود العمل السياسي، ومع اقتراب لحظة الانتخابات، ظهر أثر هذا النقص بوضوح، إذ إن العملية الانتخابية تحتاج إلى برنامج موحّد، وهيكل تنظيمي منضبط، وصوت قيادي قادر على اتخاذ القرار وإدارة التحالفات وتوحيد الخطاب، لكن القوى التشرينية بقيت موزعة بين مجموعات متعددة، لكل منها رؤيتها وأساليبها وقراءتها الخاصة للمشهد، فنتج عن ذلك تشتت الخطاب، وتعدد القوائم، وضعف التنسيق، وانعدام القدرة على فرض انضباط داخلي أو توحيد الجهود، وقد أدّى هذا الغياب القيادي إلى ارتباك الناخبين وفقدان الثقة بقدرة هذه القوى على إدارة الدولة، لأنها بدت كتيار متنافر أكثر منه مشروعًا سياسيًا متماسكًا، وبذلك تحوّل ما كان قوة للحراك في الشارع إلى نقطة ضعف في ميدان السياسة، فلم ينجح في ترجمة الزخم الجماهيري إلى حضور انتخابي مؤثر.
-
التردد في الانتقال من خطاب “الثورة” إلى خطاب “السياسة”
شكّل التردد في الانتقال من خطاب “الثورة” إلى خطاب “السياسة” أحد أبرز العوائق البنيوية أمام القوى المدنية والتشرينية، إذ بقي جزء واسع منها أسيرًا لخطاب مثالي أخلاقي يقوم على الرفض والتنديد وإدانة الفساد والمحاصصة، دون أن يرافقه تطوير خطاب سياسي براغماتي قادر على مخاطبة الناخب بلغة الحلول الممكنة، ففي الاحتجاج يمكن رفع شعارات قصوى مثل “إسقاط النظام” و”الثورة مستمرة”، لكن الناخب في صندوق الاقتراع يبحث عن برنامج عملي يجيب عن أسئلة حياتية مباشرة: كيف ستُدار الخدمات؟ كيف سيتم خلق الوظائف؟ ما هي البدائل الواقعية لإصلاح الدولة؟ هذا التردد ولّد فجوة كبيرة بين التوقعات الجماهيرية ومتطلبات العمل السياسي، وجعل الكثير من الناخبين يشككون بقدرة هذه القوى على الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الإدارة، ومع غياب هذا التحول الضروري، بدا المدنيون وكأنهم يكررون الشعارات ذاتها دون تقديم أدوات تنفيذ أو رؤية واقعية قابلة للتحقق، فخسروا جزءًا من الجمهور الذي أراد تغييرًا فعليًا لا خطابًا مثاليًا معلّقًا في الهواء، وبذلك تحوّل الخطاب الأخلاقي من مصدر قوة رمزية إلى عبء انتخابي أفقد هذه القوى القدرة على إقناع الناخب بأنهم بديل سياسي حقيقي قادر على الحكم لا مجرد صوت احتجاجي دائم الاعتراض.
ثالثًا: قراءة في الخطاب المدني والتشريني
-
خطاب أخلاقي أكثر منه سياسي
تركّز الخطاب المدني في جوهره على مقاومة الفساد والسعي لتحقيق العدالة ورفض نظام المحاصصة، لكنه بقي حبيس العموميات والشعارات المبدئية دون أن يتحوّل إلى رؤية سياسية متكاملة تمتلك أدوات التنفيذ، فالمواطن العراقي سمع كثيرًا عن محاربة الفساد منذ 2003، ولم يعد يكفيه التنديد به بقدر ما يحتاج إلى معرفة كيف ستُحارب شبكاته، وما البدائل التشريعية والإدارية المقترحة، وما تكلفة الإصلاح وآثاره، ومع أن مبادئ الخطاب المدني كانت أخلاقية وضرورية، فإنها لم تُترجم إلى برامج تفصيلية في قطاعات أساسية مثل الكهرباء، الصحة، خلق الوظائف، إصلاح المؤسسات الأمنية، معالجة البطالة، أو تحسين بنية الدولة.
وغاب عن هذا الخطاب تقديم دراسات واقعية، أرقام، نماذج تطبيقية، وخرائط طريق قابلة للقياس، فبدا أقرب إلى خطاب احتجاجي مثالي منه إلى مشروع سياسي قادر على الدخول في اختبار الحكم، ونتيجة ذلك، شعر كثير من الناخبين بأن المدنيين يجيدون تشخيص المشكلة لكنهم لا يقدمون حلولها، وأنهم يرفعون شعارات محقة لكنهم يفتقرون إلى الأدوات والمقاربات العملية المطلوبة لإحداث التغيير، وهكذا تحوّل الخطاب، رغم نُبل غاياته، إلى خطاب أخلاقي غير مكتمل، عاجز عن إقناع الناخب بأن التغيير ليس مجرد حلم أو شعار، بل خطة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
-
خطاب موجه للنخب لا للشارع الشعبي
اعتمدت القوى المدنية في الغالب خطابًا موجّهًا إلى النخب أكثر من كونه موجّهًا إلى الشارع الشعبي، إذ استخدمت مفردات فكرية وسياسية عامة مثل “الحوكمة”، و”دولة المواطنة”، و”العدالة الاجتماعية”، وهي مصطلحات قد تحمل مضمونًا مهمًا لكنها لا تتصل مباشرة بتجربة المواطن اليومية ولا تعبّر عن همومه المعيشية المباشرة، ففي الوقت الذي كان الناخب الشعبي يبحث عن خطاب يلامس مشكلاته الحقيقية-الكهرباء، الوظائف، الأمن، الخدمات، فرص السكن- كانت القوى المدنية تقدّم طرحًا نظريًا يبدو أحيانًا مجرد إطار مفاهيمي لا يقدم حلولًا ملموسة، وعلى الجانب الآخر، كانت الأحزاب التقليدية تعتمد خطابًا أكثر بساطة ووضوحًا، يقدّم وعودًا مباشرة وقابلة للفهم السريع، ويستثمر شبكة الخدمات والعلاقات التي يعرفها الجمهور جيدًا.
هذا الفارق في اللغة والتواصل جعل الخطاب المدني يبدو نخبوياً بعيدًا عن الوجدان الشعبي، كما عزز الانطباع بأن المدنيين يتحدثون بلغة “الصالونات الثقافية” لا بلغة الشارع، وهو ما أدى في النهاية إلى ضعف القدرة على جذب الشرائح الأوسع من الناخبين الذين يبحثون عن وعود محددة وحلول ملموسة لا عن مبادئ عامة يصعب ربطها بالواقع اليومي.
-
خطاب تصادمي مع المجتمع نفسه أحيانًا
تجاوز بعض الخطاب المدني حدَّ نقد السلطة إلى نقد المجتمع نفسه، عبر التهكّم على قيمه أو ممارساته، ما جعله يبدو وكأنه يصطدم بثقافة الناس بدل أن يتحاور معها، وهو ما خلق فجوة نفسية مع شرائح محافظة قد تكون ميّالة للإصلاح في أصل موقفها، لكنها تنفر من خطاب يضعها ضمن المشكلة بدل أن يستثمر في استعدادها للمشاركة في الحل.
رابعًا: الإشكالات الثقافية والقيمية في خطاب بعض القوى المدنية والتشرينية
إلى جانب التحديات السياسية والتنظيمية، حمل خطاب بعض القوى المدنية مواقف أثارت حساسية اجتماعية كبيرة وأسهمت في إضعاف جاذبيتها لدى قطاعات واسعة من الجمهور.
-
المجاهرة بالعداء للشعائر الدينية
انتقد بعض الناشطين- علنًا وبحدة- الشعائر الدينية الحسينية وزيارة الأربعين والطقوس المرتبطة بالهوية الدينية، في سياق رغبتهم بإظهار جرأة الخطاب المدني ورفض ما يعدّونه توظيفًا سياسيًا للدين، إلا أنّ هذا المسار انقلب عليهم اجتماعيًا، إذ عده كثير من المواطنين مساسًا مباشرًا بخصوصيتهم الثقافية والروحية، ولا سيما في مجتمع متديّن تُعَد فيه هذه الشعائر امتدادًا للذاكرة الجمعية ومنظومة القيم، وليست مجرد ممارسات طقوسية، وقد أسهم هذا الأسلوب الصدامي في خلق فجوة واسعة بين بعض رموز الحراك المدني وبين جمهور واسع كان يمكن أن يكون شريكًا في الإصلاح، لولا شعوره بأن الهجوم طال ثوابته الدينية بدلاً من أن ينصبّ على مكامن الخلل في الإدارة والحوكمة.
-
السخرية من الرموز الدينية
انتشرت عبر بعض صفحات القوى المدنية محتويات يُفهم منها السخرية أو التقليل من شأن الرموز الدينية، بما فيها شخصيات ومقدسات ذات مكانة مركزية في الثقافة العراقية، وهو ما شكّل حاجزًا نفسيًا كبيرًا مع الجمهور المحافظ، هذا الجمهور قد يكون نفسه من أكثر الفئات انزعاجًا من الفساد وسوء الأداء الحكومي، ويؤمن بالحاجة إلى الإصلاح، لكنه في الوقت ذاته يحتفظ باحترام عميق للرموز والممارسات الدينية التي تُشكل جزءًا من هويته الثقافية والروحية، وعندما يُفهم خطاب المدنيين على أنه هجومي ضد هذه الرموز، يتحوّل إلى شعور بالاغتراب والقطيعة النفسية، فيصبح الدعم المحتمل للإصلاح مستحيلًا أو محدودًا، حتى لو كان هناك توافق على الرغبة في التغيير السياسي، وهذا التوتر بين خطاب الإصلاح من جهة والحساسية الدينية من جهة أخرى أضعف من قدرة المدنيين على تحويل الزخم الاحتجاجي إلى تأثير انتخابي حقيقي، وجعل بعض شرائح الجمهور تنأى عن المشاركة معهم، خوفًا من المساس بمعتقداتهم أو هويتهم المجتمعية.
-
العداء العلني للحشد الشعبي
رغم أن نقد أي مؤسسة حكومية أو أمنية أمر مشروع في أي مجتمع ديمقراطي، إلا أن الخطاب المعادي للحشد الشعبي بصورة شاملة أثار حساسية كبيرة لدى جمهور واسع من العراقيين، الذين يرون في هذه المؤسسة رمزًا للتضحية الوطنية والدفاع عن الوطن في مواجهة الإرهاب، وقد جاء موقف النائب سجاد سالم مثالًا على هذا التوتر، إذ صرح وبشكل واضح رفضه لقانون الحشد والوقوف بالضد منه، بل ذهب ابعد من ذلك بقوله ذهبنا لكل السفارات الأجنبية لمناقشة قانون الحشد!!! وإن تجريد الحشد من قيمته الرمزية واتهامه بشكل مطلق يجعل جزءًا كبيرًا من المواطنين يشعر بأن التشرينيين لا يحترمون تضحيات أبنائهم أو أجدادهم، ومن ثم يشكلون تهديدًا للقيم الوطنية المتوارثة، هذا الأمر خلق جدارًا نفسيًا وثقافيًا بين القوى المدنية وجمهور محافظ يرفض الفساد ويطمح للإصلاح، لكنه يرى في الحشد الشعبي جزءًا من هويته الوطنية والرمزية، ما أسهم في تراجع الدعم الشعبي للتشرينيين على الصعيد الانتخابي، وجعلهم يظهرون، رغم شعاراتهم الإصلاحية، كتيار معارض للهوية الوطنية والتضحيات الجماعية، وهو عامل قلّل من قدرتهم على تحصيل أصوات جوهرية في الانتخابات.
-
غياب المشروع مقابل الاكتفاء بالرفض
ركّز جزء كبير من خطاب المدنيين على رفض الإسلاميين والحكومة والقوى التقليدية بمجملها، من دون أن يُقابَل ذلك بطرح مشروع واقعي بديل يمكن أن يشكل أساسًا لحلول عملية، وبهذا الطابع الاعتراضي الخالص بدا الخطاب سلبيًا قائمًا على الهدم دون البناء، وهو ما أفقده القدرة على إقناع الناخبين أو جذب ثقتهم في إمكانية إحداث تغيير فعلي.
-
الاتكاء على معاداة الأحزاب الإسلامية كهوية سياسية
تحوّل خطاب بعض المدنيين إلى تعريف أنفسهم من خلال “معاداة الإسلاميين” بدل منافستهم ببرنامج أفضل، بينما الناخب العراقي قد ينتقد الإسلاميين، لكنه لا يقبل خطابًا يبدو معاديًا للدين أو للهوية الاجتماعية المحافظة.
خامسًا: البعد النفسي والسوسيولوجي لسلوك الناخب
-
الخوف من المجهول: يخشى كثير من المواطنين التغيير الجذري السريع، ويفضلون “المجرب المعروف” على “المحتج الغاضب”، لا سيما في بلد يعاني من اضطرابات متكررة.
-
الشعور بأن القوى المدنية بلا نفوذ أو حماية: في بلد مضطرب، يبحث الناخب عن قوة سياسية لها قدرة على التأثير والحماية والتفاوض، وهو ما لم يظهر بوضوح في القوى المدنية الجديدة.
-
تراجع الزخم بعد انطفاء لحظة الاحتجاج: الزخم الجماهيري الذي يصاحب أي حراك او انتفاضة لا يستمر طويلًا، ومع مرور الوقت يعود الناخب إلى شبكاته التقليدية، بينما لم تنجح القوى المدنية في ترسيخ نفسها كمؤسسة تستثمر ذلك الزخم.
سادسًا: ما بعد الخسارة – ماذا تكشف هذه النتيجة أن:
-
المجتمع العراقي يحفظ توازناته الاجتماعية والدينية، ولا يستجيب بسهولة لخطابات القطيعة الثقافية.
-
القوى الاحتجاجية تحتاج إعادة بناء خطابها بما ينسجم مع قيم المجتمع لا ضده.
-
التنظيم والبرنامج والقيادة أهم من الشعارات مهما كانت نبيلة.
-
أي مشروع إصلاحي يجب أن يكون إيجابيًا يقدم بديلاً واقعيًا لا مجرد نقد.
الاستنتاجات
-
فشل المدنيين والتشرينيين في الانتخابات لم يكن سياسيًا فقط، بل اجتماعيًا وثقافيًا أيضًا، إذ اصطدمت هذه القوى ببُنى اجتماعية راسخة تتقدم فيها الهويات الدينية والمناطقية والعشائرية على الخطاب المدني الحديث.
-
الخطاب الاحتجاجي، رغم قوته الأخلاقية، لم يستطع التحول إلى مشروع سياسي ناضج، بسبب غياب البرامج التفصيلية، وضعف الهيكل التنظيمي، وتشتت القوائم وعدم وجود قيادة جامعة.
-
الموقف الحاد لبعض القوى المدنية تجاه الشعائر والرموز الدينية والحشد الشعبي خلق فجوة نفسية كبيرة بين هذه القوى وبين المجتمع المحافظ، الأمر الذي أفقدهم التعاطف الشعبي وأضعف ثقة الناخب بهم.
-
اعتماد الهوية السياسية للمدنيين على “رفض الإسلاميين” بدل تقديم بديل أفضل جعل خطابهم سلبيًا، قائمًا على الهدم أكثر من البناء، وهو ما لا يلائم عقلية الناخب العراقي الذي يبحث عن حلول واقعية لا عن صراعات أيديولوجية.
-
تشتت القاعدة الاجتماعية للتشرينيين وغياب التجانس الداخلي حوّل قوة الاحتجاج إلى ضعف انتخابي، فالجمهور الذي يوحّده الغضب لا يوحّده بالضرورة برنامج سياسي واحد.
-
العوامل المادية لعبت دورًا حاسمًا في الخسارة، فالأحزاب التقليدية تتمتع بموارد مالية وشبكات خدماتية واسعة، بينما اعتمدت القوى المدنية على عمل تطوعي لا يستطيع الصمود أمام ماكينة انتخابية راسخة.
-
الناخب العراقي ما يزال يميل إلى الاستقرار والتوازن أكثر من التغيير الجذري، لا سيما في ظل الانهيارات الإقليمية والخوف من الفوضى، وهو ما جعل خطاب الاحتجاج يبدو “مخيفًا” أكثر مما هو “مطمئن”.
-
تراجع زخم الاحتجاج بعد انتهاء اللحظة التشرينية كان طبيعيًا، لكن غياب استراتيجية لدى القوى المدنية للافادة من هذا الزخم حوّلها إلى قوة رمزية غير قادرة على تحقيق نتائج انتخابية ملموسة.
-
الخسارة تعكس خللًا في التواصل وليس فقط في الفكرة، فالتوجه النخبوي في الخطاب المدني وتجاهل اللغة التي يفهمها الجمهور جعلا المدنيين قريبين من المثقفين وبعيدين عن الطبقات الشعبية.
-
رغم الخسارة، يبقى المشروع المدني قابلًا للنهوض إذا أُعيدت صياغته بصورة تنسجم مع الهوية الاجتماعية والدينية للمجتمع، مع خطاب براجماتي وبرامج واقعية، وتنظيم قادر على المنافسة.
الخاتمة
إن خسارة المدنيين والتشرينيين ليست نهاية مشروعهم الإصلاحي، بل هي بداية وعي جديد بحدود الشارع وحدود الصندوق، فالصندوق لا يكافئ الغضب وحده، ولا الشهادة وحدها، ولا الخطاب الأخلاقي وحده، بل يكافئ التنظيم والقدرة والتواصل مع وجدان الناس.
إن على القوى المدنية والتشرينية أن تعيد النظر بخطابها، وأن تتعامل مع قيم المجتمع بذكاء وحساسية، وأن تفرّق بين نقد السلطة ونقد الهوية، وأن تبني مشروعًا لا يقوم على الرفض فقط، بل على تقديم بدائل واقعية.
فالناس تريد التغيير، لكنها تريد التغيير الذي يطمئنها ويحترم قيمها، لا التغيير الذي يصطدم معها.
المصادر
-
المعلومة -“انتخابات 2025.. خسائر متوقعة لنحو 90% من نواب تشرين والمستقلين”
-
“إقبال الناخبين سيحدد نتائج انتخابات العراق لعام 2025” بقلم منقذ داغر
-
الجزيرة نت – “ما التحديات أمام انتخابات 2025؟ وكيف يواجهها العراق؟” للفارس الخيام
-
المجلة (The Majalla) – “انتخابات العراق… الفصائل المسلحة تحل بدلاً عن المدنيين” لسَلام زيدان
-
المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات – “الانتخابات العراقية: هل تحول المشهد السياسي أم تعيد إنتاجه”
-
رؤية نقدية حول ما إذا كانت انتخابات 2025 تشكل تغييرًا فعليًا أم مجرد إعادة إنتاج للنظام الحالي.
-
“التركيبات 2025: التحالفات العراقية في انتخابات 2025”
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...