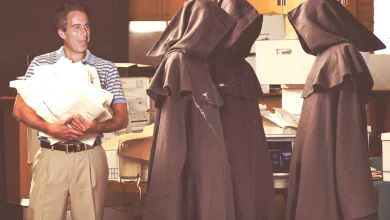اعداد: مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
لم يعد الابتذال ظاهرة هامشية في عالم الإعلام، بل تحوّل إلى صناعة كاملة تُنتج محتوى وتبني جماهير وتصنع نجومًا، وتعيد تشكيل الذوق العام والسلوك الفردي والجمعي، وبينما تبدو هذه الظاهرة كامتداد طبيعي لاستهلاك العصر الرقمي، إلا أنها في جوهرها مشروع اقتصادي- ثقافي يقوم على استثارة الغرائز، وتهميش العقل، وتشييء الإنسان (تسليعه).
وإذا كان الفلاسفة والأديان عبر التاريخ حذّروا من الانغماس في اللذة الفجة ومن الابتعاد عن المعنى والقيم، فإن واقع اليوم يثبت أن صناعة التفاهة أصبحت أخطر من مجرد انحراف أخلاقي، إنها تحويل ممنهج للإنسان إلى مستهلك غرائزي.
أولًا: مفهوم الابتذال وصناعة التفاهة في ضوء الفلسفة والدين
ولفهم هذا المفهوم على نحو أدق، تقتضي العودة إلى جذره اللغوي، إذ يُشتقّ لفظ “الابتذال” من المادة العربية (ب ذ ل)، ويدلّ على ترك الصون وإهدار الحرمة، وقد جاء في المعاجم أن “بَذَلَ الشيءَ” يعني جعله مبتذلًا، أي مطروحًا للعموم بلا قيمة، ورخيصًا بعد أن كان مصونًا ومرفوع المكانة، ومن هذا الأصل تولّد المعنى الأخلاقي والجمالي الحديث للابتذال بوصفه عملية تُسقِط الشيءَ من مقامه، وتنتزع عنه مكانته، وتحوله من مضمون يحمل قيمة إلى سلعة معروضة، ومن جمال يرقى بالذائقة إلى استهلاك يُستثار بالغرائز.
في الاصطلاح العلمي، يُعرَّف الابتذال بأنه: تحويل المحتوى أو السلوك أو الفكرة من مجالها القيمي والمعرفي الرفيع إلى مستوى منخفض يستثير الغرائز الأولية على حساب العقل والمعنى، ويُقدَّم بصورة استهلاكية تكرارية تُفقده جوهره، فيمتد المفهوم في العلوم الإنسانية ليشمل عدة أبعاد:
-
في علم الاجتماع الإعلامي: الابتذال هو إنتاج محتوى يُقصَد به الإثارة السطحية بدل القيمة المعرفية، ويُبنى على التضخيم والتهويل والعرض المُفرِط للجسد أو الحياة الخاصة، بهدف جذب الانتباه على حساب الجودة.
-
في علم النفس الثقافي: الابتذال هو تحفيز المناطق الانفعالية البدائية في الدماغ (اللذة، الصدمة، الفضول السطحي) بدل تحفيز مناطق التفكير والتحليل، مما يجعل المتلقي متفاعلًا غرائزيًا أكثر منه عقلانيًا.
-
في نظريات الاتصال: هو تشويه للرسالة الاتصالية عبر تبسيطها إلى درجة تفقد معها عمقها ودقتها، فيتحول التواصل إلى عرض استعراضي، لا إلى نقل معرفة أو بناء وعي.
-
في الفلسفة الأخلاقية: الابتذال يمثل انحدارًا قيميًا عندما يُنزَع عن الشيء بُعدُه الإنساني أو الجمالي ليُقدَّم في صورة تُشيِّئ الإنسان أو تحوّل الجسد والرغبة إلى أدوات اقتصادية.
-
في فلسفة الجمال: الابتذال هو نقيض الجمال الرفيع، ويُستخدم للدلالة على الرداءة الفنية أو الاستعمال المُفرِط للمثيرات الحسية بشكل يقتل المعنى ويُضعف الذائقة.
ونستخلص من تلك التعاريف أن الابتذال هو عملية تحويل الظواهر والمعاني والمحتويات من مستواها القيمي والمعرفي والإنساني الرفيع إلى مستوى منخفض يقوم على الإثارة السطحية وتحفيز الغرائز الأولية، عبر تشويه الرسالة وتبسيطها المفرط، وتسليع الجسد والانفعال، وإضعاف التفكير العقلاني لصالح الجاذبية اللحظية، وهو بذلك يمثل انحدارًا جماليًا وأخلاقيًا يُفقد الشيء عمقه، ويجرّده من قيمته، ويحوله من معنى يُثري الوعي إلى عرض استهلاكي يُضعف الذائقة ويشوّه الوعي.
يؤكّد ذلك (ألان دونو) في كتابه نظام التفاهة أنّ مجتمعات اليوم تنتج نخبًا فارغة، تصعد في الإعلام لأنها تثير المشاعر لا لأنها تحمل فكرًا أو مشروعًا.
هذه الفكرة نجد جذورها في الفلسفة الكلاسيكية والدين فلو تأملنا في آراء أفلاطون نجد انه حذّر من “كهف الصور” الذي يعيش فيه الناس وهم يتابعون ظلالًا يظنونها الحقيقة- وهو ما يشبه اليوم الاستغراق في المحتوى المبتذل، من جانبه اشار ارسطو أن الإفراط في طلب اللذة يُغلّف الإنسان بطبقة من الانحطاط الأخلاقي مانعًا إياه من بلوغ الفضيلة.
نجد في التراث الديني لا سيما الاسلامي اروع من ذلك، فالقرآن الكريم وضع أساسًا روحيًا راسخًا حين أكد تكريم الإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ الاسراء 70، والابتذال هو انتهاك مباشر لهذا التكريم، وان التراث الحديثي الشريف شدد على مكارم الأخلاق، وعلى الحياء كقيمة تحفظ الإنسان من الانجراف في السلوك المبتذل.
بهذا المعنى، يصبح تسويق الابتذال عدوانًا على العقل والروح والكرامة.
ثانيًا: الآليات النفسية لتحويل الإنسان إلى مستهلك غرائزي
تستخدم المنصات الرقمية مبادئ علم النفس السلوكي لصناعة مستهلك سريع، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال:
-
إدارة الانفعالات بدلًا من مخاطبة الفكر: المنصات لا تتوجه للعقل الواعي، بل تستهدف النظام الانفعالي في شخصية الفرد بعيدا عن التعقل والعقلانية، الذي يستجيب بسرعة ودون تأمل.
-
الدوبامين بوصفه منتجًا تجاريًا: كل محتوى خفيف يخلق جرعة متعة لحظية، فتتولد علاقة إدمانية، تتطابق مع ما وصفه نيتشه بـ إرادة الضعف، حيث يهرب الإنسان من عمق الحياة إلى اللذة السطحية.
-
كسر الاتزان النفسي والمعرفي: حين يعيش المتلقي في عالم الإبهار اللحظي، تتراجع قدرته على التفكير الطويل، ويصبح كما وصفه الإمام علي (عليه السلام): من غلبت عليه الشهوة فهو أسيرها.
ثالثًا: اقتصاد التفاهة- لماذا يربح الابتذال أكثر؟
ينمو المحتوى المبتذل بوتيرة أسرع وأوسع من المحتوى الجاد لاعتبارات اقتصادية وتقنية واجتماعية، مما يجعله صناعة رائجة ومربحة، ويمكن تفصيل هذه الأسباب على النحو التالي:
-
تكلفة إنتاج منخفضة وانتشار سريع: المحتوى المبتذل لا يتطلب ميزانيات ضخمة أو إنتاجًا معقدًا، بل يعتمد على عناصر بسيطة تُثير الانتباه بسرعة، كالصور الصادمة أو الفيديوهات القصيرة، ومن هذا المنطلق، يحقق انتشارًا واسعًا مع جهد قليل نسبيًا، وهو ما يمكن تفسيره من منظور دوركهايم في العدوى الاجتماعية، حيث تميل الجماهير إلى تكرار ما يراه الآخرون دون تمحيص أو وعي ناقد، مما يضاعف سرعة الانتشار ويجعل الابتذال أكثر ربحية وسهولة في الانتشار.
-
خوارزميات تفضّل الإثارة: تعمل منصات التواصل الحديثة على تعزيز المحتوى الأكثر جذبًا للمشاهدات والنقرات، أي المحتوى الصادم أو المثير للغرائز، فالخوارزميات صممت لضمان استمرار تدفق هذا النوع من المحتوى، لأنه يجذب الإعلانات ويحقق أرباحًا أكبر، وبهذا الشكل، تصبح الآليات التقنية حافزًا اقتصاديًا مباشرًا لإنتاج المزيد من التفاهة، بعيدًا عن الجودة أو العمق المعرفي.
-
جمهور متكاسل معرفيًا: المحتوى الجاد يتطلب وعيًا وتحليلًا، بينما المحتوى المبتذل يقدّم نفسه بطريقة مبسطة وغرائزية، فتكون الاستجابة عليه أسرع وأسهل، وهذا الجمهور، الذي لا يسعى عادة وراء المحتوى العميق، يجعل من الابتذال سلعة مرغوبة وقابلة للتكرار، ما يعكس ما وصفه نيتشه بسلوك “القطيع”، حيث يتبع الأفراد ما هو شائع دون إدراك لقيمته أو مضامينه.
-
تسليع الإنسان وانتهاك الكرامة: في سياق الابتذال، يتحوّل الإنسان نفسه إلى سلعة، يُستهلك جسده وسلوكه ومشاعره كجزء من المنتج الإعلامي، وهو ما يمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية، ومن منظور ديني، يتناقض هذا مع المبدأ القرآني: “وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ“، الذي يحذّر من امتهان قيمة الإنسان وتحويله إلى مجرد أداة للربح أو التسلية، فاقتصاد التفاهة لا يربح المال فحسب، بل يربح أيضًا تشييء الإنسان وإضعاف القيم الأخلاقية والاجتماعية.
رابعًا: صناعة “النجم الفارغ” وتحويل الشهرة إلى استعراض
تعمل صناعة الابتذال على إنتاج شخصيات ضجيج بلا أثر حقيقي، تُقدّم كنجوم لمجتمعات الاستهلاك الرقمي، حيث يُستبدل المضمون بالعرض، والفكرة بالجسد، والإنجاز بالجدل، والقيمة باللقطة المؤثرة لحظيًا، وهذه الشخصيات، رغم شهرتها الواسعة، لا تضيف للوعي الجمعي أي فائدة معرفية أو جمالية، بل تصبح مجرد أدوات لجذب المشاهدات والإعلانات.
وفي هذه المناخات سيعيش الإنسان بلا هدف أو غاية حقيقية، متكيفًا مع ثقافة الاستهلاك اللحظي ومتخليًا عن أصالته وهويته، ويترسخ لديه مفهوم النجاح على أساس الظهور والضجيج لا على الإنجاز أو الفكرة، فتتراجع قدرة المجتمع على التمييز بين القيم الحقيقية والمظاهر الزائفة.
من منظور فلسفي يغرق الفرد في الانشغال بالسطحي والمألوف ويغفل عن التفكر في المعنى والوجود الأصيل، وكما يمكن ربطه بمفهوم القطيع عند نيتشه، حيث يتبع الناس ما هو شائع بلا تمحيص أو وعي.
أما من المنظور الديني، فقد جاء التحذير صريحًا في الحديث الشريف: “من تشبّه بقوم فهو منهم“، وهو تحذير من الانسياق وراء نماذج بلا مضمون أو قيم، والتقليد الأعمى للشهرة الظاهرية دون النظر إلى الجوهر الأخلاقي أو الروحي. ويؤكد التراث الإسلامي على أهمية الحرص على أصالة الفرد، وعدم السماح للسطحية والابتذال بإلغاء القيمة الجوهرية للإنسان، ليظل معيار التقدير قائمًا على المعرفة، الأخلاق، والفضيلة لا على المظاهر الفارغة.
خامسًا: الآثار السلبية على الفرد والمجتمع
-
تآكل الذوق العام: تتراجع قيمة الفن واللغة، ويصبح الجميل هو ما يثير اللحظة، لا ما يثري الروح.
-
تشويه الهُوية: يُعاد تشكيل خيال المراهقين وفق صور مشوّهة للنجاح والمكانة، كما أشار ابن خلدون إلى أنّ الترف يفسد العمران حين تتحول الذائقة من قيم إلى مظاهر.
-
صعود السلوك القطيعي: ما وصفه نيتشه بـ القطيع يتجسد اليوم في التقليد الرقمي للمحتوى الرائج.
-
اغتراب الإنسان عن ذاته: يتحول الفرد إلى قيمة سوقية بدل كونه كائنًا معنويًا، وهذا يناقض جوهر الفلسفة الإنسانية والرسالات السماوية.
سادسًا: دوافع المنصات إلى تسويق الابتذال
تسويق الابتذال ليس مجرد نتيجة عرضية للثقافة الرقمية، بل هو نتاج تفاعلي بين المنصات الرقمية، الاقتصاد، الجمهور، والبنى الأخلاقية والاجتماعية، ويمكن تفصيل دوافع المنصات إلى تسويق هذا النوع من المحتوى على النحو التالي:
-
الربحية القصوى على حساب الأخلاق: المنصات الرقمية تعمل وفق نموذج اقتصادي يركز على زيادة الإيرادات من خلال جذب أكبر عدد من المستخدمين والمشاهدات، والمحتوى المبتذل والصادم يحقق معدلات تفاعل عالية، وهو ما يترجم مباشرة إلى أرباح أكبر من الإعلانات والرعايات، وهنا الأخلاق تتحول إلى متغير ثانوي أمام المنطق الربحي، حيث يصبح المبدأ التوجيهي هو “ما يثير المشاهدين يُربح المال”، بصرف النظر عن التأثير الثقافي أو النفسي على الفرد والمجتمع.
-
ضغط المعلنين والمحتوى المدفوع: المعلنون يميلون إلى المحتوى الذي يحقق أعلى نسب وصول وتفاعل، بصرف النظر عن جودة الرسالة أو عمقها، والمنصات تستجيب لهذا الضغط بتقديم مساحات أكبر للمحتوى المثير، حتى لو كان مبتذلًا أو عديم القيمة، وهذا يخلق دائرة مغلقة بين المنصة، المعلن، والجمهور، حيث تتحول الإثارة والصدمات إلى عملة ربحية فورية.
-
غياب التشريعات الأخلاقية والتنظيمية: ضعف أو غياب الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم المحتوى الرقمي يتيح للمنصات حرية شبه مطلقة في تحديد ما يُعرض، وفي بعض الدول، التركيز على حرية التعبير يفوق الاهتمام بالرقابة الأخلاقية، ما يؤدي إلى انتشار الابتذال بسهولة دون محاسبة أو ضوابط واضحة، كما أن نقص التشريعات الفاعلة حول حماية الذوق العام يترك مساحة كبيرة للمحتوى المبتذل ليصبح معيارًا سائدًا.
-
دعم الخوارزميات للمحتوى الصادم والمبتذل: الخوارزميات الرقمية، التي تشكل جوهر التوصية والإظهار على منصات التواصل، تميل إلى تعزيز المحتوى الذي يثير الانفعالات السريعة. المحتوى الصادم أو المثير للغرائز يولد أكبر قدر من التفاعل اللحظي (نقرات، مشاهدات، تعليقات)، وبالتالي يُفضّل من الناحية التقنية والاقتصادية، وهذا يؤدي إلى تضخيم الابتذال بطريقة ممنهجة، بحيث تصبح الاستجابة العاطفية اللحظية هدفًا رئيسيًا لتصميم المحتوى.
-
هشاشة التربية الأخلاقية والدينية في الأسرة والمدرسة: ضعف التنشئة الأخلاقية والدينية، سواء في الأسرة أو المؤسسات التعليمية، يجعل الأفراد أكثر قابلية للتأثر بالمحتوى المبتذل، وغياب الوعي الناقد والإرشاد السلوكي يزيد من احتمالية الانغماس في هذه الثقافة الرقمية، ويخلق جمهورًا مستعدًا لتقليد السلوكات الفجة دون وعي بخطرها على القيم والمعايير، والتراث الديني والفلسفي أكّد دائمًا على دور التربية في صون الفضيلة والكرامة، ومن دونها يصبح الفرد عرضة للاستغلال والإغراء اللحظي.
وخلاصة الكلام يمكن القول إنّ تسويق الابتذال ليس مجرد محتوى عابر، بل مشكلة حضارية تُشوّه الذائقة، وتعيد تشكيل الوعي، وتدفع الإنسان نحو الاستهلاك الغرائزي على حساب العقل والروح والكرامة، وما بين تحذيرات الفلاسفة من الانغماس في اللذة السطحية، وتوجيهات الأديان نحو تهذيب النفس وصون الأخلاق، يصبح من الواجب إعادة بناء منظومة ثقافية تعيد للإنسان مكانته الطبيعية ككائن عاقل، مكرّم، حامل للمعنى لا عبدًا للغرائز.
الاستنتاجات
-
الابتذال ظاهرة منهجية وليست عفوية: لم يعد الابتذال مجرد محتوى هامشي أو انحراف فردي، بل أصبح مشروعًا اقتصاديًا- ثقافيًا متكاملًا يستهدف تحويل الإنسان إلى مستهلك غرائزي وإضعاف قيمه العقلية والأخلاقية.
-
أثر الابتذال متعدد الأبعاد: يشمل الابتذال أبعادًا معرفية ونفسية واجتماعية، إذ يؤدي إلى تآكل الذوق العام، وتشويه الهُوية، وصعود السلوك القطيعي، واغتراب الإنسان عن ذاته ومكانته المعنوية.
-
دور المنصات الرقمية محور أساسي: يعتمد انتشار الابتذال على آليات تقنية واقتصادية، مثل الخوارزميات التي تفضّل المحتوى الصادم، وانخفاض تكلفة إنتاجه، وضغط المعلنين لتحقيق الربح، إضافة إلى ضعف التشريعات الأخلاقية.
-
البعد النفسي والغريزي للمستهلك: يُظهر الابتذال تحفيز الانفعالات الأولية والغريزية لدى المتلقي، ما يقلل قدرته على التفكير الناقد والتحليل، ويجعل العلاقة بالمحتوى قائمة على التسلية اللحظية وليس على المعرفة أو الفهم.
-
تحذيرات فلسفية ودينية مؤكدة: التحليل يوضح توافق التحذيرات الفلسفية (أفلاطون، أرسطو، نيتشه) والدينية (القرآن الكريم، السنة النبوية) من مخاطر الانغماس في التفاهة، حيث يؤدي إلى فقدان المعنى والقيم وامتهان كرامة الإنسان.
التوصيات
-
إعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية- حماية الإنسان من التشييء واستغلال جسده أو سلوكه كسلعة، وفق المبادئ الدينية والفلسفية، وتعزيز وعي المجتمع بالقيمة الجوهرية للفرد.
-
تعزيز التربية الإعلامية والنفسية- تعليم الجمهور، لا سيما الشباب، تحليل الرسائل الخفية، كشف الاستغلال، وتفادي الاستجابة الانفعالية اللحظية، بما يتوافق مع دعوة كانط لاستخدام العقل دون وصاية.
-
إنتاج محتوى بديل وراقي- التركيز على صناعة محتوى يجمع بين الجاذبية والأسلوب الأخلاقي والمعرفي، ليكون بديلاً جذابًا للمحتوى المبتذل دون اللجوء إلى القمع أو الحجب الكلي.
-
دور الأسرة والمؤسسات الدينية والثقافية- توجيه الأفراد، تقديم قدوات حقيقية، وتعزيز قيم الحياء والأخلاق، بعدِّها حارسًا نفسيًا ضد الانجراف خلف التفاهة.
-
تشريعات وتنظيمات تحمي الذوق العام- وضع سياسات وقوانين إعلامية وأخلاقية تحمي الفضاء العام من التلوث الاتصالي، كما دعا هابرماس إلى حماية الفضاء العام من الانحدار الثقافي والاجتماعي.
-
مواجهة اقتصاد التفاهة- الحد من الربحية المفرطة على حساب الأخلاق من خلال ضغط مجتمعي وتنظيمي، ومساءلة المنصات الإعلامية عن المحتوى الذي يروج للابتذال، وتطوير خوارزميات تشجع المحتوى القيمي والمعرفي.
المصادر
القران الكريم
-
دغوغي الإدريسي. (2020). التفاهة في الإعلام والتواصل الاجتماعي. الرباط: دار الفكر المعاصر.
-
أخدوش، ح. (2020). صناعة التفاهة والتلاعب بالذوق العام.
-
مجلة كل العرب. (2025). انتشار ثقافة التفاهة في المجتمع: المظاهر والعوامل والأخطار ودور التفكير الناقد في مواجهتها.
-
جامعة بابل. (2024). أكاديميون يحذرون من تنامي ظاهرة التفاهة وانحدار الذوق العام.
-
الجزيرة نت. (2025). الأخلاق في عصر التفاهة: حين تصبح القيم محض شعارات.
-
Deneault, A. (2018). Mediocracy: The politics of the extreme centre. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
-
Postman, N. (1992). Media triviality. New York: Vintage Books.
-
Ferguson, D. A. (2021). The trivial pursuits of mass audiences using social media. Journal of Digital Media Studies, 12(3), 45–67.
-
Smith, J. (2024). Between triviality and false consciousness. Social Theory Review, 19(2), 88–105.
-
Johnson, L., & Carter, P. (2021). Superficiality and representation: Adding aesthetics to knowledge without truth. Aesthetics & Culture Journal, 7(1), 15–32.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...