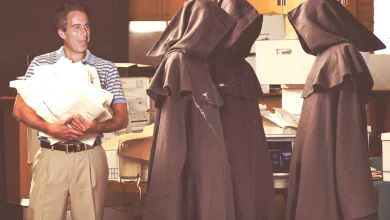بقلم: أ. د. عباس علي شلال
تُعدّ الشخصية أحادية العقلية واحدة من أكثر البنى النفسية التي تُعيق الإنسان عن رؤية العالم كما هو، لا كما يريده أن يكون، وإنها شخصية تصنع لنفسها جدارًا معرفيًا يمنعها من استقبال المعنى الجديد، وتتمسّك بتفسيرات جاهزة، وتنظر للمواقف عبر ثنائيات حادة: حق/باطل، خير/شر، معنا/ضدّنا.
هذا النمط ليس مجرّد “صفة” بل منظومة نفسية كاملة تتعلق بضعف النضج، وانخفاض التمايز، والجمود المعرفي والانفعالي.
أولاً: التدرّج الانفعالي مقابل ذهنية “الكل أو اللاشيء“
تؤكد الدراسات التخصصية أنّ النضج النفسي يتجلى في القدرة على التدرّج العاطفي: أن نفرح بدرجات، ونغضب بدرجات، ونحزن بدرجات، بينما يفتقر الشخص غير الناضج لهذا الطيف الانفعالي، فيستجيب كما لو كان يضغط زرًا واحدًا: إمّا اندفاع كامل أو انطفاء كامل.
ولعلّ النموذج الأكثر حضورًا هو ذلك الشخص الذي يفسر أي خلاف فكري على أنه عداء شخصي، ففي كثير من النقاشات الاجتماعية، نرى من يتعامل مع الرأي المخالف وكأنه طعن في الذات، فيتحول الحوار فجأة إلى مواجهة، ويسمي علماء النفس هذه الحالة اندماج الذات بالفكرة Ego-Fusion، حيث لا يستطيع الفرد التفريق بين اعتقاده وبين قيمته الذاتية.
وهنا يصبح الغضب حادًا، والدفاعية قوية، وردود الفعل غير متدرجة، فيُدار الموقف كله بذهنية (معي أو ضدي).
من الناحية الثقافية، يظهر هذا النمط عند الأشخاص الذين يعتقدون أن الموقف يجب أن يكون حادًا دائمًا، وأن الغضب لا بد أن يكون انفجارًا، وأن الفرح لا بد أن يكون ضجيجًا، وهو ما يجعلهم أقرب للحياة الانفعالية للطفل، التي وصفها جيرسيلد بأنها اندفاع شبه آلي.
وما لم يتعلم الفرد كيف ينظّم انفعالاته، سيبقى عقله حبيس الثنائيات.
ثانيًا: التكرار الآلي للسلوك- جذر الاضطراب وغياب المرونة
يرى بعض الباحثين أن أساس العصاب ليس الألم النفسي، بل إعادة إنتاج السلوكات نفسها بطريقة جامدة حتى وإن تغيّرت الظروف.
هنا لا تكمن المشكلة في البيئة، بل في طريقة الاستجابة، ويظهر هذا النمط بوضوح في المؤسسات، مثلًا، يعارض بعض الموظفين أي تحديث إداري أو نظام إلكتروني جديد لمجرّد أنه لم يكن موجودًا سابقًا، وهذا الرفض ليس عقلانيًا دائمًا، بل يعكس خوفًا داخليًا من التغيير، وما تسميه كارول دويك عقلية الجمود.
إنه تكرار قهري للأساليب القديمة، حتى لو أثبت الواقع عدم جدواها.
وفي الثقافة العامة، نرى من يردد الشعارات ذاتها، والاتهامات ذاتها، ويستخدم القوالب ذاتها مهما تغيّر الزمن، إنه شكل من الفقر المعرفي حيث لا يملك الفرد سوى أداة واحدة في صندوق أدواته الذهنية.
ثالثًا: الحياة ديناميكية
لماذا يبقى بعض الناس ثابتين؟
تقدّم التوجهات الثقافية المتحررة رؤية مهمة: الحياة بطبيعتها متغيرة، والتوافق يتطلب تغييرات في التفكير والسلوك، والفرد السوي يمتلك بدائل، ويعدل خططه، ويغيّر أدواته، ويخفض أو يرفع جهده.
أما الشخص أحادي العقلية، فليس لديه سوى مسار واحد، لا يعرف تغيير الطريقة، ولا يرى البدائل، ولا يعيد تقييم الهدف.
وتظهر هذه الحالة مثلاً في الشاب الذي لا يزيد في تعلمه ولا يسأل ويرفض الإفادة من أي لقاء علمي او تعليمي، فهو يعاند ويرفض حضور ورش أو دورات تدريبية لأنه يعتقد أنه لا يحتاج أن يتعلم أكثر.
هذه ليست ثقة بالنفس، بل هي صدمة التعلّم Learning Shoc، وهو خوف داخلي من المعرفة الجديدة لأنها تهز تصورات الفرد المستقرة عن نفسه.
ومن هنا تظهر المشاعر السلبية كالعجز، الفشل، الانسحاب، العداء للمجتمع، ورفض التجديد.
رابعًا: رؤية ليفين وتمييزه بين السلوك المتصل والمتقطع
طرح “كيرت ليفين” مفهومًا مهمًا: الشخصية السوية تمتلك “مطاطية” تسمح لها بعبور الصراع دون توقف، أما الشخصية المتصلبة، فتميل إلى “السلوك المتقطع”، الذي يتوقف عند أول عقبة.
نرى ذلك في ربّ الأسرة الذي يرفض تمامًا أي نقاش يخالف قناعاته، فهو لا يملك قدرة على الاستمرار في الحوار، بل يتحول الاختلاف البسيط إلى أزمة حادة.
هذا النمط يجسّد انخفاض التمايز النفسي الذي تحدث عنه ليفين؛ حيث يمتلك الفرد عددًا محدودًا من الاستجابات الممكنة.
خامسًا: النفور من الغموض- أزمة ثقافية قبل أن تكون نفسية
تؤكد برونشفيك أن بعض الناس لا يحتملون المواقف الغامضة، فيسارعون إلى تقسيم العالم إلى ثنائيات: صحيح/خاطئ، أبيض/أسود.
وهذا ما يجعل أصحاب العقلية الأحادية يكرهون الأسئلة المفتوحة، والانتظار، والبحث، والتفكير المركب.
ويتجلى هذا في كثير من السياقات اليومية: كالسياسي الذي يرى كل نقد استهدافًا وليس حقًا طبيعيًا، وهذا السلوك يكشف هشاشة داخلية تبحث عن اليقين، لا عن الحقيقة، كما يرى إريك فروم أن الشخص المنغلق يبحث عن الأمان أكثر مما يبحث عن المعرفة.
وفي الثقافة العربية، يظهر هذا في الأحكام الاجتماعية الجاهزة، التفسيرات السريعة، تحويل الاختلاف إلى نزاع، واختزال الواقع السياسي في معسكرين متقابلين، وهو ما يكون سببًا في فقدان الحاضنة اللازمة لقبول النظم الديمقراطية.
سادسًا: الفقر البنيوي للشخصية وارتباطه بالجمود\
يرى “كونين” أن الشخصية التي تفتقر إلى التمايز الداخلي تصبح ضعيفة أمام متغيرات الحياة، فكلما قلّ تنوع القدرات والاتجاهات، قلّت قدرة الفرد على مواجهة التنوع الخارجي.
وفي الواقع نرى الكثيرين ممن لا يجيدون تغيير خططهم، ولا يملكون بدائل، ولا يتحملون الفشل، ويخشون كل جديد، ويظهر ذلك بوضوح في التدريسي والشخصية الأكاديمية التي ترفض المناهج والنظريات الحديثة بحجة أنها غير مألوفة.
هذه ليست حماية للمنهج، بل جمود معرفي يقف في وجه التطور.
سابعًا: الدوغماتية- النسخة الصلبة من العقل الأحادي
يقدّم روكيتش مفهوم الدوغماتية بعدِّها مقاومة التغيير على مستوى شبكة المعتقدات كلها، وليس فكرة واحدة، وهنا يصبح العقل أشبه بغرفة مغلقة، تتردد فيها الأصوات نفسها، ويُعاد إنتاج القناعة القديمة بلا مراجعة.
إنها النسخة الأكثر صلابة من العقلية الأحادية، حيث لا تعمل الحقائق، ولا تؤثر التجارب، ولا تنفع الحجج، ولا يُفسح المجال للحوار.
ثامنًا: الانغلاق الفكري- حين يصبح الجمود خطرًا عامًا
يشير بعض المفكرين إلى أن الانغلاق الفكري ليس مجرد ميل فردي، بل ظاهرة اجتماعية خطرة، وعندما تنتشر العقلية الأحادية في المجال العام، يصبح المجتمع أسيرًا لثنائيات ضيقة، ويفقد قدرته على الإبداع والتطور.
فالمشهد العام يميل إلى التعصب، الانقسام، رفض الجديد، إقصاء المختلف، وانهيار الحوار، وتلك السمات تُضعف أي مشروع ثقافي أو سياسي أو نهضوي.
يمكن لنا أن نستخلص ان الشخصية أحادية العقلية ليست مجرد نقص في المرونة، بل منظومة نفسية وثقافية كاملة تقوم على جمود انفعالي، فقر معرفي، نفور من الغموض، تفضيل الثنائيات، ضعف التمايز الداخلي، مقاومة التغيير، وانغلاق فكري.
إن مواجهتها تتطلب تعزيز التفكير المرن، قبول الغموض كجزء طبيعي من الحياة، تربية عقل متنوع الوظائف، تشجيع الحوار، وتعلّم رؤية العالم بدرجاته، لا بثنائياته الصلبة.
الاستنتاجات
-
الشخصية أحادية العقلية ليست عرضًا عابرًا، بل هي بنية نفسية- معرفية متكاملة
يتضح من التحليل أنّ هذا النمط الشخصي يقوم على شبكة من العناصر المتشابكة: ضعف النضج الانفعالي، الجمود المعرفي، ضيق دائرة البدائل، وانخفاض التمايز الداخلي، وهذا يجعلها أكثر من مجرد “طريقة تفكير”، إنها منظومة كاملة تُعيد إنتاج ذاتها باستمرار.
-
الانغلاق ليس نتيجة جهل بالضرورة، بل غالبًا نتيجة خوف
تكشف المؤشرات النفسية عن أن جذور العقل الأحادي ترتبط بالخوف من التغيير ومن المعرفة الجديدة، وهو ما يظهر في ظواهر مثل صدمة التعلّم، والهشاشة الداخلية التي تحتاج لليقين لتعويض ضعف الشعور بالأمان.
-
ذهنية “الكل أو اللاشيء” تعبّر عن نضج انفعالي منخفض
فالعجز عن التعامل مع الانفعالات بدرجات، وتحويل الخلاف إلى تهديد للذات، مؤشران أساسيان على اندماج الفكرة بالهُوية، وهذا يجعل الحوار مستحيلًا، لأن أي اختلاف يُفسَّر كعداء مباشر.
-
الجمود السلوكي يأتي من تفضيل ما هو “مألوف” لا ما هو “فاعل”
يتضح أن كثيرًا من السلوكات المتكررة ليست عقلانية، بل هي آليات نفسية دفاعية تفضّل الماضي لمجرد أنه مألوف، حتى إن أثبت الواقع فشله، وهذا يؤثر ليس فقط على الأفراد، بل على المهمات الإدارية، والأطر المؤسسية، والمجال العام.
-
النفور من الغموض أحد أهم جذور الانغلاق العقلي،
ويعاني العقل الأحادي من هشاشة في التعامل مع التعقيد، فيلجأ إلى تبسيط العالم إلى ثنائيات حادة، وهذا الميل يشكّل عائقًا رئيسًا أمام التفكير العلمي، والتفكير الهادف، والقدرة على اتخاذ قرارات مرنة.
-
كلما ضعُف تنوّع الوظائف النفسية والمعرفية، ارتفع مستوى الجمود
يؤكد التحليل أن الفقر البنيوي للشخصية يجعل الفرد عاجزًا عن تعديل استجاباته، وتغيير أدواته، وتطوير مهاراته، وهذا يظهر في أنماط رفض التعلم، ومقاومة التدريب، ورفض المناهج الجديدة حتى في المؤسسات الأكاديمية.
-
الدوغماتية هي الشكل المكتمل للعقلية الأحادية
حين يصبح الرفض شاملًا لكل تغيير على مستوى شبكة المعتقدات، يتحول العقل إلى بنية مغلقة بالكامل لا تسمح بدخول أي معنى جديد، وإنها ليست فقط جمودًا، بل مقاومة نشطة للتجديد.
-
انتشار العقل الأحادي يشكل خطرًا على المجال الاجتماعي والسياسي
فحين تُصبح الثنائية (مع/ضد) هي لغة المجتمع، ينهار الحوار، ويتعطل الإبداع، وتضعف قدرة الناس على إدارة الاختلاف، وهذه البيئة تُفسد الديمقراطية، وتزيد الانقسام، وتمنع بناء مشاريع نهضوية مستقرة.
-
العقل الأحادي يقود إلى أزمة في الهُوية أكثر مما يقود إلى أزمة في التفكير
لأن الفرد يصبح محتاجًا للدفاع عن أفكاره كمن يدافع عن نفسه، فتغيب القدرة على إعادة التقييم، وتغيب فضيلة الاعتراف بالخطأ، ويصبح الاعتقاد جزءًا من تقدير الذات.
-
المعالجة تبدأ من بناء عقل مرن لا من مواجهة الخطأ مباشرة،
والحلول الفاعلة لا تقوم على كسر الجمود بالقوة، بل عبر تعزيز القدرة على تدرّج الانفعال، قبول الغموض، توسيع البدائل، ممارسة التفكير الايجابي الهادف، تدريب الانفتاح على المعرفة الجديدة، ودعم الحوار بوصفه آلية للتعلم لا للمواجهة.
المصادر Top of Form
-
شحاتة، حسن. (2014). الإبداع وتنمية التفكير. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
-
عبد الستار إبراهيم. (2007). علم النفس المرضي المعاصر: سوء التوافق والاضطرابات. القاهرة: دار النهضة العربية.
-
عبد الله، عبد الرحمن. (2015). الدوغماتية والاتجاهات المغلقة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
-
فروم، إريك. (2016). الخوف من الحرية (ترجمة: محمود منقذ الهاشمي). دمشق: دار الحوار.
-
مرعي، عبد العزيز حسين. (2018). التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. عمّان: دار المسيرة.
-
Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House.
-
Rokeach, M. (1960). The Open and Closed Mind. New York: Basic Books.
-
Kruglanski, A. W. (2004). The Psychology of Closed Mindedness. New York: Psychology Press.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...