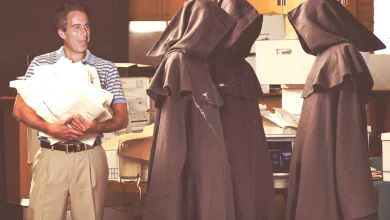اعداد: مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
في كل موسم انتخابي، يتضح بجلاء أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر أو منصة للبث، بل صار قوة مؤثرة تشكل وعي الناخبين وتؤثر في قراراتهم، ومع هذا التأثير الكبير، تأتي المسؤولية الأخلاقية والنزاهة المهنية كأحد أهم محددات ديمقراطية العملية الانتخابية وصدقها.
في العراق والعالم العربي، حيث يتشابك الإعلام بالسياسة وتتصارع المصالح الحزبية والمالية، يصبح السؤال الأساسي:
هل يستطيع الإعلام أن يحافظ على حياده ومصداقيته، أم أنه سيتحوّل إلى أداة للتجييش والتحريض والتسطيح؟
نستهدف في هذه المدونة استكشاف المسؤولية الأخلاقية والنزاهة المهنية للإعلام قبل الانتخابات، من خلال تحليل الوظائف والوظائف الإضافية للإعلام، واستعراض المرجعيات العلمية والفكرية والدينية التي تؤطر هذا الدور.
وظيفة الإعلام “من أجندة تقليدية إلى فوضى رقمية”
إن الدور الأساس للإعلام، كما حدده منظرو الاتصال، يتجاوز كونه ناقلاً للخبر ليصبح قوة فاعلة في بناء الواقع الاجتماعي والسياسي، والإعلام هو المؤثر الأكبر في تحديد أجندة النقاش العام (Agenda Setting)، حيث يقرر، بحكم سلطته، ما يجب على الجمهور أن يُفكر فيه، حسب تأكيدات دنيس ماكويْل (McQuail, 2010). هذا الدور يكتسب أهمية قصوى في الانتخابات، حيث يصبح الإعلام هو الجسر الذي يُوصل البرامج والوجوه إلى الناخبين، مُشكّلاً بذلك الأساس لـ التثقيف الواعي.
لكن المشهد الحالي معقد بفعل الثورة الرقمية، فقد أدت المنصات الاجتماعية إلى تفتيت السلطة الإعلامية، مانحةً الجميع القدرة على الإنتاج، وهو ما يبدو ديمقراطياً ظاهرياً، لكنه يحمل في طياته تحديات عميقة، تتفاقم نظرية “دوامة الصمت “للباحثة نُويل-نيومان (Noelle-Neumann, 1974) في البيئة الرقمية، حيث يمكن للتصويتات والترندات المُوجّهة أن تخلق انطباعاً زائفاً عن الرأي العام، دافعةً بالآراء المخالفة نحو الانزواء والخوف من العزل الافتراضي.
أضف إلى ذلك عمل خوارزميات الفقاعة (Filter Bubbles) التي تُغذي المستخدم بمحتوى يُوافق رأيه مسبقاً، مما يعزز الاستقطاب السياسي ويُشظّي الفضاء العام الذي نادى به يورغن هابرماس (Habermas, 1989)، جاعلاً الحوار بين الأطراف المتنافسة مهمة شبه مستحيلة.
النزاهة المهنية “أمانة الصدق في زمن الأخبار الزائفة”
تُمثل المسؤولية الأخلاقية والنزاهة المهنية جوهر العقد الاجتماعي بين الإعلام والمواطن، وهي ليست مجرد التزام بالقانون، بل هي ضمير المهنة والقيمة الإنسانية التي يجب أن تُحكم التغطية الانتخابية.
وهناك مجموعة أركان للحماية ضد التلاعب، منها:
-
الصدق والشفافية التامة: إن التزام الصحفي بتقديم المعلومة كما هي دون بتر أو تحوير هو الأساس، ويتطلب هذا الدور، كما وصفه لورنس داي (Day, 2006)، أن يعمل الصحفي كـ حارس للحقائق. هذا الدور يتعرض لأخطر تحدٍ اليوم مع انتشار التزييف العميق (Deepfakes) والأخبار الزائفة (Fake News) التي لا تسعى فقط لتضليل الناخب، بل لـ تفكيك ثقته بشرعية العملية الديمقراطية برمتها، والنزاهة هنا تعني أن يكون الإعلام مدقق حقائق بامتياز، لا مجرد ناقل.
-
الحياد والإنصاف المتوازن: لا يُقصد به الحياد المطلق تجاه قضايا الوطن، بل الإنصاف في تغطية جميع الأطراف والمرشحين، يتطلب ذلك ضمان تكافؤ الفرص في وقت البث والمساحات الإعلانية، ورفض التحيّز ليس فقط في المحتوى، بل أيضاً في الإغفال المُتعمَّد لبعض المرشحين.
-
المساءلة والشفافية: يرى كلود جان برتران (Bertrand, 2000) أن المساءلة الأخلاقية هي صمام الأمان، يجب أن تمتلك المؤسسات آليات قوية لتقويم أدائها، بما في ذلك التزامها بـ مدونات السلوك المهني والاعتراف العلني بالأخطاء وتصحيحها فوراً، لتعزيز ثقة الجمهور، لاسيما في ظل بيئة سياسية مُشبّعة بالضغوط.
الإعلام بين التثقيف العميق والتسطيح المُهلك
يُحدد الإعلام طبيعة الانتخابات، هل هي منافسة عقول وأفكار أم استعراض شخصيات وعواطف؟
-
الإعلام التثقيفي (الجاد): هو الذي يشرح بمسؤولية البرامج الانتخابية المُعقدة، ويفتح حواراً عقلانياً، ويمنح الناخب الأدوات التحليلية اللازمة لاتخاذ قرار واعٍ ومبني على القناعة، وهذا الإعلام يركز على الجوهر والمعنى.
-
الإعلام الترفيهي (المسطح): يعتمد على الإثارة والدراما والصور الجذابة، مُتجاهلاً عمق القضايا لصالح الشخصنة والفضائح (Scandals) يحذر بوستمان (1985) من أن هذا النمط قد يُحوّل السياسة إلى “عرض مسرحي” جذاب، بينما يؤكد هابرماس (1989) أن فقدان العقلانية في الخطاب العام يترك القرار السياسي تحت رحمة العاطفة الشعبوية بدلاً من الجدل الرصين والموضوعي، وإن هذا التسطيح يُعدّ إفراغاً لقيمة الانتخابات.
الإطار القانوني والالتزام بالمرجعيات
يخضع الإعلام الانتخابي العراقي لضوابط قانونية واضحة تشمل قانون هيئة الإعلام والاتصالات وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن التغطية، إلى جانب مدونة السلوك المهني المُلزمة.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في الفجوة بين النص والتطبيق، لاسيما على وسائل الإعلام المُموّلة حزبيًا أو سياسيًا، وهذه الكيانات تستغل الثغرات القانونية لتتجاوز القيم المهنية، مُستخدمةً نفوذها للتأثير المباشر على خيارات الناخبين، ما يُهدد مبدأ المنافسة المتساوية.
هنا يتدخل دور المرجعيات الأخلاقية والإنسانية ليُذكر الإعلام بدوره كـ أمانة عامة، فيتفق الفكر الإسلامي على أن الكلمة هي مسؤولية، وأن “التبيّن” (التحقق) من الخبر واجب شرعي وأخلاقي، مع الفكر الغربي على أن الإعلام يمثل الضمير العام للمجتمع وضرورة للحفاظ على السوق الحرة للأفكار، وهذه المرجعيات تُعزز الرسالة بأن الإعلام ليس أداة بيد النفوذ، بل شريك في بناء الديمقراطية الحقة والوعي العام.
استنتاج عام
إن المشهد الإعلامي الانتخابي اليوم يتسم بـ تآكل الثقة الجماهيرية بفعل التضليل الرقمي والتمويل السياسي، وإن آليات الرقابة التقليدية أصبحت عاجزة عن مواكبة سرعة تدفق الشائعات في الفضاء الرقمي، ما يستدعي تحولاً جذرياً في مفهوم المساءلة وفي أدوات العمل الإعلامي.
توصيات.. نحو إعلام مُحصّن
لتحصين المشهد، يجب اتخاذ خطوات حاسمة:
-
المساءلة الرقمية المُركَّزة: تأسيس وحدة مستقلة لتدقيق الحقائق الرقمية (Digital Fact-Checking Unit) داخل الهيئات الرقابية، مهمتها الرصد الاستباقي وتصحيح المحتوى المُضلل على منصات التواصل الاجتماعي بأسرع وقت، مع إلزام المؤسسات الإعلامية بالإشارة إليها.
-
فرض الشفافية المالية: يجب سن قوانين تُلزم جميع وسائل الإعلام المُرخصة بتغطية الانتخابات بـ الإفصاح العلني والمفصل عن مصادر تمويلها السياسي والحزبي، لتمكين الجمهور من قراءة التحيز خلف كل خبر.
-
الاستثمار في الوعي: إطلاق برامج وطنية شاملة لـ محو الأمية الإعلامية (Media Literacy) بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، لتعليم الناخبين الأدوات التحليلية اللازمة للتمييز بين الخبر الموثوق والمحتوى المُوجّه، وتفكيك خطابات الشعبوية.
هذا المزيج من التزام المؤسسات الأخلاقي، والرقابة القانونية الفاعلة، والوعي المجتمعي، هو السبيل الوحيد لضمان أن يكون الإعلام أداة لتحرير خيار الناخب، لا لتوجيهه أو تقييده.
المصادر
-
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. (2021). مدونة السلوك المهني للإعلام الانتخابي. بغداد.
-
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. (2023). التعليمات العامة للإعلام الانتخابي. بغداد.
-
Bertrand, C. J. (2000). Media Ethics and Accountability Systems. UNESCO.
-
Day, L. A. (2006). Ethics in Media Communications: Cases and Controversies. Wadsworth.
-
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
-
Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). The Elements of Journalism. Three Rivers Press.
-
McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory. Sage Publications.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...