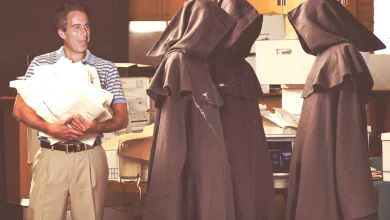اعداد: مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
تُعدّ حرية الاختيار من أعظم القيم التي منحت للإنسان، فهي المعيار الذي يُقاس به مدى إنسانيته، وعمق وعيه بذاته وبمسؤوليته في هذا العالم، إنّها ليست مجرّد قدرة على الفعل أو الامتناع عنه، بل هي قدرة على اتخاذ القرار وفقًا للقيم والعقل والإدراك، ولأنّ هذا المفهوم يلامس جوهر الإنسان، فقد كان محورًا لجدل واسع في الفلسفة والدين وكثير من العلوم كعلم النفس والاجتماع والسياسة والقانون.
أولاً: حرية الاختيار في الفكر الفلسفي
ظلّ مفهوم حرية الاختيار من أعقد القضايا التي شغلت الفلسفة منذ نشأتها، إذ ارتبط بمسائل المسؤولية، والعقل، والإرادة، وعلاقة الإنسان بالقدر والعلّة الأولى، ففي الفلسفة اليونانية، رأى أرسطو أن الإنسان مسؤول عن أفعاله الإرادية، لأن الفعل الأخلاقي لا يكون إلا باختيارٍ حرٍّ نابع من الوعي والإرادة، ثم جاء كانط ليُعيد تعريف الحرية بأنها خضوع الإرادة لقانون أخلاقي يضعه العقل بذاته، لا انقيادًا للميول والرغبات.
وفي الفلسفة الوجودية الحديثة، اعتبر سارتر أن الإنسان محكوم عليه بالحرية، إذ لا يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته حتى حين يختار الامتناع عن الفعل .
أما في الفلسفة الإسلامية، فقد تطور مفهوم الحرية ضمن جدلية الجبر والاختيار، حيث سعى الفلاسفة والمتكلمون إلى تحقيق التوازن بين القدرة الإلهية المطلقة ومسؤولية الإنسان عن أفعاله، فالمعتزلة أكدوا على حرية الإنسان، بينما رأى الأشاعرة أن الله خالق الأفعال والإنسان كاسب لها، غير أن الفلاسفة اللاحقين تجاوزوا هذا الجدل نحو فهمٍ أعمق لطبيعة الإرادة الإنسانية وصلتها بالوجود نفسه.
إن الملا صدرا الشيرازي (صدر الدين محمد الشيرازي 1571–1640م) يُعدّ من أبرز فلاسفة الإسلام الذين أعادوا بناء العلاقة بين الإرادة الإنسانية والوجود في إطار نظريته الشهيرة “الحركة الجوهرية” و”تشكيك الوجود”، فيرى أن الحرية ليست نقيضًا للجبر، بل هي تجلٍ من تجليات كمال الوجود الإنساني، فكلما ازداد الإنسان كمالًا في وجوده، ازدادت قدرته على الفعل الواعي، فيقول: إن الإرادة فرع من فروع الوجود، فكلما كان الوجود أشدّ تحققًا، كانت الإرادة أتمّ وأكمل، ومن ضعف وجوده ضعف اختياره، وبهذا المعنى، تتحول الحرية عنده إلى مقام وجودي لا مجرد قدرة سلوكية، إذ تتحقق بقدر ما يترقى الإنسان في مدارج الوعي والمعرفة، ويصبح فعله صادرًا عن ذاته العاقلة لا عن مؤثرات خارجية.
والإمام روح الله الموسوي الخميني (1902–1989م) قدّم، في فلسفته العرفانية والسياسية، فهمًا مركبًا للحرية يجمع بين التحرر الروحي والسياسي، فهو يفرّق بين الحرية الظاهرية والباطنية، وأن الحرية الحقيقية هي تحرر الإنسان من عبودية الهوى والنفس، لا مجرد الانعتاق من السلطة الخارجية، إذ يقول: الحرية ليست أن يفعل الإنسان ما يشاء، بل أن يتحرر من أنانيته، لأن العبودية لله وحده هي عين الحرية، وفي بعده السياسي، يرى أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية الشرعية والاجتماعية، فالإرادة الحرة ينبغي أن تُمارَس ضمن حدود العدل الإلهي والمصلحة العامة، وهكذا تتخذ الحرية عنده بُعدًا أخلاقيًا وروحيًا، يجعلها وسيلة للتهذيب لا للانفلات.
أما السيد محمد باقر الصدر (1935–1980م) فقد قدّم قراءة فلسفية ومنطقية دقيقة لمفهوم الإرادة والاختيار في ضوء نظرية السنن التاريخية والاستقلال الإرادي للإنسان، ففي كتابه الأسس المنطقية للاستقراء والإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، يؤكد أن الإنسان يمتلك حرية مسؤولة تعمل داخل إطار السنن الإلهية التي تحكم الكون والمجتمع، ويشير الى ان “الإنسان حرّ، لكن حريته تعمل ضمن إطار القوانين التي وضعها الله في الطبيعة والمجتمع، وهذه القوانين لا تُلغِي إرادته، بل تنظمها وتوجّهها نحو الكمال”.
ويضيف إن الإسلام لا يلغي حرية الإنسان، بل يضبطها بالقيم، لأن الحرية بلا وعي تتحول إلى فوضى، بينما الحرية الواعية هي أساس التكليف والاستخلاف، وهكذا يُقدّم الصدر رؤية وسطية بين الحتمية التاريخية والجبر الميتافيزيقي، تُبرز الإنسان ككائن مسؤول يشارك في صناعة مصيره ضمن سنن الخلق الإلهية.
يتبيّن من هذا التطور أن مفهوم حرية الاختيار في الفلسفة الإسلامية مرّ من الجدل الكلامي حول الجبر والاختيار إلى رؤية وجودية- عرفانية- قانونية تؤكد أن الحرية ليست نفيًا للقدر، بل تحقق للإنسانية في إطار النظام الإلهي، فالملا صدرا جعل الحرية ترقّيًا وجوديًا، والخميني جعلها تحررًا روحيًا، والصدر جعلها ممارسة عقلانية مسؤولة في ضوء السنن الإلهية.
وعند المراجعة المعمقة للأفكار المقدمة من السيد الشهيد محمد محمدصادق الصدر في جملة كبيرة من بحوثه ومؤلفاته، تظهر لنا مجموعة من المؤشرات بهذا السياق، منها:
-
الاعتراف بالحرية كعنصر أساسي للكرامة والحقوق الإنسانية، فالسيد الصدر يربط بين وجود الحرية ووجود الحقوق والكرامة، وإن فقدان الحرية يعني فقدان الإرادة والحقوق، وهو ما يهدد وجود الإنسان باعتباره كيانًا إنسانيًا.
-
لا حرية مطلقة- الحرية مشروطة بالأخلاق والشريعة والعقل، وموقفه متوافق مع قراءة إسلامية ترى أن الحرية مطلوبَة، لكن ليست بلا حدود، فيجب أن تُمارَس في إطار يحمي حقوق الآخرين ويحقق الخير العام، وأن تَخضع لضوابط شرعية وعقلية.
-
ربط الحرية بالمسؤولية الأخلاقية والجزاء، فهو يؤكد أن الفعل الصادر عن إرادة يخضع للمحاسبة، فالاختيار يقترن بمسؤولية أخلاقية ودينية، والطاعة الحقة يجب أن تكون اختيارية لتترتّب عليها جزاءات وثواب.
-
الموقف من الجبر/التفويض- اتجاه وسطي متأمّل ونقد للجبر الخالص، في كتاباته الفلسفية والمنهجية يناقش مسائل الجبر والتفويض ويقاربها بعين ناقدة، لا يقبل الجبر المطلق الذي ينفي الاختيار، لكنه أيضاً يقدّر أبعاد توحيدية في فهم حركة الكون، أي موقف فلسفي معقّد يميل إلى حلّ وسط لا إلى تطرف.
-
حرية التحرّر من عبودية الشهوات والقيود الاجتماعية كشرط لحرية (حقيقية)
يميّز بين حريات (ناقصة( في الإطار المادي وحرية تامة تتحقّق ضمن الإيمان والتوحيد الذي يعطي الحرية مضمونها الحقيقي على الصعيدين الشخصي والاجتماعي.
وبذلك، يتكامل المنظور الإسلامي مع الفلسفات الغربية في اعتبار الحرية جوهرًا للإنسانية وشرطًا للمسؤولية الأخلاقية، لكنه يختلف عنها في أنه يرى الحرية وسيلةً للتكامل الوجودي والروحي لا مجرد حقٍّ فردي أو تجربة ذاتية.
ثانياً: البعد النفسي – الحرية بين الذات والدافع
في المنظور النفسي، تُعدّ حرية الاختيار من المفاهيم الجوهرية التي ترتبط بالإرادة والدافعية والتحكم الذاتي، فالحرية هنا ليست تحررًا من المؤثرات الخارجية فحسب، بل هي قدرة داخلية على تنظيم الدوافع والانفعالات وتوجيه السلوك نحو أهداف يختارها الفرد بوعي ومسؤولية.
تُشير نظريات الذات (Self-Theories) إلى أن شعور الإنسان بالاستقلال الذاتي (Autonomy) يمثل أحد الحاجات النفسية الأساسية، ويُعدّ مصدرًا مباشرًا للدافعية الداخلية والرضا النفسي، فكلما شعر الفرد أن أفعاله تنبع من قراره الذاتي، ارتفع مستوى التزامه وازداد إحساسه بالكفاءة والانتماء، وعلى العكس، فإن السلوك المفروض أو المشروط خارجيًا يولّد الإحباط والاغتراب.
وفي علم النفس الإنساني، رأى كارل روجرز أن الحرية شرط أساس لتحقيق الذات (Self-Actualization) فالإنسان لا يبلغ الاتزان النفسي إلا عندما تكون أفعاله منسجمة مع قيمه الداخلية لا مع ضغوط المجتمع أو توقعاته، ويقول روجرز (1961) إن الحرية الحقيقية تنبع من إدراك الذات لذاتها، لا من غياب القيود الخارجية، وهكذا تصبح الحرية عنده مؤشرًا على النضج النفسي والانسجام الداخلي.
بينما عدّ ألبرت باندورا في نظريته التفاعلية (1986) أن الإنسان ليس مجرد مفعول به في بيئته، بل فاعل واعٍ يملك ما أسماه الكفاءة الذاتية (Self-Efficacy) التي تمكّنه من توجيه سلوكه وضبط دوافعه رغم الضغوط.
أما من منظور التحليل النفسي، فقد ربط فرويد الحرية بالقدرة على وعي الدوافع اللاشعورية وتحرير الأنا من سطوتها، فالحرية، في ضوء التحليل النفسي، ليست حالة مطلقة بل رحلة وعي داخلي تتيح للفرد أن يعرف أسباب سلوكه ويعيد توجيهها بوعي.

ثالثاً: البعد الاجتماعي – الحرية في ظل المجتمع
إن الحرية في منظور علم الاجتماع ليست حالة فردية خالصة، بل هي نتاج علاقة جدلية بين الفرد وبنية المجتمع، فالفرد لا يعيش في عزلة، وإنما يتشكل وعيه وخياراته ضمن منظومة من القيم والمعايير والعلاقات التي تحدد حدود الممكن والممنوع، والمشروع والمحظور.
يرى إميل دوركايم أن الحرية الحقيقية لا تعني الانفلات من الضوابط، بل هي ثمرة تنظيم اجتماعي متوازن يضمن للفرد إمكانية الاختيار دون أن يُهدد التماسك الجماعي، فالضوابط الاجتماعية، بحسبه، لا تُقيد الحرية بل تُهذّبها، لأنها تخلق إطارًا من المعنى والغاية يجعل الأفعال الإنسانية منسجمة مع النظام الأخلاقي العام .
أما ماكس فيبر، فقد قدّم تحليلاً أكثر تركيبًا للحرية حين ربطها بالبنية الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع، مشيرًا إلى أن ما يُسمّى “حرية الاختيار” يتحدد في الواقع ضمن شبكة من القيود البنيوية، كالتقسيم الطبقي والبيروقراطية والعقلانية الأداتية التي تُقنّن السلوك الإنساني وتضبطه، ومن ثم فإن الحرية النظرية–أي الحق في الاختيار– قد لا تعني بالضرورة حرية فعلية حين تكون الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية محدودة.
وفي إطار أكثر حداثة، يرى بعض العلماء أن أفعال الأفراد تُمارس داخل ما يسمى “الحقول الاجتماعية” التي تتوزع فيها القوة والرموز والمعاني، وبالتالي، فإن الحرية ليست نفيًا للهيمنة، بل هي قدرة على المناورة داخل الحقول عبر الوعي بالقيود وتوظيفها لصالح الفعل الإرادي.
ويذهب يورغن هابرماس إلى أن الحرية تتجلى من خلال التواصل العقلاني داخل الفضاء العام، حيث يُصبح الحوار القائم على الاعتراف المتبادل أساسًا لبناء الإرادة الجمعية الحرة، فالتحرر الاجتماعي لا يتحقق بالقوة، بل عبر الفعل التواصلي الذي يتيح للأفراد التعبير عن ذواتهم ضمن نظام عادل من التفاهم والتقدير.
وعليه، فإن الحرية في بعدها الاجتماعي ليست حالة مطلقة أو فردية منعزلة، بل هي ممارسة اجتماعية تتطلب وعيًا بالعلاقات والقوى التي تشكل المجال العام، فكلما ازداد المجتمع عدلاً ومؤسساتُه شفافية، اتسعت دائرة حرية الأفراد فيه، والعكس بالعكس.
رابعاً: البعد السياسي – حرية الاختيار أساس الكرامة المدنية
تُمثل حرية الاختيار جوهر الفعل السياسي وركيزة الكرامة المدنية في الفكر الإنساني الحديث، إذ لا يمكن تصور مواطنة فاعلة دون حرية في اتخاذ القرار والمشاركة في الشأن العام، فالحرية السياسية ليست ترفًا فكريًا، بل هي شرط وجودٍ للمجتمع المدني الذي تُبنى فيه السلطة على الإرادة الشعبية لا على القهر أو الوراثة أو الهيمنة.
يُعدّ جون لوك من أوائل من أسّسوا لمفهوم الحرية بوصفها حقًا طبيعيًا يسبق الدولة، فهي ملازمة لوجود الإنسان ذاته، وقد رأى أن العقد الاجتماعي لا يمنح الناس حريتهم، بل ينظم ممارستها بما يضمن الأمن والمساواة والعدل، أما جان جاك روسو، فيشير الى أن الحرية هي التعبير عن “الإرادة العامة” التي يُشارك فيها الأفراد بوصفهم مواطنين لا رعايا، أي أنهم يشرّعون لأنفسهم القوانين التي يلتزمون بها طوعًا، وهكذا، تُصبح الحرية السياسية مرادفًا للمسؤولية الجماعية لا للفوضى الفردية.
وفي الفكر السياسي المعاصر، يُنظر إلى حرية الاختيار بعدّها مؤشرًا لمدى نضج النظام الديمقراطي، فهي تتجلى في حق التصويت والترشح، وفي حرية التعبير والتنظيم والمساءلة، غير أن هذه الحرية قد تتحول إلى وهمٍ شكلي حين تُختزل الديمقراطية في صناديق اقتراع تُوجَّه نتائجها مسبقًا عبر السيطرة على الإعلام وتضييق فضاء الوعي، فيتحول المواطن من فاعل سياسي إلى مستهلك للخطاب السلطوي.
وقد حذّر ألكسيس دو توكفيل من هذا الشكل من “الاستبداد الناعم” الذي تُمارسه الديمقراطيات حين تُخدّر إرادة الأفراد عبر الإغراق في الاستهلاك واللامبالاة السياسية، لتبقى الحرية قائمة في الشكل لا في الجوهر، وهناك من يربط الحرية بالفعل السياسي ذاته، معتبرًا أن الإنسان لا يكون حرًّا إلا بقدر ما يشارك في الحياة العامة ويُعبّر عن ذاته في فضاء الحوار والمساءلة.
في المقابل، تؤدي الأنظمة السلطوية إلى تفريغ الإنسان من جوهره الأخلاقي والسياسي، إذ يقمع القهرُ الإرادة الفردية ويحوّل المواطنين إلى أدوات خاضعة لا فاعلة، مما يُنتج خمولاً اجتماعيًا ويُعطل طاقة الإبداع والمسؤولية، وحين تُغلق قنوات المشاركة وتُحتكر المعلومة، يُغتال معنى الحرية من الداخل، وتُختزل الكرامة إلى طاعة.
إنّ حرية الاختيار، في نهاية المطاف، ليست مجرد حقٍّ سياسي، بل قيمة تأسيسية للكرامة الإنسانية، فهي التي تمنح الإنسان القدرة على الفعل الواعي والمساءلة، وتُحوّل المجتمع من رعايا إلى مواطنين، وكل نظام يُصادر هذه الحرية، إنما يصادر جوهر الإنسان ذاته.
خامساً: البعد القانوني – الإرادة الحرة والمسؤولية
يُعدّ مبدأ الإرادة الحرة أحد الأعمدة التي يقوم عليها البناء القانوني والأخلاقي في المجتمعات الإنسانية، فالحرية في المنظور القانوني ليست مجرد حقٍّ ميتافيزيقي، بل هي شرط جوهري للمساءلة والعقاب، فالمسؤولية الجنائية والمدنية تُبنى على أساس أن الإنسان كائن واعٍ يمتلك القدرة على الاختيار بين الفعل والامتناع عنه، وأنه يدرك النتائج المترتبة على قراراته، لذلك، فإن القانون لا يُحاسب على الأفعال التي تُرتكب تحت الإكراه المادي أو المعنوي، أو في حالات الاضطراب العقلي التي تُعطل الإدراك والإرادة.
لقد استقرّ في الفقه الجنائي مبدأ أساسي مفاده “لا جريمة بلا نية” وهو ترجمة قانونية لفكرة فلسفية عميقة مؤداها أن المسؤولية تفترض حرية القرار، فالفعل الإجرامي لا يُعتدّ به قانونًا ما لم يكن مسبوقًا بعنصر نفسيّ يتمثل في القصد أو العلم أو الإهمال، بذلك، تتلاقى فلسفة القانون مع فلسفة الأخلاق عند كل من إيمانويل كانط وأرسطو اللذين ربطا الحرية بالمسؤولية الأخلاقية، معتبرين أن الإنسان لا يكون فاعلاً أخلاقيًا إلا حين يختار فعله بإرادة واعية لا بدافع الخوف أو الإكراه.
وقد أثار التطور العلمي، لا سيما في مجال علم الأعصاب الإدراكي (Neuroscience)، نقاشًا واسعًا حول طبيعة الإرادة ومسؤولية الإنسان عن أفعاله، فقد أظهرت تجارب مثل تجارب بنيامين ليبت (Libet, 1983) أن النشاط الدماغي يسبق الوعي بالقرار الجزئي، مما دفع بعض العلماء إلى التساؤل:
هل الإرادة الحرة وهمٌ عصبي؟
إلا أن أغلب الفقهاء القانونيين، ومنهم ستيفن مورس (Morse, 2010)، يرون أن النظام القانوني لا يمكن أن يستقيم من دون افتراض الإرادة الحرة، لأن العدالة ذاتها تفترض أن الإنسان قادر على توجيه سلوكه وتحمل تبعاته.
وفي الفقه الإسلامي، تُمثل الإرادة الحرة أساس التكليف والمسؤولية الشرعية، فالمبدأ القائل بـ “رفع القلم عن المجنون والمكره والنائم” يؤكد أن المساءلة لا تكون إلا عن فعل اختياري يصدر عن عقلٍ مدرك وإرادة حرة.
وهكذا يتضح أن الحرية ليست قيمة مثالية فحسب، بل شرطًا بنيويًا لعدالة النظام القانوني، إذ من دونها تنتفي المسؤولية، ويستحيل الحكم الأخلاقي أو القضائي على الفعل، فالحرية القانونية هي التعبير العملي عن كرامة الإنسان ككائن عاقل، واعٍ، ومكلّف.
ومن منظور تكاملي، فإن حرية الاختيار تمثل نقطة التقاءٍ بين ميادين الفلسفة والدين وعلم النفس والاجتماع والسياسة والقانون:
-
فهي في الفلسفة شرط الأخلاق والعقلانية.
-
وفي الدين جوهر التكليف والمسؤولية أمام الله.
-
وفي علم النفس أساس النمو الذاتي والاتزان الانفعالي.
-
وفي الاجتماع والسياسة ركيزة العدالة والمواطنة.
-
وفي القانون معيار للمساءلة وميزان للعدالة.
إن الحرية الحقيقية ليست أن نفعل ما نشاء، بل أن نعرف لماذا نفعل، وأن نتحمّل تبعات ما اخترناه بوعي ومسؤولية، ومن هنا تظلّ حرية الاختيار ميزان الوعي الإنساني بين الغريزة والعقل، وبين الإكراه والضمير، وبين الفعل والواجب.
سادساً: حرية الاختيار والانتخابات البرلمانية العراقية – بين الوعي والمسؤولية
تتجلى حرية الاختيار في أعلى صورها حين يقف الإنسان أمام صندوق الاقتراع، ليقرر بإرادته من يمثّله ويصوغ مصير وطنه، فهذه اللحظة ليست حدثًا سياسيًا فحسب، بل هي تعبير وجودي وأخلاقي عن كرامة الإنسان ووعيه ومسؤوليته، إذ تُختبر فيها كل الأبعاد التي تناولها الفكر الفلسفي والنفسي والاجتماعي والسياسي والقانوني للحرية، وتتحول من فكرة نظرية إلى فعلٍ واقعي يترك أثره في التاريخ.
فمن المنظور الفلسفي، لا تتحقق الحرية إلا بقدر ما يكون الإنسان واعيًا بذاته ومتصلاً بعقله الكلي، أي أن الاختيار السياسي لا يصبح حرًّا إلا حين يُمارس عن بصيرة لا عن انفعال، فكلما ازداد الوعي الوجودي للمواطن، ازدادت قدرته على اختيارٍ نابعٍ من جوهره لا من ضغط الجماعة أو إغراء المصلحة.
أما في البعد الأخلاقي، فإن الحرية الحقيقية هي التحرر من عبودية الهوى والنفس، ونجد صداها في السلوك الانتخابي المعاصر، فالمواطن الحر هو الذي يتحرر من ضغوط العصبية والطائفية والمصلحة الضيقة، ويجعل اختياره استجابة لنداء الضمير لا لمغريات اللحظة أو دعاية السلطة، فالتصويت الواعي ليس مجرد فعل سياسي، بل مجاهدة روحية لاختيار الأصلح لا الأقرب أو الأقوى.
ومن منظور الوعي الاجتماعي والسياسي، فإن الحرية لا تعني الفوضى، بل هي ممارسة مسؤولة ضمن “سنن التاريخ”، أي ضمن القوانين الاجتماعية التي تُنتج التغيير حين ينهض الإنسان بوعيه، فالمجتمع الذي يصوّت بوعي ينتقل من حالة الانفعال إلى حالة الفعل، ومن الخضوع للقدر السياسي إلى المشاركة في صناعته، ومن هنا، تصبح الانتخابات ميدانًا لتفعيل الحرية الواعية التي تنظّمها القيم وتوجّهها المصلحة الوطنية.
وفي ضوء علم النفس السياسي، يتجلّى أن السلوك الانتخابي يعكس مستوى التحكم الذاتي والاستقلال المعرفي لدى الناخب، فالفرد الذي يُصوّت بناءً على قناعاته المستقلة إنما يعبّر عن ذاته الناضجة، بينما الذي يخضع للتأثيرات الدعائية أو لهيمنة الجماعة إنما يعيش اغترابًا نفسيًا يجعله يُمارس حرية ظاهرية لا حقيقية، فالتحرر الداخلي من الخوف، والقدرة على اتخاذ القرار المستقل، هما شرطا الفعل الديمقراطي الأصيل.
أما من منظور علم الاجتماع السياسي، فإن حرية الاختيار لا تتحقق في مجتمع يفتقر إلى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فالحرية الاجتماعية لا تعني غياب القيود، بل وجود نظام عادل يتيح للفرد ممارسة إرادته دون قهرٍ مادي أو رمزي، وفي السياق العراقي، تتجلى التحديات في اختلالات البنية السياسية والإعلامية والاقتصادية التي قد تُفرغ الاختيار من مضمونه، حين تُوجَّه الإرادة الشعبية عبر شبكات النفوذ أو المال أو الخطاب الطائفي.
أما في البعد القانوني والدستوري، فإن حرية الاختيار هي الأساس الذي تقوم عليه شرعية النظام الديمقراطي، فلا معنى للتمثيل النيابي إن لم ينبثق من إرادة حرّة غير مكرهة، ومن ثم، فإن ضمان نزاهة الانتخابات وشفافية الإعلام وحياد المؤسسات لا يُعدّ إجراءً إجرائيًا فحسب، بل هو تجسيد عملي لمبدأ الإرادة الحرة الذي تقوم عليه العدالة ذاتها، فكما لا مسؤولية دون حرية، لا شرعية دون اختيارٍ حرّ.
إنّ الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة تمثّل اختبارًا حقيقيًا لمدى نضج الوعي الجمعي، إذ يقف المواطن بين خيارين:
-
أن يُمارس حريته كواجبٍ أخلاقي يعبّر عن وعيه وكرامته.
-
أو أن يتركها تُختطف تحت شعارات العاطفة والمصلحة الضيقة.
فحرية الاختيار هنا ليست مسألة سياسية فحسب، بل قضية مصيرية تتعلق بوجود الإنسان العراقي ذاته: هل يبقى أسيرًا للماضي ومحدداته، أم يتحرر ليشارك بوعي في صياغة مستقبلٍ يليق بكرامته وتاريخه؟
لقد أثبتت التجارب أن الشعوب لا تُبنى بالقيود بل بالوعي، وأنّ الحرية الواعية هي القاعدة التي تُقيم عليها الأمم نهضتها، ومن ثمّ، فإنّ اختيار الأصلح في الانتخابات ليس شعارًا أخلاقيًا، بل فعلٌ حضاريّ يختبر مدى صدق المجتمع في تحويل القيم إلى سلوك، والإيمان إلى ممارسة، والمعرفة إلى قرار.
إنّ حرية الاختيار هي في جوهرها الميزان الذي يحدّد مصير الأوطان، فهي التي ترفع الأمم حين تُمارَس بوعي، وتُسقطها حين تُفرّغ من معناها، ولذلك، فإنّ الانتخابات ليست نهاية الحرية، بل بدايتها، لأنّها اللحظة التي يُعيد فيها الإنسان اكتشاف ذاته ككائنٍ مسؤول، يختار لا لمجرد أن يُسجّل موقفًا، بل ليُغيّر واقعًا.
المصادر
-
الصدر،محمد باقر. (1980). الأسس المنطقية للاستقراء والإنسان المعاصر. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.
-
الصدر، محمد محمد صادق. (1999). نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان. قم: مؤسسة الصدر الدينية.
-
——. (1998). ما وراء الفقه (الجزء الأول والثاني). النجف الأشرف: دار المؤرخ العربي.
-
——-. (1998). فقه الأخلاق. النجف الأشرف: دار المؤرخ العربي.
-
الخميني، روح الله. (1980). الأربعون حديثًا. قم: دار الإرشاد الإسلامي.
-
(الشرق الأوسط). (2020). حرية الاختيار وجودة الحياة. جريدة (الشرق الأوسط). https://aawsat.com/home/article/2824361
-
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory: The ‘what’ and ‘why’ of human motivation. Psychological Inquiry.
-
-
Morse, S. J. (2010). Criminal law and neuroscience: Mapping the future. Washington University Law Review.
-
Libet, B. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity.
 Loading...
Loading...

 Loading...
Loading...