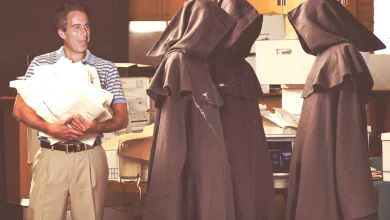بقلم: الباحث باسم محمد ناصر
الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية
تكتب الصورة ما لا تستطيع الكلمات قوله، لكنها لا تستطيع أن تشرح ما تقوله. بهذه العبارة، يلخص المفكر الفرنسي رولان بارت العلاقة المعقدة بين الصورة والكلمة، وهي علاقة تأخذ طابعًا صراعيًا في فضاء الإعلام الرقمي المعاصر، ففي زمنٍ باتت فيه الصورة تنتج الحدث وتعيد تشكيل الواقع، لم تعد الكلمة وحدها قادرة على احتكار المعنى أو قيادة الخطاب، بل أصبحت تواجه تحديًا وجوديًا يتعلق بهويتها ووظيفتها. فإذا كان القرن الثامن عشر هو عصر الأنوار، والقرن التاسع عشر هو رحم التكنولوجيا، فإن القرن العشرين هو عصر الصورة بامتياز، حيث شكَّل هذا المنتج أحد معطيات الحضارة الغربية المعاصرة. فالصورة بانتقالها من مجال (الحس- الحدس) إلى إطار (التعبير- اللغة)، تكون قد حققت تجاوزًا في مجال التعبير والتواصل، وخصوصًا لمفهوم (الكتابة- النص- الرسالة)، بسرعة غير مسبوقة في مجال اختراع الأدوات في إطار التجربة الحضارية للإنسان وفي إطار الفكر العالمي وأدواته. وبذلك فقد أسهمت في نقل البشرية إلى مسارات جديدة مبتكرة في مجال التواصل البشري يمكن أن تؤسس لنمط من المعرفة قائم على مفاهيم جديدة تتماهى مع آلية التسارع التي يفرضها تطور التكنولوجيا المعاصر.
يطرح هذا المقال سؤالًا جوهريًا: هل ما زالت الكلمة قادرة على الصمود أمام هيمنة الصورة؟ أم أن الهوية اللغوية في طريقها إلى الذوبان أو التشظي في ظل العولمة الرقمية؟
هيمنة الصورة في الثقافة العربية
بهذا السياق، تبرز هيمنة الصورة بوصفها معطى حضاريًا في الثقافة العربية الحديثة، ومعطى مُستحدثًا ومُستوردًا في مجمل آلياته الفكرية والتقنية. فالثقافة العربية لم تُسهم في صناعة الصورة في العصر الحديث، بل دخلت في مجالها الاستهلاكي. لذلك لم يُحصِّن العرب مجتمعاتهم بضدٍ نوعيٍ يُسهم في تقنين هذه الهيمنة على حساب الكلمة التي هم رواها. فإذا كان الشعر ديوان العرب في العصور الغابرة، فإن الصورة هي ديوان الغرب منذ عصر النهضة ولا تزال.
مما تقدم، يطرح هذا المقال سؤالًا جوهريًا: هل ما زالت الكلمة قادرة على الصمود أمام هيمنة الصورة؟ أم أن الهوية اللغوية في طريقها إلى الذوبان أو التشظي في ظل العولمة الرقمية؟
يسعى المقال إلى تفكيك هذا الصراع وتحليله نقديًا، من خلال استعراض مظاهر هيمنة الصورة في الإعلام الجديد، وتقييم قدرة اللغة العربية على التكيف مع هذا الواقع، مع طرح رؤى مستقبلية حول سُبل حماية الهوية اللغوية في البيئة الإعلامية المتغيرة. في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لم يعد الإعلام مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح فضاءً للسيميولوجيا تتصارع فيه الرموز البصرية واللغوية على تشكيل الوعي والهوية. يطرح المقال “سلطة الصورة ومرونة الكلمة” قضية جوهرية تتعلق بالتأثير والهيمنة التي تفرضها الوسائط الرقمية على اللغة العربية، ويكشف عن صراع خفي بين الصورة التي تفرض هيمنتها، والكلمة التي تحاول الحفاظ على أصالتها وهويتها.
الصورة بوصفها أداة اتصال
قبل أن يمتلك الإنسان اللغة، عبّر عن أغراضه وحاجاته وكينونته بالرسوم والخطاطات التي حفرها على جدران الكهوف والمغارات التي كانت تأويه قبل آلاف السنين التي نعرفها، وآلاف أخرى لا نعرفها. إذ عبّر من خلالها عن أحاسيسه وخلجاته وما اصطنع في ذهنه ودواخله من أفكار ومشاعر. وبمرور الزمن وبمختلف العصور، تطور التعبير بالرسم كما تطور التعبير باللغة، فصار كل منهما قرينًا للإنسان الذي عمل دائمًا على تجديد وعيه بهما، وتوظيفهما للاتصال والتواصل النافعين. ومن خلال اللغة اتصل الإنسان بغيره وحاور نفسه وأفرغ ما في دواخله أو ذهنه تخيلًا وتصويرًا وإيقاعًا. وبالرسم والصورة كشف عما أحسه من جمال، وهو يتأمل كونه وأشياءه. وبين الشعر والرسم محطات التقاء لعل أبرزها وأرسخها أن كلا منهما منبع من منابع الحلم الإنساني المستند إلى أرضيات معرفية وفكرية وتقنية مجدِّدة تمنح النص اللغوي أو اللوحة الفنية القيمة الجمالية وفعلها الاتصالي المأمول. وبالكلمات ينطلق الإنسان المبدع في رحلة لغوية متناغمة وموحية وقادرة على رسم صور فنية نابضة بالحياة والحركة. وبالخطوط والألوان يرسم الفنان لوحات لصور الأشياء وهي تلوح أمام ناظريه وتتحرك أو يتخيلها هكذا مبرزًا ما فيها من مظاهر الجمال أو القبح، والخير أو الشر، والمحبة أو الكراهية، والعدل أو الظلم. وقد لا يخفى على الكثير ما توظفه الوسائل الرقمية في مواقعها من عالم السيميولوجيا والعلامات لاستهدافات ثقافية واجتماعية واقتصادية. ولعل أخطر النتائج المترتبة على هذا التوظيف، تلك المتصلة بمخاطر الاقتلاع الثقافي والخوف من فقدان الهوية لدى العديد من الشعوب والأمم، وما يحدث نتيجة ذلك من تأثيرات سلبية اجتماعية وأخلاقية لهذا التوظيف على المجتمع العربي والمسلم، فلا تخطئه عين الناظر ولا بصيرة الباحث.
فما يحدث اليوم من الصور والإشارات والنصوص المرئية على الشاشات الإلكترونية دائمة البث، بات يشكل تهديدًا لمنظومات القيم والرموز وتغييرًا في المرجعيات الوجودية وأنماط الحياة. فأصبحت الكثير من ثقافات الشعوب عارية أمام تدفق الرسائل والعلامات التي تحمل معها أبطالًا ورموزًا جديدة تمتلئ بها مخيلة المشاهد بدءًا بعارضات الأزياء والصور النمطية المفبركة، ووصولًا إلى رموز الفن والسينما والأطعمة وأنماط السلوك وموضات الملابس، أو موضوعات التفاهة والابتذال والمحتوى الهابط.
قدم لنا علم اللسانيات، كما لا يُحصى من الوسائل والأدوات للتفكير ولتحليل المفاهيم وإعادة صياغة الأشياء صياغة جديدة. وفي عالمنا الحاضر، عالمنا الرقمي وما بعده، عالم الفضائيات الصاخبة، عالم صناع المحتوى، عالم الافتراض الذي يحكم ويهيمن على الواقع، عالم الفبركة وعالم الذكاء الاصطناعي، وعالم الهندسة الوراثية التي تحاول أن تستنسخ نوعًا جديدًا من البشر أو عقلًا آخر للإنسان مثلما استطاعت أن تستنسخ الحيوان، وعالم الشركات الكبرى ورؤوس الأموال التي توظف للإعلان والإشهار والدعاية، والتي بلغت مليارات الدولارات، بما في ذلك محطات البث التلفازي الفضائية التي تبث إعلاناتها ودعاياتها على مستوى العالم، وعلى مدار الساعة. وفي هذا العالم لم يعد هناك شيء جوهري، فكل شيء بات استعراضيًا، أو هكذا يُراد له أن يكون بعيدًا عن الروح والعقل والوعي، حتى الشعر والمسرح والغناء. ولم تعد مقولة أن اللغة أداة للتعبير عن الفكر مقبولة أو فاعلة في عالم بلا حدود ثقافية، أُغفلت فيه الجغرافيا، ثم تحرَّك التاريخ داخلها فصار كل شيء موجودًا في كل شيء(1). فتنتقل عبر وسائل الإعلام الأفكار والمعلومات والأخبار والاتجاهات والسلوكيات. هكذا أضحى الإعلام اليوم يمتلك كل شيء، ومالكو الإعلام والمسيطرون عليه والمخططون له هم مالكو المال والنفوذ، فيوجهون اللغة والصورة على وَفق ما يريدون تمامًا مثلما يوجهون السلع التجارية، ويتفننون في ابتكار وسائل وأدوات وطرق متعددة للاتصال، والإعلان والإشهار والدعاية من أجل مناورة عقل الإنسان ومشاعره في محاولة لسحب البساطة من تحته(2). إذ عمدوا إلى توظيف الحوادث اليومية العابرة إلى حوادث رأي عام من خلال محاكاة العقل الجمعي الذي يتأثر بالصورة الناطقة. وليس ببعيد ما يجري في واقع حوادث الشعوب ومنها المجتمع العراقي وما يجري فيه من صناعة رأي عام من جزئية بسيطة ربما تحصل العشرات أو المئات منها دون أن تُسلّط عليها الأضواء. فعندما يتم صناعة وإنتاج الصورة بسيميولوجيا معينة وباختيار كلمات مخصصة تحاكي محتوى الصورة لتُوجَّه نحو فئة مستهدفة لتحاكي أذواقهم وأهواءهم بقضية ما، هذا ما يجعل للصورة هيمنة وحاكمية قبال الكلمة التي تراجع دورها في عالمنا المعاصر.
مرونة الكلمة: بين التكيف والانحدار
اللغة العربية بما تحمله من عمق تاريخي وتركيبي، تواجه تحديات في الإعلام الرقمي. فالعامية واللغة الهجينة تهيمن على المحتوى، مما يؤدي إلى تآكل الفصحى في الخطاب العام. وما يصنعه الاقتراض اللغوي من الإنجليزية أحيانًا يخلق فجوة بين الأجيال ويضعف الهوية اللغوية. ومع ذلك، تُظهر الكلمة مرونة في التكيف، خاصة في مجالات التعليم الرقمي والمحتوى الثقافي، مما يدل على قدرتها على التجدد إذا ما أُحسن استخدامها. فمرونة الكلمة في اللغة تعكس قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتطورها المستمر، وغالبًا ما تُظهر التكيف كاستجابة طبيعية لاستيعاب المستجدات. أما الانحدار فهو عملية معاكسة ترتبط بالانتقاص من قدرات اللغة أو اضمحلالها، وهذا ما يميز المرونة اللغوية في اللغة العربية التي تتمتع بخصائص تُمكِّنها من التفاعل مع البيئة التكنولوجية وغيرها من التحديات.
التكييف (Adaptation) هو استجابة اللغة للتغيرات المحيطة بها، حيث تكتسب كلمات جديدة أو تعدِّل معاني الكلمات القديمة لتلبية الاحتياجات المستجدة في مجال التكنولوجيا أو العمل. أما المرونة (Resilience) فهي القدرة على التعامل مع الأحداث السلبية، بل وتجاوزها نحو النمو والتطور في سياق اللغة. قد تشمل المرونة اللغوية القدرة على تجاوز التحديات مثل تحدي التكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية الأصيلة للغة.
الانحدار اللغوي يشير إلى حالة ضعف أو تراجع في قدرات اللغة، وهو ما يناقض المرونة. وقد ينتج عن الانحدار فقدان الدقة اللغوية، وتضاؤل القدرة على استخدام المفردات بشكل فعّال، أو التأثر بالظواهر الثقافية والاجتماعية السلبية التي تؤثر على بنية اللغة. إذ تتمتع اللغة العربية بمرونة عالية في قدرتها على توليد كلمات جديدة من جذر واحد، مما يمكنها من استيعاب مفاهيم جديدة دون الحاجة إلى استعارة كبيرة من لغات أخرى.
حينما نتكلم عن إمكانية استعمال اللغة العربية بمرونتها في المجال الإعلامي، نطرح تساؤلًا منهجيًا يتعلق بمدى إمكانية اللغة العربية على استيعاب التقنيات الحديثة للإعلام، وهل بإمكانها أن تستجيب لمتطلبات المستحدثات الاتصالية في مجال الإعلام؟ وهذا الأمر يرتبط موضوعيًا بما اصطلح عليه بمصطلح (التحرير الإعلامي) الذي يحتاج إلى صياغة تمتاز بالجودة في التأليف واختيار البدائل، وإلى قدرة كبيرة ودراية علمية في موضوع من الموضوعات، التي تتطلب البحث في التراكمات المعرفية على مستوى التراث العربي، الذي يزخر بأمثلة متعددة في هذا الصدد. من ذلك أن المبدعين القدامى كانوا يشترطون في الكتابة السليمة القابلة للنفاذ والاستيعاب، توافر ثلاثة عناصر متصلة ببعضها وهي:
الشرط الأول: يتعلق بدقة اختيار الألفاظ وهو ما يسمى بالقدرة الإبدالية.
الشرط الثاني: فهو الشرط الذي يتعلق بنظم الكلام أي القدرة التأليفية.
الشرط الثالث: فيخص مراعاة الغرض المطلوب من الكلام، وقد اشترط وجوبًا الإشارة إليه، مما يتطابق ومضمون الكلام بمقتضى الحال (8).
وفي الفهم المعاصر فإن الشروط الأساسية للتحرير الإعلامي تختصر في أن الإعلامي عليه أن يختار الألفاظ المناسبة ويربط فيما بينها ليكون التأليف مناسبًا ومطابقًا، مع مقتضيات قواعد اللغة والمقام في صياغة تشكل كُلًّا متكاملًا منسَّق الأجزاء مترابط الوحدات الداخلية، خاليًا من الشذوذ والنشاز. على أن هذه الصياغة المراعية لقواعد اللغة العربية، لا يمكن أن تكون كذلك إلا بالتشبث بقواعد النحو، محافظة على ترتيب الكلمات. واعتمادًا على ذلك، فإن السياق العام للتحرير الإعلامي لا بد أن يُعنى بدراسة وتأليف الكلام، تأليفًا دقيقًا، مرن الصياغة، سهل الاستيعاب بخصوص الرسالة الإعلامية(9). غير أن الاستعمال والتداول اللغوي، في وسائل الإعلام، سجل خروجًا عن المألوف اللغوي، الذي تفرضه قواعد اللغة العربية تحديدًا، وهو ما أدى إلى حالة من التساهل في استعمال اللغة العربية الفصحى، ما نتج عنه اللغة الوسطى أو اللغة الثالثة.
صراع الهوية اللغوية: بين التهميش والمقاومة
الإعلام الرقمي يخلق بيئة خصبة لصراع الهوية اللغوية، فالصورة تهمّش الكلمة وتُعيد تشكيل الخطاب بطريقة بصرية سريعة، والكلمة تقاوم هذا التهميش عبر مبادرات لتعزيز الفصحى، مثل تعريب المصطلحات، وتطوير أدوات لغوية رقمية. هذا الصراع لا يُعد سلبيًا بالضرورة، بل يمكن أن يكون محفزًا لإعادة التفكير في دور اللغة والصورة في تشكيل الوعي العربي الحديث.
الهوية هي كل ما يتميز بالوحدة والثبات والدوام لا يتعدد ولا يتغير ولا يزول في الكائن البشري على المستوى الفردي والاجتماعي وفي غيره من الكائنات على اختلاف أنواعها مادية كانت أو فكرية أو روحية. فالهوية تعبر عن حقيقة الكائن وماهيته، وفي غياب الهوية غياب للحقيقة وغموض الماهية على مستوى الأفكار والأشياء والأشخاص. ومن هنا تقوم أهمية الهوية لدينا وحاجتنا الملحة إلى اكتشافها في الموضوع أي موضوع، مثلما هو الحال في تحديد هويات الأفراد وهويات الشعوب وهويات الطوائف وهويات الأعراق وغيرها.
وترتبط الهوية باللغة ارتباطًا وثيقًا، ارتباط العلة بالمعلول، وعلى سبيل التأثير والتشكيل والتمثيل، فالواحدة منهما تؤثر في الأخرى وتُشكِّلها وتمثلها. فالهوية حالة في اللغة لأن كل لغة لها هويتها الخاصة بها، وتعبير اللغة عن الهوية كما تعبر الهوية عن اللغة. وقد تكون اللغة إحدى المقومات أساسية أو غير أساسية في بناء الهوية، وتنتج اللغة الهوية وتحافظ عليها وتنقلها من جيل إلى آخر ومن وقت إلى آخر، وتقوم الهوية بتنشيط اللغة وتحريكها وتحافظ عليها وتؤمن وجودها من الاندثار. وتتأثر اللغة بالهوية إذ تقوى بقوتها وتضعف بضعفها وتنصهر بانصهارها وتندثر باندثارها. وانطلاقًا من العلاقة الوثيقة بين الظاهرتين الإنسانيتين الهوية واللغة يتحدد مدلول الهوية اللغوية باعتبارها أحد المفاهيم الرئيسية في الفكر المعاصر. ويقول حسن حنفي محددًا العلاقة بين الهوية واللغة في الوطن: الهوية واللغة موضوعان مرتبطان يتفاعلان في السلوك الفردي والاجتماعي داخل الأوطان، يؤثر كل منهما على الآخر، قوةً وضعفًا، إذا قويت الهوية قويت اللغة، وإذا ضعفت الهوية ضعفت اللغة. اللغة تعبير عن الهوية طبقًا للقول المشهور (تحدث حتى أراك)، وكلمة (لوغوس) في المسيحية كما هو الحال في إنجيل يوحنا تعني الكلمة والهوية والوجود في آن واحد (10).
استنادًا إلى مدلول الهوية وإلى مدلول اللغة وبالإضافة والاقتران والتركيب بين المدلولين قام مصطلح الهوية اللغوية المركب من لفظتين: لفظ الهوية ولفظ اللغة. ويعني المصطلح كل ما تتميز به لغة ما من خصائص ورموز وإشارات ودلالات وعلاقات فكرية ومنطقية ونفسية واجتماعية خاصة بها تميزها عن غيرها من اللغات الأخرى، وتمثل لسان جماعة بشرية ما قد تتميز بها الجماعة عن غيرها من الجماعات البشرية الأخرى. والهوية اللغوية بهذا المعنى تظهر بمظهرين: مظهر ذاتي تعبر به عن كيانها اللغوي ووجودها وحقيقة هذا الوجود بين اللغات، ومظهر آخر موضوعي تعبر به عن القوم الذي ينطق بها ويعبر بها عن أغراضه وعن هويته الثقافية والتاريخية والدينية وغيرها. فاللغة العربية علوم ونسق من الألفاظ والاشتقاقات والأساليب والعلاقات والروابط المنطقية والسيكولوجية والقواعد لها أصلها وتاريخها ودورها ومكانتها. علوم اللغة ونسقها يُعبِّران عن هوية اللغة العربية، ويحملان تراث وثقافة وتاريخ وتطلعات الجماعة البشرية في الحاضر والماضي، فهي ذات هوية مزدوجة: هوية لغوية ذاتية وهوية اجتماعية وإنسانية.
شهدت اللغة العربية تغييرات ملحوظة على مستوى المفردات نتيجة التفاعل مع الإعلام الرقمي وانتشار التكنولوجيا في ظل غياب الرقابة اللغوية وافتقار منصات التواصل الاجتماعي لآليات الرقابة اللغوية مما أدى إلى تفشي الأخطاء اللغوية وإلى تدهور وعي المجتمع بأهمية اللغة الفصحى واستخدامها بشكل سليم. وهذه التغييرات تظهر مرونة اللغة العربية في استيعاب المصطلحات المستحدثة، لكنها تطرح في الوقت ذاته تداعيات جدية تتعلق بتهديد الهوية اللغوية لاسيما إذا لم يتم ضبط هذه التحولات وإخضاعها لعمليات التعريب، بما يتماشى مع خصوصيات اللغة العربية. وبالإمكان تحليل هذه التأثيرات وفق الأمور التالية:
-
استحداث كلمات جديدة: أدى انتشار وسائل التكنولوجيا والإنترنت إلى دخول مجموعة من الكلمات أو المصطلحات الجديدة التي أصبحت جزءًا من الاستخدام اليومي للمجتمع العربي الرقمي، مثل: كلمة( بوست) التي تشير إلى المنشورات الرقمية، وكلمة (تويت) المستخدمة في التغريدات على منصة تويتر، وكلمة (لايك) للدلالة على التفاعل الإيجابي مع المحتوى المنشور. فاستيراد واستعمال هذه الكلمات ونظائرها يبين اختراق المصطلحات الأجنبية لبيئة اللغة العربية. فبالرغم من أن هذه المصطلحات تُشير إلى مفاهيم تقنية حديثة، إلا أن عدم معالجتها بالتعريب يؤدي إلى طمس المفردات ويؤدي إلى إهمال مفردات اللغة العربية الأصيلة ومما يؤثر على ثراء اللغة العربية. وهذا يتطلب توعية مجتمعية رقمية في الحفاظ على أصالة اللغة العربية، وكذلك تطوير استراتيجيات لتعريب المصطلحات التقنية بما يحفظ هوية اللغة العربية.
-
الاقتراض في اللغة: تزداد عمليات الاقتراض في اللغة (الاقتراض اللغوي) نتيجة العولمة الثقافية والهيمنة التكنولوجية الرقمية للغات الأجنبية وحاكمية السيميولوجيا (العلامة) باستخدام كلمات ورموز أجنبية بصيغتها الأصلية أو بحروف عربية مثل (أونلاين) التي تشير إلى الاتصال عبر الإنترنت، وكلمة (share) “شارك” وهذا ما يحصل في سياق مشاركة منشور أو محتوى رقمي معين. وهذا الواقع يمثل تحديًا مزدوجًا وهو فقدان مفردات اللغة العربية من جهة، وخطر تآكل هوية اللغة من جهة أخرى.
-
المصطلحات التقنية الجديدة: ظهرت في البيئة الرقمية مجموعة من المصطلحات التقنية التي لم تكن معروفة من قبل، لكنها أصبحت متداولة بشكل واسع، مثل كلمة (هاشتاغ) أو (ترند) التي تشير إلى الموضوعات الشائعة، وكذلك مصطلح (لايف) live للدلالة على البث المباشر. فهذه المصطلحات تعد من أنماط الحياة الرقمية الحديثة، لكنها تحتاج إلى حلول لغوية عربية من ضمنها المحافظة على هوية اللغة العربية.
-
الاختصارات: استخدم الإعلام الرقمي منظومة تعبيرية جديدة في التعبير اللغوي تركز على السهولة والسرعة بدلًا من الدقة وجماليات اللغة، وتؤدي إلى تصاعد دور اللغة الوظيفية على حساب اللغة الجمالية التي تبرز قيمة الفصحى وذلك استجابة لطبيعة النصوص الرقمية التي تتسم بالاختصار والسرعة. فأصبحت الاختصارات ظاهرة شائعة وغالبًا ما تستعير من اللغات الأجنبية.
-
الأخطاء الإملائية: يؤدي الاستخدام غير المنضبط للغة في الوسائط الرقمية إلى انتشار الأخطاء الإملائية، مما يضعف جودة النصوص المكتوبة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك في كتابة الهمزات والتنوين والخلط بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة. وتزداد هذه المسألة تعقيدًا بسبب ضعف الكتابة باللغة العربية، حيث إن هناك الكثير من المنصات الرقمية التي لا تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار أو عدم تمكين خيارات تشكيل الحروف، مما يقلل من جودة الحروف المكتوبة بالعربية ويضعف تجربة المستخدم. يضاف إلى ذلك ندرة الأدوات التكنولوجية المتخصصة بالمقارنة مع اللغات الأخرى، حيث تعاني اللغة العربية هكذا تكنولوجيا مثل المدققات اللغوي (11).
وبالإمكان القول: إن التغيرات التي أحدثها المحتوى الرقمي على مستوى المفردات والمصطلحات والتحولات المفرداتية التي طرأت بالفعل على الإعلام الرقمي تعد دليلًا على مرونة اللغة العربية وقدرتها على التكييف مع المستجدات التقنية والرقمية والثقافية. كما أن التوسع في استخدام الكلمات المستحدثة والمقترضة يسلط الضوء على تحديات جوهرية تتعلق بموازنة التجديد مع الحفاظ على الهوية اللغوية، وتثير مخاوف حول قدرة اللغة في الحفاظ على هويتها أمام الزحف التكنولوجي المتسارع، إذ إن الاعتماد المطلق والمفرط على المفردات المستعارة دون عملية تعريب مُحكمة سيؤدي إلى إفقار المعجم العربي وإضعاف بنيته الفصيحة.
تعد اللغة أداة محورية للتعبير عن الهوية الثقافية وحاملة لقيمها ومعارفها. ونظرًا لطبيعة بيئة الإعلام الرقمي التي تفرض طبيعة تواصلية تتسم بالسرعة والفورية، فقد أدى ذلك إلى تغييرات جوهرية في قواعد اللغة الفصيحة، وتمثلت هذه التغيرات في التحولات النحوية في النصوص الرقمية التي تميل نحو تبسيط التراكيب النحوية، حيث تفضل الجمل القصيرة والمقتضبة التي تعبر عن الأفكار بسرعة ودون تعقيد وتوصل رسائل المستخدمين بكلمات مختصرة كرسائل التهنئة وغيرها(12). بعد عرض هذه الإشكاليات، تتبين أهمية تعريب المصطلحات التقنية الحديثة بالتعاون مع المجامع اللغوية لتطوير بدائل عربية للمصطلحات التقنية الشائعة، وكذلك إطلاق قواميس رقمية حديثة تحتوي مصطلحات عربية معربة مع شرح استخدامها الصحيح، والتوعية باستخدام المفردات الفصيحة من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف جمهور الإعلام الرقمي لتشجيع استخدام الكلمات الفصيحة بدلًا من الكلمات الأجنبية أو الهجينة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في دعم نشر مفردات عربية أصيلة في النصوص الرقمية، وكذلك دعم الابتكار في اللغة عبر اقتراح مصطلحات جديدة تتناسب مع الاستخدام الرقمي مع الحفاظ على أصالة اللغة، وتعزيز التفاعل مع الجمهور من خلال إقامة المسابقات على استخدام الكلمات العربية الفصيحة.
الاستنتاجات
المقال يسلط الضوء على إشكالية عميقة تتجاوز الشكل إلى المضمون: كيف نحافظ على الهوية اللغوية في عصر الصورة؟ والنقد هنا لا يرفض الصورة، بل يدعو إلى تكاملها مع الكلمة، بحيث لا تكون الصورة بديلًا عن المعنى، بل وسيلة لتعزيزه. كما يدعو إلى إعادة الاعتبار للفصحى في الإعلام الرقمي، ليس عبر التلقين، بل من خلال الإبداع والتجديد.
-
يُظهر الإعلام الرقمي تحوّلًا جذريًا في أدوات التعبير، حيث أصبحت الصورة تتصدر المشهد الاتصالي، مما أدى إلى تراجع دور الكلمة بوصفها ناقلًا أساسيًا للمعنى.
-
هذا التحول خلق نوعًا من الصراع الهوياتي، إذ باتت اللغة العربية بوصفها اللغة المستهدفة في مجتمعاتنا المحلية مهددة بالتهميش لصالح لغة الصورة أو اللغات العالمية، مما يضعف الخصوصية الثقافية.
-
رغم أن الكلمة تمتلك مرونة عالية في التكيف مع الوسائط الرقمية، إلا أن هذه المرونة قد تؤدي إلى فقدانها لعمقها الرمزي والدلالي الأصلي إذا لم تُوظف بوعي.
-
العلاقة بين المتلقي والمحتوى الإعلامي أصبحت أكثر تفاعلية، لكنها أيضًا أكثر عرضة للتأثيرات السطحية، مما يستدعي إعادة تقييم أدوات التعبير اللغوي والبصري.
التوصيات
-
ضرورة تعزيز الوعي اللغوي بالتدريب على اللغة العربية الفصيحة، وكذلك الوعي البصري بما يتلاءم مع السيميولوجيا الهادفة لدى صناع المحتوى الرقمي، لضمان إنتاج محتوى يحافظ على الهوية الثقافية ويوازن بين الصورة والكلمة.
-
دعم المبادرات التي تُعنى بإنتاج محتوى رقمي باللغة العربية كونها تمثل المادة المستهدفة، وتشجيع الاستخدام الإبداعي للكلمة في سياقات بصرية دون التفريط في معناها.
-
إدماج برامج تدريبية وتطويرية وأكاديمية تركز على فهم ديناميكيات الصورة وتعزز مكانة اللغة وأصالتها في الإعلام الرقمي، لتطور قدرة الأفراد على التعبير الواعي.
-
تشجيع البحوث التطبيقية التي تستكشف أثر الصورة على اللغة والهوية، وتقدم توصيات عملية لصياغة سياسات إعلامية تراعي التنوع الثقافي مع الحفاظ على أصالة اللغة.
المصادر
1- ينظر: هانس بيتر مارتين هارلد شومان: فخ العولمة،1996: عالم المعرفة- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت. ص52
2- ينظر : عبد الله عبد الخالق: العولمة وتأثيراتها السياسية والاقتصادية، ص2 المستقبل العربي ; العدد. المجلد 24، العدد 278 (30 نيسان 2002) الناشر. مركز دراسات الوحدة العربية
3- ينظر: أدمان، أروين: الفنون والإنسان مقدمة موجزة لعلم الجمال، 24/5 / 2021 ص 102
4- ينظر: الوز، د. هزوان: الإعلام: أدوار وإمبراطوريات ص 25 – 26.
5- ينظر: القصيبي، غازي عبد الرحمان: الغزو لثقافي، ص16.
6- ينظر: فريدريك جوانيو، «بودريار.. شاهد على اغتيال الواقع،» ترجمة شوق بن حسن، العربي الجديد، 2017/3/6، ص4، <https://bit.ly/2UgQLy6>.
7- ينظر: عبد الله الغذامي، الثقافة التلفزيونية: سقوط النخبة وبروز الشعبي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005)، ص 7.
8- ينظر: بن مراد، إبراهيم، في مسألة الاستعمال اللغوي في البرامج الإذاعية والتلفزيون، مجلة اتحاد إذاعات الدول العربية. عدد 2-2000 ص43.
9- ينظر: المصدر السابق، ص44.
10- ينظر: حسن حنفي، مقال بعنوان: الهوية والثقافة في الوطن، الرابط
11- ينظر :التويجري ،عبد العزيز بن عثمان، تاثير الاعلام المرئي والمسموع على اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (2021) 99-151-162
12- ينظر: الزيادي، لطفي محمد، اللغة العربية في وسائل والاتصال والتحول الرقمي، قراءة تاريخية وملاحظات انية مجلة البحوث الاعلامية (2021) 56(2) 702-677
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...