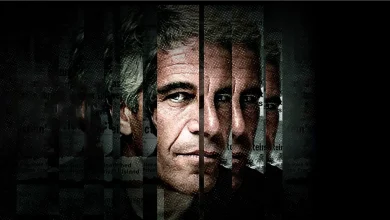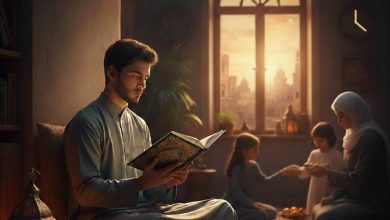مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
البطالة في معناها التقليدي تعني غياب العمل أو فقدان الدخل، لكنها في العراق تتخذ شكلاً آخر أكثر تعقيدًا وخطورة، هو البطالة المقنَّعة، وهي حالة يكون فيها الموظف حاضرًا جسديًا في مؤسسته، يتقاضى راتبًا شهريًا، لكنه في الواقع لا يقدّم إنتاجًا فعليًا يتناسب مع كلفته، أو يمارس عملاً يمكن أن يقوم به موظف واحد بدلاً من خمسة، هذه الظاهرة ليست مجرّد خلل إداري، بل انعكاس مباشر لبنية الاقتصاد العراقي الريعي، وللثقافة الاجتماعية التي جعلت الوظيفة الحكومية “غاية” لا وسيلة، وللسياسات السياسية التي استخدمت التوظيف الجماعي كأداة لامتصاص الاحتقان الشعبي وشراء الولاءات.
إنّ العراق اليوم يقف أمام مفارقة مؤلمة: بلد يمتلك ثروة نفطية هائلة، وطاقات بشرية فتية (أكثر من 60% من السكان دون سن الثلاثين)، ومع ذلك يعاني من نسب بطالة مرتفعة تتجاوز 15% وفق تقديرات منظمة العمل الدولية (2024)، فيما يعمل ما يقارب 38% من مجموع القوى العاملة في القطاع الحكومي المتضخم، الذي يستهلك أكثر من 40% من الموازنة العامة عبر الرواتب والتقاعد، تاركًا مساحة ضئيلة للاستثمار والخدمات، هذا الواقع يجعل البطالة المقنَّعة عبئًا مزدوجًا: تستنزف خزينة الدولة وتُفقِد المجتمع حافز الإبداع والعمل المنتج.
التضخم الوظيفي في العراق لا يرتبط بنمو اقتصادي حقيقي أو توسّع إنتاجي قادر على امتصاص العمالة وتوظيفها بفاعلية، بل هو انعكاس لسياسات الريع النفطي.
موقع العراق بين معايير التوظيف العالمي
تُظهر المؤشرات الدولية أن العراق يحتل مرتبة متقدمة جدًا عالميًا في نسب التوظيف بالقطاع العام، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط العراقية إلى أن ما يقارب 37% إلى 42% من مجموع القوى العاملة هم موظفون حكوميون، وهذه النسبة تعدّ مرتفعة للغاية إذا ما قورنت بالمعايير الدولية، فالمعدل العالمي للتوظيف الحكومي لا يتجاوز عادةً 11%، بينما يتراوح في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بين 18% و21% فقط، ويصل في الدول الإسكندنافية (مثل النرويج والسويد) إلى حدود 25–30% نتيجة لطبيعة نظمها الاجتماعية المتقدمة، وبمعنى آخر، فإن العراق يتجاوز متوسط التوظيف في الدول المتقدمة بما يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، بل إنه يتخطى حتى بعض الاقتصادات ذات الطابع الاجتماعي (كالنرويج) رغم افتقاره إلى ذات البنى المؤسسية والخدمية القوية التي تبرر مثل تلك النسب هناك.
هذا التضخم الوظيفي في العراق لا يرتبط بنمو اقتصادي حقيقي أو توسّع إنتاجي قادر على امتصاص العمالة وتوظيفها بفاعلية، بل هو انعكاس لسياسات الريع النفطي والاعتماد على الدولة كمصدر أساس للمعاش، وهو ما ولّد ما يُعرف بـالبطالة المقنّعة، حيث يُدرج آلاف الموظفين ضمن مؤسسات الدولة من دون وجود حاجة فعلية إليهم أو مهام إنتاجية واضحة، الأمر لا ينعكس فقط على كفاءة الجهاز الحكومي الذي يتضخم بالعدد مقابل ضعف المردود، بل يترك آثارًا عميقة على المستوى المالي من خلال استنزاف الموازنة العامة برواتب ضخمة تعيق الاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة (التعليم، البنى التحتية، الصحة) كما أن هذه الظاهرة لها بعد اجتماعي ونفسي خطير، إذ تعزز ثقافة الاتكالية لدى الأجيال الشابة وتضعف روح المبادرة الفردية والريادة، ما يرسّخ منطق “الوظيفة الحكومية” كخيار وحيد آمن بدلاً من تنمية القطاع الخاص أو تشجيع روح الابتكار.
وبالمقارنة مع التجارب العالمية، يمكن القول إن موقع العراق في سلم التوظيف الحكومي يمثّل حالة نادرة وغير قابلة للاستمرار، إذ يقترب من أعلى نسب عالمية دون أن يقابلها مستوى خدمات أو إنتاجية يتناسب مع هذا الحجم من الجهاز الوظيفي، وهذا يضعه أمام تحديات جدّية لإعادة هيكلة سوق العمل وتوجيه السياسات نحو موازنة بين القطاعين العام والخاص، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية ويحدّ من الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة المقنّعة.
جذور الظاهرة
-
الاقتصاد الريعي: اعتماد العراق شبه المطلق على عوائد النفط جعل الحكومة المصدر الأساس للتوظيف، بدل أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لسوق العمل.
-
المحاصصة السياسية: منذ عام 2003 ارتبطت التعيينات بالولاءات والانتماءات الحزبية والعشائرية، فصارت الوظائف وسيلة لتوزيع المكاسب أكثر منها وسيلة لبناء دولة فاعلة.
-
غياب بيئة أعمال جاذبة: ضعف القوانين الاستثمارية، الروتين الإداري، وانعدام الضمانات جعل القطاع الخاص عاجزًا عن امتصاص الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل.
-
ثقافة اجتماعية مترسخة: حيث باتت الوظيفة الحكومية رمزًا للاستقرار الاجتماعي حتى وإن كانت بلا معنى أو مردود إنتاجي.
الأبعاد الاجتماعية
-
البطالة المقنَّعة ليست مجرد أرقام في الموازنات، بل هي ظاهرة تُعيد تشكيل المجتمع وقيمه.
-
ثقافة الاتكالية: ينشأ جيل يرى أن “الوظيفة = راتب” لا “وظيفة = إنتاج”، مما يضعف روح المبادرة والعمل الحر.
-
تراجع ثقة المواطن بالمؤسسات: المواطن الذي يراجع دائرة حكومية مزدحمة ولا ينجز معاملته إلا بعد أيام يفقد الثقة بجدوى الخدمة العامة.
-
ضعف رأس المال الاجتماعي: حين لا يشعر الناس بأن وظائفهم تضيف قيمة، يتراجع الشعور بالانتماء إلى المؤسسة وإلى الدولة ككل.
-
هجرة الكفاءات: الكثير من العقول العراقية تفضّل الهجرة بحثًا عن بيئات عمل أكثر تقديرًا للجهد والإبداع.
الأبعاد النفسية
-
تُظهر الدراسات الحديثة أن البطالة (حتى المقنَّعة) ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاضطرابات النفسية.
-
الإحباط وفقدان المعنى: الموظف الذي يحضر يوميًا من دون مهام واضحة يعيش حالة “اغتراب وظيفي” شبيهة بالبطالة الحقيقية، تؤدي إلى فقدان الحافز وتراجع الرضا عن الذات.
-
القلق والاكتئاب: دراسات علمية (2022–2024) أثبتت أن التعطل عن العمل أو العمل غير المنتج يزيد من معدلات القلق والاكتئاب، بل ويؤثر على الصحة الجسدية.
-
تأثير ممتد على الأسرة: البطالة المقنَّعة تخلق نموذجًا غير صحي للأبناء، حيث يرون ذويهم في وظائف بلا جدوى، فيترسخ لديهم الإحساس بعدم قيمة العمل.
التوصيات
إلى الحكومة (مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة التخطيط):
-
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي عبر اعتماد توصيف وظيفي واضح، وإلغاء الوظائف المكررة أو غير الفاعلة، بما يقلل من الهدر المالي ويزيد الكفاءة.
-
تحويل الموظفين الفائضين إلى قطاعات حيوية تعاني نقصًا في الكوادر مثل التعليم (نقص المعلمين)، الصحة (نقص الكوادر الطبية والتمريضية)، التحول الرقمي (الحكومة الإلكترونية)، والبيئة (برامج مكافحة التلوث والتغير المناخي).
-
إصلاح نظام الرواتب بحيث يرتبط الأجر بالإنتاجية، مع تخصيص جزء من الراتب كمكافأة على الأداء، مما يحفز الموظفين على الإنجاز بدل الاكتفاء بالوجود الشكلي.
إلى مجلس النواب (اللجان الاقتصادية والمالية والعمل):
-
سنّ تشريعات داعمة للقطاع الخاص، عبر تعديل قوانين الاستثمار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
-
فرض رقابة برلمانية على آليات التوظيف الحكومي لمنع التسييس والمحاصصة التي تُكرّس البطالة المقنعة.
-
إقرار قوانين تمنح الشباب قروضًا صغيرة ومتوسطة بفوائد مخفّضة، مع رقابة على صرفها لتمويل مشاريع إنتاجية حقيقية.
إلى القطاع الخاص (اتحاد الصناعات، غرفة التجارة، البنوك):
-
الدخول في شراكات مع الحكومة لتشغيل الفائض من الخريجين ضمن مشاريع إنتاجية وخدمية.
-
إطلاق برامج تدريبية مهنية وتقنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد لملء الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
-
توفير حوافز ضريبية للمؤسسات التي توظّف الشباب وتقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
إلى الجامعات ومراكز التدريب:
-
إعادة تصميم المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات المطلوبة في السوق (البرمجة، الطاقة المتجددة، المهن التقنية).
-
إدخال برامج إعادة التأهيل للموظفين الحكوميين الذين يُنقلون إلى قطاعات جديدة، بما يضمن جاهزيتهم للعمل المنتج.
-
تعزيز التعليم المستمر عبر دورات قصيرة ومكثفة تخدم احتياجات السوق المتغيرة.
إلى الإعلام والمؤسسات التربوية:
-
إصلاح ثقافة العمل عبر حملات توعوية تبرز قيمة العمل المنتج، وتشجع الشباب على الانخراط في مشاريع ريادية بدل انتظار التعيين الحكومي.
-
دمج مفاهيم ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية لتعزيز روح المبادرة.
-
إنتاج محتوى إعلامي يقدّم نماذج شبابية ناجحة خارج الإطار الحكومي لكسر صورة الوظيفة الثابتة كخيار.
إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة:
-
تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي للباحثين عن عمل أو الموظفين العالقين في وظائف بلا معنى، لكسر دائرة الإحباط وفقدان الدافعية.
-
تأسيس مراكز استشارية داخل الجامعات ومؤسسات الدولة لمساعدة الشباب على التخطيط لمسارات مهنية بديلة.
-
دمج برامج الرعاية النفسية ضمن سياسات التشغيل الوطنية لتقليل الآثار السلبية للبطالة المقنعة.
الخاتمة
البطالة المقنَّعة في العراق ليست مشكلة قطاع أو مؤسسة، بل هي مرآة لأزمة التنمية الشاملة، فهي تكشف هشاشة الاقتصاد الريعي، وضعف القطاع الخاص، وانحراف مفهوم العمل من قيمة منتجة إلى مجرد ضمان مالي، إنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلب شجاعة سياسية لا تخشى مواجهة الواقع، ورؤية اقتصادية تؤمن بتنويع مصادر الدخل، وإرادة اجتماعية تعيد تعريف قيمة العمل، إننا أمام تحدٍّ لا يخص الموازنات فقط، بل يخص هوية المجتمع نفسه:
هل نريد أن يكون العمل وسيلة للعيش الكريم والبناء والإبداع؟ أم نتركه يتحول إلى حضور شكلي وراتب بلا أثر، يعمّق القلق النفسي ويزيد من التآكل الاجتماعي.
المصادر
-
Alnasrawi, A. (2021). Rentierism and disguised unemployment in Iraq: A political economy perspective. Middle East Economic Review, 15(2), 55–73.
-
International Labour Organization (ILO). (2020). World employment and social outlook 2020: Trends. Geneva: ILO. https://www.ilo.org
-
International Monetary Fund. (2023). Iraq: Selected issues paper (IMF Country Report No. 23/46). Washington, DC: International Monetary Fund. https://www.imf.org
-
Ministry of Planning – Republic of Iraq. (2022). Iraq labour force survey 2021. Baghdad: Central Statistical Organization.
-
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Government at a glance 2021. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1c258f55-en
-
United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Human development report: Iraq country analysis. New York: UNDP
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...