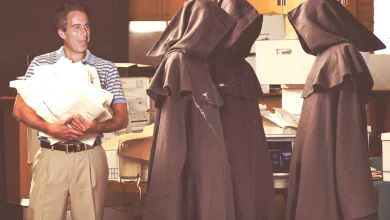مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
تُعدّ الشريعة الإسلامية أحد أهمّ المرتكزات التي نظّمت شؤون الأسرة والمجتمع عبر التاريخ الإسلامي، ليس فقط بوصفها نصوصاً دينية، بل كمنظومة متكاملة من القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تهدف إلى حماية الأسرة وتحقيق التوازن المجتمعي، وفي العراق، شهدت الساحة التشريعية جدلاً واسعاً عقب إقرار مسودة القانون الجعفري في مجلس النواب، والتي استندت إلى الفقه الإمامي الاثني عشري، لتغطي موضوعات الزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث. هذه الخطوة مثّلت عودة إلى النصوص الشرعية كمصدر أساسي للتشريع، وأثارت نقاشات بين مؤيدين رأوا فيها تعزيزاً للهوية الإسلامية وضماناً للاستقرار الاجتماعي، ومعارضين اعتبروها مصدراً لمزيد من الانقسام المذهبي.
غير أن قراءة اجتماعية ونفسية معمّقة لفقرات المسودة تكشف عن جملة من الفوائد، أهمها الحدّ من التفكك الأسري، ضبط العلاقات الزوجية، حماية حقوق الطفل، تحقيق العدالة في توزيع الثروة، إضافةً إلى تعزيز الهوية والانتماء النفسي للأفراد.
أولاً: الفوائد الاجتماعية لتطبيق الشرع الإسلامي
ينظر الشرع الإسلامي إلى الزواج باعتباره ميثاقاً غليظاً لا عقداً مدنياً محضاً، ما يمنح العلاقة الزوجية بُعداً مقدساً ينعكس على سلوك الطرفين، والقانون الجعفري يكرّس مفهوم المسؤولية المتبادلة، حيث يحدد حقوق الزوج وحقوق الزوجة بدقة، الأمر الذي يقلّل من مساحات الغموض التي تشكّل عادةً سبباً للنزاع.
ضبط الطلاق بشروط واضحة (مثل الطلاق بحضور الشاهدين والالتزام بمدد العدة) يسهم في الحد من الطلاق العشوائي الذي بات ظاهرة مقلقة في المجتمع العراقي، والإلزام بمساعي الإصلاح قبل الانفصال يُجبر الأطراف على التفكير ملياً، وهو ما يخفّف من آثار التفكك الأسري على الأطفال والمجتمع.
-
تنظيم الحضانة ورعاية الطفل
-
القانون الجعفري يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، لكنه يربط الحضانة بالبيئة التي تكفل التربية الدينية والأخلاقية السليمة.
-
اجتماعياً، هذا التوجه يحمي الطفل من أن يصبح أداة للصراع بين الوالدين، ويؤمّن له استقراراً تربوياً ونفسياً.
-
الشريعة الإسلامية وضعت قواعد محكمة للميراث، لا تخضع للأهواء الشخصية، وهو ما يقلّل من النزاعات القضائية بين الورثة.
-
توزيع الثروة وفق قاعدة “لكل ذي حق حقه” يرسّخ مفهوم التكافل العائلي، ويمنع احتكار الميراث أو استبعاده من الفئات الأضعف (كالنساء والأطفال).
ثانياً: الفوائد النفسية لتطبيق الشرع الإسلامي
-
الأمان النفسي والطمأنينة: عندما يدرك الأفراد أن حقوقهم محمية بقانون يستند إلى الشرع الإلهي، فإن ذلك يمنحهم شعوراً بالثقة ويقلّل من القلق المرتبط بالمحاكمات أو الاحتيال القانوني.
-
تعزيز الهوية والانتماء: انتماء الفرد إلى منظومة قانونية مستمدة من عقيدته يوفّر له شعوراً بالانسجام الداخلي، ويعزز الإحساس بالكرامة والانتماء للهوية الإسلامية.
-
الحد من النزاعات الأسرية الطويلة: القواعد الدقيقة التي يضعها الشرع بشأن الطلاق أو الحضانة تمنع طول أمد النزاعات، ما يخفف الضغوط النفسية على جميع الأطراف، وخاصة الأطفال.
ثالثاً: المحور التطبيقي– أثر القانون الجعفري على الواقع العراقي
-
الطلاق: تشير الإحصاءات الأخيرة في العراق إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل غير مسبوق، واعتماد النصوص الشرعية التي تشترط الإصلاح قبل الانفصال يمكن أن يقلل من هذه المعدلات، والتطبيق سيؤدي إلى استقرار نسبي في الأسر الشابة، إذ لن يكون الطلاق خياراً سريعاً متاحاً بلا ضوابط.
-
الحضانة: النزاعات حول حضانة الأطفال تعد من أكثر القضايا استنزافاً للمحاكم العراقية، وجود نصوص شرعية واضحة يقلل من النزاعات القانونية، ويضع مصلحة الطفل فوق الحسابات الشخصية.
-
الميراث: الكثير من القضايا العالقة في المحاكم المدنية تتعلق بالميراث، والقانون الجعفري سيضع حداً للتأويلات، عبر تطبيق قواعد الميراث الشرعي التي تُعد ملزمة وغير قابلة للطعن الشخصي.
-
الهوية الدينية: التطبيق العملي للقانون يعزز الشعور بأن التشريع متجذر في العقيدة الإسلامية، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. لكن هذا يتطلب صياغة آليات تطمين لبقية المكوّنات العراقية كي لا يشعروا بالإقصاء.
رابعاً: مكانة المرأة وحقوقها في القانون الإسلامي الجعفري
-
المرأة غير مُلزمة بالأعمال المنزلية
من منظور فقهي، المرأة غير ملزمة شرعًا بالقيام بأعمال المنزل كالطبخ والتنظيف والغسيل، بل هذه من مهام الزوج أو يتم توفير خادم/خادمة عند القدرة، ومسؤولية المرأة الأساسية هي الحفاظ على الأسرة ورعاية الأبناء من الناحية العاطفية والتربوية، لكن لا يوجد نص يلزمها بالقيام بالمهام المنزلية كواجب شرعي.
الرضاعة الطبيعية حق للطفل، لكنها ليست التزامًا شرعيًا على الأم إذا لم ترغب أو لم تستطع، وإذا امتنعت، على الأب أن يوفر مرضعة بأجر، وهذا يبين أن الشرع يحمي المرأة من الاستغلال الجسدي أو النفسي ويجعل قرار الرضاعة اختيارياً، مع ضمان حق الطفل.
ذمة المرأة المالية منفصلة عن الزوج كليًا، ولها الحق في التملك، الاستثمار، والإنفاق كما تشاء دون وصاية، والزوج ملزم بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية.
النفقة واجبة على الزوج: تشمل السكن، المأكل، الملبس، العلاج، وكل ما تحتاجه الزوجة بما يتناسب مع حاله المادي، وهذا يجعل المرأة في موقع أمان اقتصادي حتى لو لم تعمل.
-
الحضانة والرعاية العاطفية
الحضانة في الشريعة تُبنى على مبدأ مصلحة الطفل أولاً، والأم لها الحق في الحضانة بسنوات الطفولة المبكرة، لأنها الأقدر على منح الحنان والرعاية النفسية، وحتى عند وقوع الطلاق، يبقى للمرأة دور محوري لا يمكن إلغاؤه، بخلاف بعض القوانين المدنية التي قد تنتزع الحضانة بسرعة.
المهر ليس “ثمناً للزواج” كما يُشاع، بل هو حق تكريمي يثبت للمرأة ويؤكد مكانتها، ويُعد ضماناً مالياً لها في حال الانفصال.
-
الطلاق بضوابط تضمن الكرامة
الطلاق في الشريعة ليس فوضوياً، بل يمر بمراحل:
-
محاولات الإصلاح والتحكيم.
-
انتظار فترة العِدّة التي قد تسمح بمراجعة القرار.
-
ضمان حقوق المرأة المالية (نفقة العدة والمتعة).
-
هذا يمنع أن تُترك المرأة فجأة بلا سند كما قد يحدث في أنظمة أخرى.
-
منع الإكراه على الزواج
عقد الزواج باطل إذا تم بالإكراه، ورضا المرأة شرط أساس في صحة العقد، وهذا يحميها من الاستغلال الاجتماعي أو العشائري.
قد يُثار أن المرأة ترث نصف الرجل في بعض الحالات، لكن هناك تفاصيل مهمة، فالمرأة لا تتحمل النفقة على الأسرة، بينما الرجل مُلزم بذلك، ومن ثم نصيبها المالي في الميراث صافٍ لها، بينما نصيب الرجل مُوجه للإنفاق على الأسرة، هذا يعكس عدالة توزيع الأدوار لا تمييزاً.
وهذا توضيح حول ميراث المرأة
-
المرأة ترث أكثر من الرجل في بعض الحالات
-
الأم: إذا تُوفي الابن وترك والديه فقط، فالأم ترث ثلث التركة بينما الأب يرث الثلثين، لكن إذا كان للمتوفى أبناء، فالأم ترث السدس بينما الأب يرث الباقي مع الأبناء (المسؤولية المالية عليه).
-
البنت الواحدة: إذا توفي شخص وترك بنتًا واحدة فقط (دون إخوة ذكور)، ترث نصف التركة منفردة. ولو كان هناك أخ ذكر واحد فقط، فحينها يقسمان “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
-
الأخوات الشقيقات: في حالة عدم وجود ورثة ذكور، الأخوات قد يرثن أكثر أو كل التركة. مثلًا: إذا ترك الميت أختًا شقيقة واحدة فقط، فلها النصف، وإذا ترك اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان.
-
حالات مساواة المرأة مع الرجل
-
الأب والأم في حالة وجود أبناء: لكل واحد منهما السدس بالتساوي.
-
الأخ والأخت لأم: إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، يرث كل واحد منهما السدس بالتساوي، وإذا كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث بالتساوي دون تفريق بين ذكر وأنثى.
ج- الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة (للذكر مثل حظ الأنثيين)
هذه الحالة تخص الأبناء فقط (الإخوة الأشقاء أو غير الأشقاء)، حيث الرجل مُلزَم بالإنفاق على الأسرة، بينما المرأة لا تتحمل نفقة، ومن ثم ليس الهدف تفضيل الذكر على الأنثى، بل مراعاة العبء المالي الذي يُلقى على عاتقه.
-
صيانة الكرامة الإنسانية للمرأة
الشريعة تُلزم الرجل بحسن المعاشرة: “وعاشروهن بالمعروف”.
-
أي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي يُعد انتهاكًا للشرع.
-
وهذا بحد ذاته حماية قانونية وأخلاقية تعلو حتى على القوانين الوضعية.
الخاتمة
إن قراءة مسودة القانون الجعفري في ضوء المنظور الاجتماعي والنفسي تفتح الباب أمام فهم أعمق لطبيعة التشريع الإسلامي بوصفه منظومة قيمية وأخلاقية متكاملة، لا تقتصر على الأحكام الفقهية البحتة، بل تتجاوزها لتعكس فلسفة العدالة والتوازن في العلاقات الأسرية والمجتمعية؛ فالمسودة، بما تطرحه من تنظيم لأحكام الزواج والطلاق والحضانة والإرث، تعيد ربط القانون المدني بالمنابع الشرعية التي تستجيب لخصوصية المجتمع العراقي وهويته الدينية والثقافية.
لقد بيّنت المسودة أن المرأة ليست عنصرًا مهمّشًا كما يُشاع، بل هي طرف أساس في العقد الاجتماعي؛ إذ أكّدت على حقها في عدم الإجبار على أعمال المنزل أو الرضاعة، ووضعت أطرًا لصون كرامتها الإنسانية، أما في قضية الميراث، فقد أثبت النص القرآني أن المرأة لا ترث نصف الرجل في جميع الحالات كما يُتداول خطأً، بل هناك حالات ترث فيها أكثر من الرجل كالأم أو البنت المنفردة أو الأخت الشقيقة، وأخرى تتساوى معه مثل ميراث الأبوين أو الإخوة لأم، إلى جانب حالات محدودة فقط ترث فيها نصف الرجل، وهو توزيع قائم على المسؤوليات المالية والاجتماعية وليس على معيار التفضيل النوعي، وهذا التنوع في صور الميراث يكشف أن العدالة في الشريعة ذات بعد اجتماعي متكامل يأخذ بالحسبان التكاليف المعيشية والواجبات الاقتصادية.
أما في مجال الحضانة والطلاق، فإن القانون الجعفري يعيد الاعتبار لمصلحة الطفل والأسرة معًا، حيث يوازن بين حق الأم في الرعاية وحق الأب في الوصاية والإنفاق، مانحًا الأسرة بنية قانونية أكثر استقرارًا ووضوحًا. كما أن نظام الطلاق وما يتضمنه من ضوابط زمنية وإجرائية يحول دون التفكك الأسري العاجل، ويتيح فرصًا للإصلاح والمراجعة النفسية والاجتماعية قبل الانفصال التام.
ومن زاوية أوسع، فإن تطبيق القوانين ذات المرجعية الإسلامية في العراق يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعكس الهوية الثقافية والدينية للأغلبية، كما أنه يقدّم بدائل تربوية ونفسية لمعالجة القلق الأسري والانقسام المجتمعي الناتج عن القوانين المستوردة التي قد لا تنسجم مع البنية الثقافية المحلية.
وبذلك يمكن القول إن القانون الجعفري– إذا طُبّق ضمن إطار من العدالة الدستورية والحوار المجتمعي– لا يمثل مجرد نص فقهي، بل هو مشروع لإعادة بناء منظومة الأسرة العراقية على أساس الرحمة والمودة والعدالة الاجتماعية، جامعًا بين النص الشرعي وروح العصر، ومحققًا توازنًا بين حقوق المرأة والرجل والطفل في إطار الأسرة والمجتمع.
المصادر
-
تقارير مجلس النواب العراقي (محاضر جلسات مناقشة مسودة القانون الجعفري، 2025).
-
دراسات منشورة في مجلة كلية القانون / جامعة بغداد، أعداد خاصة بالأحوال الشخصية (2019–2024).
-
الدليمي، عبد الجبار. القانون المدني العراقي وأثر الشريعة الإسلامية فيه. بغداد: دار الحرية للطباعة، 2017.
-
الربيعي، حسن. أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. بغداد: الجامعة المستنصرية، 2016.
-
عبد الله، كاظم. القانون الجعفري: دراسة تحليلية في ضوء فقه الإمام جعفر الصادق. بغداد: بيت الحكمة، 2018.
-
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.
-
الكبيسي، أحمد. فقه الأسرة بين الشريعة والقانون. دبي: دار البحوث، 2005.
-
مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري.
-
مدونة القانون الجعفري.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...