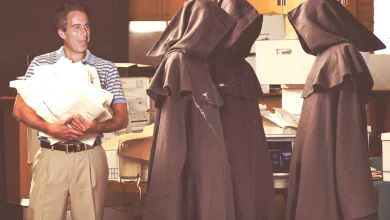بقلم: د. حسن هاشم حمود
باحث في مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
مر تاريخ العراق الحديث بتجارب حكم عديدة ابتداء من الحكم الملكي مرورًا بحكم العسكر والانقلابات العسكرية إلى حكومة البعث، لكن الحكومات التي تشكلت في العراق بعد 2003 مختلفة تمامًا عن الحكومات السابقة، لاسيما حكومات البعث التي بنيت وفق العقلية الاقصائية القبلية التي تؤمن بتهميش الآخرين وعدم فسح المجال امامهم للاشتراك في إدارة الحكم، والقائمة على سياسة الحزب الواحد والحكم الشمولي البوليسي الذي يؤمن باحتكار الحكم واختزاله بشخص واحد وباسرة واحدة وقبيلة واحدة وطائفة واحدة، وخلال مدة حكم هذه الحكومات لم تشهد اي تبادل سلمي للسلطة، بعكس ما هو قائم الأن على الرغم من بعض السلبيات فالحكم ما بعد 2003 يؤمن بالشراكة الوطنية وإدارة البلد من قبل جميع مكونات المجتمع من خلال نظام سياسي منظم وفق آلية انتخابية، وكل اربع سنوات يشهد عملية تبادل سلس وسلمي للسلطة عكس ما كان سائدًا وفق آلية تأبيد الحكم لشخص واحد.
لكن هذا لا يعني ان حكومات ما بعد 2003 حكومات مكتملة خالية من السلبيات، ومن اخطر مشكلات هذه الحكومات هي المحاصصة السياسية الارضائية التي لم تخلق معارضة سياسية حقيقية لممارسة دورها كمراقب وناقد للعمليات السلبية، ومن اعقد مشكلاتها وتحدياتها هو الفساد الذي يمثل خطرًا كبيرًا يهدد النظام السياسي ويمثل تحديًا كبيرًا امام عمل المؤسسات الحكومية، فالفساد يعد من اعقد المشكلات التي تواجهها كل دول العالم، لكن بصورة نسبية تختلف من دولة إلى أخرى، إذ انه يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلد ويعمق الفجوة الاجتماعية بين افراد المجتمع والقادة السياسيين التي تؤدي إلى فقدان الثقة ما بين أفراد المجتمع والحكومة، فضلًا عن انه يعزز الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، ومن ثم فرضت المحاصصة السياسية اشتراك الجميع بشبهات الفساد، وكل طائفة او قومية اشتركت في إدارة العملية السياسية بمنأى عن تهم الفساد، ولم يكن الفساد حكرًا على طائفة واحدة او جهة سياسية واحدة من دون الأخرى، لذلك اتى هذا المقال ليس للدفاع عن جهة دون أخرى وانما لتسليط الضوء على حالة بات البعض من أفراد المجتمع ينسب الفساد أو يستهدف طائفة تمثل المكون الاكبر ويختزل الفساد بسياسيي هذا الطائفة دون ان يوجه الاتهام إلى الآخرين من بقية الطوائف والقوميات المشاركة في إدارة الحكم.
الفساد وأنواعه
وردت كلمة الفساد في المعاجم اللغوية بمعنى الفساد نقيض الصلاح، وكذلك يقصد بالفساد التلف والعطب والاضطراب والخلل والجدب والقحط، ويعرفه البنك المركزي بأنه إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، ويعرف استاذ علم الاجتماع جون باديولو الفساد السياسي بوصفه المصالح المتبادلة بين النخب السياسية، إذ يتم اقحام العلاقات الاجتماعية في ميدان السياسة والإدارة ومختلف المؤسسات فتحصل المحاباة والعشائرية والزبونية ويشترط باديولو ضرورة ان تتوافر في هذا السلوك اربعة عناصر هي:
-
خرق وانتهاك القواعد والمعايير المشتركة والمصلحة العامة في المجتمع السياسي.
-
تبادل غير مشروع بين السوق السياسية (السلطة) والسوق الاقتصادية (المال) والسوق الاجتماعية (القيم).
-
منح الثروة للافراد والجماعات للاحتفاظ بالسلطة والتأثير في عمليات صنع القرارت السياسية والادارية العليا.
-
حصول ارباح ملموسة لأطراف المبادلة وامتيازات مادية أو رمزية.
اما أنواع الفساد فهي متعددة اهمها:
-
الرشوة: تمثل الرشوة اسوء صورة لقيام الموظف بسلوك يخل بواجبات الوظيفة العامة من اجل تحقيق المصلحة الشخصية لاستغلاله لمركزه الوظيفي والسلطات الممنوحة له مخلفًا خللًا بواجباته الوظيفية.
-
الكسب غير المشروع: وهو الثراء غير المشروع الذي يحققه شخص من جراء الفساد لاستغلاله لصفته الوظيفية نتيجة سلوكيات مخالفة للقانون.
-
الاختلاس: ويعني به قيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باختلاس مال أو اخفائه، سواء كان مالًا أم أوراقًا ثبوتية بحق مالي، فتكون حيازته لتلك الاموال بسبب وظيفته أو تكليفه بالخدمة العامة، إذ يقوم بأدخال هذه الاموال العامة التي هي تحت تصرفه إلى ملكه والتصرف بها وحرمان الدولة منها.
-
غسيل الأموال: ويتمثل بمجموعة عمليات مالية، يحاول الجاني فيها أن يعطي الصفة الشرعية لأموال قام باستحصالها بطرائق غير مشروعة من خلال اخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة.
-
هدر المال العام: هو كل فعل أو امتناع يصدر عن موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة يؤدي إلى إنفاق أو ضياع أموال الدولة أو ممتلكاتها بغير وجه حق، سواء كان ذلك عمدًا أو إهمالًا جسيمًا.
المحاصصة السياسية
الحكومات التي تشكلت بعد 2003 رسمت لنفسها عرفًا سياسيًا واعدته معيارًا جديدًا في إدارة السلطة السياسية في البلاد وان لم ينص عليه الدستور لا صراحة ولا ضمنًا، وهو مبدأ توزيع السلطات بطريقة توافقية ارضائية، وأصبحت كأنها جزءًا مكمّلًا من العملية السياسية بما تتكون منه إجراءات وآليات عمل، وبذلك اصبح التوزيع الطائفي والقومي للسلطة، عرفًا مكملًا لسير العملية السياسية التي قامت على اسس عدة مثل (التعددية الحزبية، فصل السلطات)، وعلى الرغم من ان الدستور نص في المادة (1) من الباب الأول على أن جمهورية العراق دولة اتحادية .. نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي مما يوحي بما لا يدع مجالًا للشك ان الحكم في العراق بات كما يفترض على قاعدة حكم الاغلبية السياسية التي تحوز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان سواء كان حزبًا ام ائتلافًا يضم مجموعة من الاحزاب لتكون هي التي تشكل الحكومة وتنتخب رئيس الجمهورية، لكن واقع الحال خلاف ذلك تمامًا، لأن القاعدة المعمول بها في اعتماد مبدأ (المحاصصة الطائفية السياسية ) في توزيع المناصب والادوار كما مبين في الجدول التوزيع الوزاري في حكومة ابراهيم الجعفري في سنة 2005.
الطائفة – القومية
|
عدد الوزراء
|
النسبة المئوية
|
الشيعة العرب
|
16
|
50
|
الأكراد
|
8
|
25
|
السنة العرب
|
6
|
18،8
|
المسيحيون
|
1
|
3،1
|
التركمان
|
1
|
3،1
|
المجموع
|
32
|
100%
|
وسارت بقية الحكومات الأخرى التي تلت هذه الحكومة على هذا العرف السياسي على وفق مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع السلطات و الوزارات والمناصب الوظيفية، وبهذا رسمت المحاصصة السياسية خريطة طريق لإدارة الدولة على وفق نظام ما يسمى الديمقراطية التوافقية التي تتيح التوافق في المشاركة السياسية، وانتج ذلك ما يسمى “بحق المكون” وبات الجميع يطالب بهذه المنافع والامتيازات كملكية خاصة للمكون مما جعل اثار هذه المحاصصة تؤثر على بناء مراكز ومناصب المؤسسات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن ثم امتد آثارها على جميع الاقسام والمراكز الفرعية لهذه المؤسسات، ليشمل جميع مؤسسات الدولة وإدارتها بصورة توافقية محاصصاتية، وفي هذا الصدد تزودنا افكار جابرييل الموند بتفسير منهجي في هذا الشأن، إذ يرى في تحليله للديمقراطيات الليبرالية الأنكلو- امريكية ان الطابع الغالب على إدارتها للعملية السياسية هو طابع إدارة اللعبة وليس طابع إدارة الصراع، بحكم ميل الثقافة السياسية للمشاركين فيها إلى ان تكون متجانسة وبراجماتية، في حين ان إدارة العملية الديمقراطية التوافقية في العراق تمثل إدارة صراع من أجل تحقيق مصالح فئوية وحزبية ومكوناتية تنتهج سياسات التعطيل والتواقف بدلًا من التوافق في ادارة العمل السياسي، لان معظم المشتركين في العمل السياسي وضعوا مجموعة من الأهداف التي يسعون الى تحقيقها على حساب الوطن والمواطن، وينتج بذلك منهج للتعطيل والتواقف بين الكتل البرلمانية لا يمكن أن يمرّ قانونٌ أو يُجرى تصويتٌ على قضيةٍ ما، إلا بعد أن يُسمح بامتيازٍ ما لمكوّنٍ معيّن أو لكتلةٍ سياسية، وحتى فيما يخص القضايا السيادية التي تمس سيادة الوطن، وهكذا تجري سيرورة العمل السياسي التوافقي في العراق.
الفساد كظاهرة اجتماعية عابرة للطوائف والقوميات
تشير التقارير السنوية الصادرة عن هيئة النزاهة العراقية إلى أن الفساد السياسي لم يكن مقصورًا على طائفة أو قومية أو كتلة سياسية بعينها، بل شمل مختلف المكوّنات المشاركة في العملية السياسية، إذ أظهرت حالات الاستقدام التي نفذتها هيئة النزاهة لعددٍ كبيرٍ من المسؤولين بدرجة وزير أو ما دونها من أصحاب الدرجات الخاصة، ففي تقريرها السنوي لعام 2024 بلغ عدد حالات الاستقدام ممن كانوا بمنصب وزير وممن هم بدرجته قرابة (44) فرداً وبلغت عدد التهم (65) تهمة، في حين بلغ عدد الاستقدام لذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم (338) فرداً، وعدد التهم كان (577) تهمة، بينما بلغ عدد الاستقدام بحق ممن هم دون ذلك (19917) فرداً، وعدد التهم (27892) تهمة، وعلى الرغم من إنَّ الهيأةَ تُقدِّم تقريرًا سنويًا يشمل أعدادًا جديدة من الاستقدامات لقضايا فساد أخرى لأشخاص آخرين، ومن ثم هذه الاعداد من الاستقدامات تجاه هذه المناصب لم تكن من طائفة واحدة أو من مكون وقومية واحدة أو لكتلة سياسية واحدة، بل شمل خليط متنوع التوجهات السياسية والقومية والمذهبية، وبهذا لا يقتصر الفساد على مذهب محدد أو قومية محددة بل بات يمثل ظاهرة عابرة للهويات والانتماءات.
وبناءً على هذه المعطيات، لا يمكن حصر الفساد في شريحة سياسية محددة مثل السياسيين الشيعة فقط، إذ تشير شواهد عديدة إلى تورط شخصيات سياسية أخرى من مختلف المكوّنات، إذ تحدث بعض الساسة غير الشيعة، على سبيل المثال، عن صعود شخصيات سنية لم تكن قبل عام 2003 ذات حضور سياسي أو اقتصادي مؤثر، لكنها بعد دخولها المعترك السياسي استطاعت تكوين ثروات ضخمة من خلال استغلال النفوذ والسيطرة على المشاريع والعقود، وكذلك بعض الشخصيات السياسية الأخرى من قوميات مختلفة، وتتكرر النماذج التي تكشف تضخم الثروات بشكل لافت، سواء عبر امتلاك عقارات وشركات داخل العراق أو عبر استثمارات وأرصدة مالية خارجية، لاسيما في بعض دول الخليج، وهذه المؤشرات تجعل شبهات الفساد حاضرة بقوة في كيفية تراكم تلك الثروات خلال مدة زمنية قصيرة، وهو ما أقرّ به بعض السياسيين البارزين من مختلف المرجعيات السياسية والمذهبية في أكثر من لقاء إعلامي.
الإعلام وادلجة الوعي الجمعي
الاعلام كسلطة رابعة يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام وصناعة الوعي الجمعي، غير أن هذا الدور قد يتحول إلى اداة للأدلجة عندما يتم توجيه الرسائل الإعلامية بما يخدم أجندات سياسية أو حزبية محددة، ومن أبرز صور هذه الأدلجة ما يظهر في التركيز الإعلامي على اتهام جهة سياسية معينة بالفساد، مع تبرئة أو تجاهل أدوار الأطراف الأخرى المشاركة في الممارسات نفسها هذا التوجه يسهم في إنتاج وعي جمعي منحاز وغير متوازن.
ومع إزدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تضاعفت عمليات الاستهلاك الثقافي السطحي الذي يخلو من النقد العقلاني، بدأ الجمهور يعتمد على ما يُنقل في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ويتقبلها كمسلمات، دون إخضاعه لعملية تحليلية نقدية، هذا الأمر أتاح للبروباغندا الإعلامية والمحتوى الدعائي المصمم عمدًا للتلاعب بالعقول، مساحة واسعة للسيطرة على المجال العام، وتوجيه الجمهور نحو تصور مفاده أن الفساد مختزل بمكون سياسي واحد، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الكتل السياسية متورطة في الفساد من خلال ممارسات المحاصصة والتوزيع التوافقي للسلطة، ما يجعل الوزارات والمؤسسات ملكًا لمكونات معينة مع امتيازاتها، ومن مؤشرات ذلك ما حصل في تظاهرات تشرين التي كشفت عن إشكالية في وعي الجماهير، فبينما خرجت للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، جرى توجيهها في بعض الأحيان لحصر الفساد في طرف سياسي أو مكون واحد دون غيره وفي المقابل جرى استقبال أو التعامل مع بعض الشخصيات السياسية من الطوائف والقوميات الأخرى بوصفها “رموز نزاهة”، على الرغم من امتلاكها لثروات وشركات وتعاملات خارجية وممتلكات يصعب تفسيرها بوسائل مشروعة، وهو ما يسلط الضوء على إشكالية ازدواجية الخطاب والتصور الجماهيري تجاه الفساد السياسي.
ومن أهم النظريات والتوجهات الفكرية التي تناولت دور الاعلام في صناعة الوعي المشوه.
-
نظرية وضع الأجندة (Agenda-Setting Theory)طورها ماكسويل مكومبس ودونالد شو، والتي تنص على أن الإعلام لا يقول للجماهير بماذا يفكرون، لكنه يخبرهم بما يجب أن يفكروا فيه، فعندما يركز الإعلام على فساد جهة سياسية معينة ويهمل غيرها، فإنه يزرع في العقل الجمعي فكرة أن هذه الجهة وحدها مصدر الفساد.
-
الإعلام كأداة للانتقائية: تقوم بعض الوسائل الإعلامية بممارسة انتقائية متعمدة في نقل الأخبار والتحقيقات المتعلقة بالفساد كتركيز الخطاب على مكوّن سياسي أو طائفي واحد، بينما يتم تجاهل أو التخفيف من حالات الفساد لدى الشركاء الآخرين في العملية السياسية، وهذه الانتقائية تخلق انطباعًا عامًا لدى الجمهور بأن الفساد محصور في جهة واحدة وهو مخالف للواقع.
-
التأطير الإعلامي للفساد: تعتمد وسائل الإعلام على التأطير (Framing)، حيث يتم تقديم الفساد ضمن قوالب لغوية ورمزية تُحمّل جهة بعينها مسؤولية الانهيار الإداري والاقتصادي، مما يوجّه العقل الجمعي إلى بناء صورة أحادية ومبسطة للواقع المعقد.
-
صناعة “كبش الفداء” السياسي: يلجأ الإعلام أحيانًا إلى تضخيم مسؤولية طرف محدد عن الفساد عبر آلية شيطنة (Demonization)، في حين يُغفل عن عمد أدوار الشركاء الآخرين، يؤدي ذلك إلى صناعة “كبش فداء سياسي” تتوجه إليه مشاعر الغضب الشعبي، وهو ما يتيح لبقية الأطراف الاستمرار في ممارساتها بعيدًا عن المساءلة، ومن ثم يؤدي هذا النمط من الأدلجة إلى إعادة تشكيل الوعي الجماهيري بحيث يُختزل الفساد في طرف محدد، ويُستثنى الآخرون من دائرة الاتهام، النتيجة هي إنتاج عقل جمعي منحاز يفتقر إلى النظرة الشمولية، مما يُضعف فرص الإصلاح الحقيقي، لأنه يغفل الطبيعة البنيوية للفساد بوصفه ظاهرة تشمل مختلف القوى السياسية.
الخاتمة
إن معظم أفراد المجتمع ينظرون إلى الفساد بعين واحدة ويُحملون سلبياته لجهة محددة، بسبب تأثير عمليات التسقيط والأدلجة الإعلامية التي اسهمت بشكل مباشر في إعادة تشكيل وعي الجماهير السياسية، بحيث يتحول إدراك الفساد من كونه ظاهرة بنيوية تشمل جميع القوى السياسية، إلى تصور مختزل يركز على جهة معينة دون غيرها، وهذا الانحياز الإعلامي يخلق وعيًا مشوهًا ويعزز الاستقطاب السياسي والطائفي، ويقلل من فرص المحاسبة الحقيقية، إذ يُوجَّه غضب الجمهور نحو “كبش فداء” محدد، بينما تستمر باقي الأطراف في ممارسة سياسات المحاصصة والتبعية دون رادع.
المصادر
-
جمهورية العراق هيئة النزاهة الاتحادية، التقرير السنوية لسنة 2024.
-
الحسيناوي، جعفر بهلول جابر، الأبعاد السياسية والاقتصادية لاحتلال العراق وانعكاساته على دول الجوار الإقليمي، آلية العلوم السياسية– جامعة النهرين رسالة ماجستيرفي العلوم السياسية قسم العلاقات الاقتصادية الدولية، 2013.
-
حيدر طالب محمد علي، مدخل للنزاهة ومكافحة الفساد في التشريعات العراقية والاتفاقيات الدولية، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021.
-
خريسان، د. عواطف علي، الفساد السياسي والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، بحث منشور مجلة اداب المستنصرية، العدد 103، مجلد 47، 2023.
-
العيثاوي، د. ياسين محمد حمد، الانعكاسات السلبية للمحاصصة السياسية على البنية المؤسسية والمجتمعية للنظام الديمقراطي في العراق، دراسات دولية، العدد 60، د.ت.
-
Cohen, Stanley. (2011). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers (40th anniversary ed.). New York: Routledge.
-
of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.
-
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” The Public Opinion Quarterly, 36(2),
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...