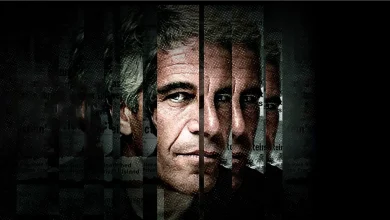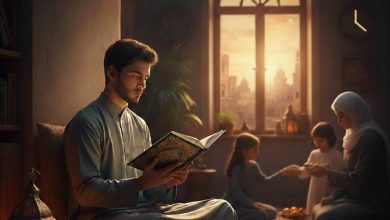بقلم: د. سمير محمد حميد
في زمنٍ تتقاطع فيه الخطابات وتتنازع فيه الأجندات على جسد المرأة وعقلها، لم تعد النسوية مجرد حركة منادية بالحقوق، بل تحوّلت إلى ساحة صراع رمزي تتداخل فيها مفاهيم التحرر، وسرديات الهيمنة، ومشاريع الاختراق الثقافي، وفي العراق تحديدًا، حيث تتشابك الجغرافيا بالتاريخ، والدين بالعشيرة، والسياسة بالمعاناة اليومية، برزت نسوية هجينة تتحدث بلسان الممول، لا بصرخة الأم، وتفاوض منظمات العون الدولي بدل أن تحاور الداخل المشوه، وتُطرح اليوم مشاريع مشبوهة مثل(تمكين) لا تنبع من حاجة المرأة العراقية، بل تُسقَط عليها من الخارج، محمّلة بمفاهيم مستعارة ومقولات لا تعبّر عن السياق الاجتماعي والقيمي العراقي العشائري العريق، بقدر ما تسعى لتغييره وفق تصوّرات نمطية ممزوجة بالعسل والسم تتحدث عن (التحرر) و(العدالة الجندرية). وهكذا يتضاعف مأزق النسوية بين خطاب ينكر الجذور بحجة التحديث، وآخر يجمّل القيود باسم الأصالة. فلا التحرر الخالي من القيم هو الصحيح ولا التقييد الذي يضيع حق المرأة هو الاصح، وبين هذا وذاك، تضيع التجربة الأنثوية الحقيقية، بما تحمله من تحديات مركّبة وشروط متضاربة. من هنا تنبع الحاجة إلى مساءلة جذرية أي نسوية نريد؟ وأي تحرر يُفترض أن نُطالب به؟ هل ما يُطرَح في الساحة العراقية من خطاب نسوي يمثّل النساء بالفعل، أم أنه يُوظَّف في مشاريع أوسع لا علاقة لها بالعدالة أو الكرامة؟ وهل يمكن للمرأة العراقية أن تستعيد صوتها الخاص، بعيدًا عن ضجيج الوصايات المتعددة؟ هذا المقال محاولة للاقتراب من هذه الأسئلة، عبر نقد ثنائي النسوية الحقيقية والزائفة، وتتبع آثار الخطاب المستورد في تشويه إمكانات التحرر المحلي.
النسوية الحقيقية أم الزائفة؟ نحو تحرر غير مشروط بالأجندات
يعد مصطلح النسوية جزءًا من الخطاب التنويري الذي ظهر في القرن التاسع عشر، وكان هدفه الأساسي هو نيل المرأة بعضًا من الحقوق العامة التي يتمتع بها الرجل، وقد احتل الاتجاه النسوي مركز الصدارة في الثقافة الغربية.(1) فالنسوية حركة تتسم بالتغير وتعدد الأوجه والجوانب والملامح، وتوصف بأنها نضال لإكساب المرأة المساواة في دنيا الثقافة التي يهيمن عليها الرجل، ومن الواضح إن مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة هو نفسه مفهوم مثير للجدل والخلاف منذ لحظة التأسيس الأولى لهذا المفهوم، سواء من حيث معناه أو دلالاته الدقيقة أو طرائق تحقيق هذه المساواة أو حتى طبيعة العراقيل التي تعترض المرأة في هذا الصدد. ولهذا فان النسوية بشكل عام عبارة عن جهد نظري او عملي يهدف الى مراجعة واستجواب او نقد او تعديل النظام السائد في البنيات الاجتماعية التي تجعل الرجل هو المركز(2) ولهذا ووفق هذا التعريف تواجه النسوية في العراق اليوم مفترقًا حادًّا بين خطاب يُفترض أنه يمثّل حاجات النساء للتحرر من القيود التي تكبل عمل المرأة الحقيقي النابع من القيم المتجذرة في الواقع العراقي، وآخر زائف، مشبع بالشعارات المستوردة والمفاهيم المعلبة والقيم الغريبة عن واقعنا الشرقي المحافظ، والخطاب المستورد يسعى إلى إعادة تشكيل المرأة بما يتلاءم مع أهداف تتجاوز قضايا النساء الثقافية والاجتماعية وحتى البايلوجية منها. وهذه المفارقة تطرح سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا في آن مفاده هل ما يُقدَّم باسم (تمكين المرأة) ينبع من حاجاتها الفعلية، أم أنه يُفرَض عليها من الخارج، ضمن مشاريع فوقية ممولة، تخضع لاعتبارات أيديولوجية عابرة للحدود؟ فالتحرر الحقيقي لا يُمنَح عبر التمويل، بل يُنتَزع من الداخل بما يتلاءم مع الداخل وقيمه وعاداته، وهو فعل تلقائي مرتبط بإرادة المرأة وكرامتها وحقها في الأمان وتكافؤ الفرص. أما التمكين، كما يُمارس في السياق العراقي، فهو مشروع موجّه، محدد الأطر، تسكنه نوايا سياسية وثقافية مشروطة بالدعم الخارجي. فكثير من النساء سواء في المدن العراقية المختلفة او حتى القرى والمناطق المهمشة لا يشعرن أن هذا التمكين يمثلهن، بل يرين فيه تهديدًا لهوياتهن، ومسخًا لخصوصيتهن، واغترابًا عن واقعهن المعاش، فالنسوية الحقيقية لا تتكلم بلغة المانحين، ولا تتصدر المؤتمرات الأممية، بل تعيش في تفاصيل الحياة اليومية نراها في المربية التي تصارع الجهل والفقر وتخرج جيل متعلم، وفي الأرملة التي تعيل أطفالها في ظل غياب المعيل وهي تلتزم بقيمها ودينها، كذلك في الطالبة التي تقاوم العوائق لتتعلم، وفي الطبيبة أو الناشطة التي تدافع عن نساء مجتمعها من داخل نسيجه لا بتمويل الخارج لتكون ضده. وهذه النسوية الحقيقية لا تحتاج إلى شعارات رنانة، بل تكتفي بفعل هادئ محافظ ومقاوم، ينبع من الوجع لا من ميزانيات المانحين.
لهذا تظهر النسوية الزائفة كصدى لخطابات غربية لا تمتّ إلى البيئة العراقية بصلة. وتتسم هذه النزعة بانفصال تام عن الواقع الشعبي والارث الحضاري العريق، وعدائية مستترة أو صريحة تجاه القيم المجتمعية العراقية (ومحاولة الغائها او مسخها)، وارتباط عضوي بمراكز تمويل أجنبية تُحدِّد أولوياتها حسب خرائط سياسية لا تراعي التكوين الاجتماعي المحلي العراقي. والأدهى في هذه الحركة، أن هذا الخطاب يبقى غائبًا عن مواقع التأثير الفعلي، مستهلكًا في الإعلام والنشاط الموسمي، بعيدًا عن ميادين العمل، التعليم، الصحة، والأسواق. ومع ذلك، فإن إمكانية بناء نسوية عراقية محلية، متجذرة في الواقع، تظل قائمة شريطة ان لا يخرج عن السياق القيمي والديني للمجتمع. وشرطها كذلك أن تنبع من معرفة دقيقة بهواجس المرأة، وأن تتصالح مع منظومات الانتماء الجماعي دون أن تتخلى عن الكرامة الفردية، وأن ترفض وصاية المموّل لصالح سيادة الخطاب، وأن تستند إلى قيم العدالة لا إلى نماذج حداثوية منبتّة عن الجذور. تلك النسوية المرجوة لا تعادي الدين والعشيرة بوصفهما عائقين، بل تفتح معهما نقاشًا جادًّا حول الإصلاح الذي لا يعزل المرأة عن محوريتها في الحياة، ولا عن دورها الوظيفي الذي خلقت من اجله، لأن التغيير الحقيقي لا يكون بالقطيعة، بل بالتفاوض الواعي.
النسوية المستوردة كأداة لإعادة تشكيل المجتمع وتفكيك الهوية الاجتماعية العراقية
منذ عام 2003، شكّل المشهد النسوي في العراق ساحةً خصبة لتجاذبات أيديولوجية حادة، لعبت فيها المنظمات الدولية المشبوهة والجهات المانحة المجهولة الأهداف دورًا مركزيًا في إعادة توجيه مسار الخطاب النسوي، خارجًا عن سياقه المحلي ومتجاوزًا شروطه الثقافية والتاريخية. فالخطابات النسوية التي ظهرت في هذه المرحلة، وإن تغلفت بشعارات توهم السذج، إلا أنها في جوهرها انطلقت من خلفيات مفاهيمية لا تنتمي إلى التربة الاجتماعية العراقية، بل فُرضت بفعل اختراق ناعم تمارسه مؤسسات خارجية وبخطوات مدروسة، توظّف قضية المرأة كمدخل استراتيجي لإعادة تشكيل المجتمع وتفكيك بنيته القيمية بقيم جديدة لا تتلاءم مع العادات الموجودة. إن استيراد النماذج النسوية الجاهزة، كما طُوّرت في سياقات غربية ذات تطور تاريخي مغاير، لا يتجاهل الخصوصية العراقية فحسب، بل يعمد في كثير من الأحيان إلى تقويضها وتسفيهها باسم (العالمية) و(الحداثة). وفي هذا السياق، لم تعد النسوية مجرد حركة اجتماعية ذات مطالب إصلاحية، بل تحولت إلى مشروع احتلال ثقافي ناعم متكامل، يُعاد عبره إنتاج مفاهيم الجندر، والسلطة، والعلاقة بين الجنسين، بوسائل تفتقر إلى التفاعل العضوي مع الواقع المحلي. ولهذا فان الإشكال الأعمق لا يكمن فقط في المفاهيم المستوردة، بل في البُنى التي تدعمها والغاية من هذا الدعم. إذ أن التدفق المالي من مؤسسات مانحة خارجية، كثيرًا ما يُسهم في خلق نخبة نسوية ناطقة باسم المرأة العراقية، بينما هي في واقع الأمر ناطقة باسم أجندات دولية لا تعبّر عن الهدف السامي الحقيقي للنساء، بل تكتفي بإعادة تدوير قضايا رمزية لا تمسّ الجروح المفتوحة في جسد المجتمع.
وهكذا، تغدو النسوية المستوردة أداة مزدوجة فهي من جهة تمارس التفكيك الثقافي الناعم تحت غطاء حقوقي مدعوم بمصطلحات براقة، ومن جهة أخرى تُنتج هوية أنثوية هجينة، مقطوعة عن إرثها الديني والاجتماعي والقيمي، ما يؤدي إلى تآكل الهوية الاجتماعية، وزعزعة الثقة بالمنظومات المحلية التي كانت تمثّل رغم أعطابها إطارًا حيويًا لحماية المرأة والمجتمع معًا، وفي ظل هذه المعادلة المختلة، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة بناء خطاب نسوي محلي، ينبثق من واقع النساء العراقيات وتاريخهن وتجاربهن اليومية وقيمهن الاصيلة مراعي هذا الخطاب الاصالة العشائرية والدينية لهذه القيم ، لا أن يُفرض عليهن من مراكز إنتاج الخطاب الغربي. ولهذا فإن تحرير المرأة لا يتحقق بنقل النماذج الجاهزة، بل بإعادة اكتشاف الذات النسوية العراقية من داخلها، عبر مشروع تحرري حقيقي يتفاعل مع الثقافة لا يخاصمها، ويُصلح المجتمع لا يختزله أو يُفككه.
من التأسيس إلى التزييف مسار النسوية العراقية بين التاريخ والاختراق
لم تكن النسوية يومًا خطابًا موحدًا أو كيانًا صافياً خالياً من النزاعات الأيديولوجية، بل كانت منذ نشأتها ظاهرة متعددة المستويات، تتبدى في أشكال متباينة بين السياقات الغربية والمحلية. ففي حين تشكلت الموجة الأولى في الغرب كحركة قانونية تسعى لحقوق مدنية كالانتخاب والتعليم للمرأة، انتقلت لاحقًا إلى موجة ثانية أكثر راديكالية، طرحت أسئلة الجسد والجنسانية والعمل، قبل أن تنفجر في الموجة الثالثة التي أعادت مساءلة مركزية التجربة البيضاء الغربية، وطرحت نقدًا لخطابات التحرير الكولونيالي. ومن هنا نشأ السؤال المؤلم هل النسوية، كما وصلت إلى العراق، تمثل تحررًا ذاتيًا؟ أم أنها استنساخ لخطاب تمويلي– ثقافي مفارق للواقع؟
لم تتأخر بوادر النشاط النسوي في العراق بعد محاولة الاندماج مع الحركة التطورية الغربية، فمنذ أربعينيات القرن العشرين ظهرت منظمات كـ (رابطة المرأة العراقية)، وبدأت النساء اقتحام فضاءات تقليدية كانت محظورة فيما سبق، لطرح قضايا تمسّ صلب البنية الاجتماعية القائمة على النظام الأبوي المتجذر تاريخياً كالطلاق، الحضانة، العمل، والتعليم. غير أن هذه البدايات، رغم حيويتها، كانت نخبوية وعاجزة عن ترسيخ الخطاب التحرري الشعبي الذي اريد منها. وفي عهد عبد الكريم قاسم، وُضع قانون الأحوال الشخصية (1959) الذي شكّل لحظة تقدمية فارقة لهذه الحركات، لكنه ظل مشدودًا بين منطق الدولة الحداثي وهيمنة المرجعيات القيمية الاصيلة والدينية والتي كانت لاتزال قوية ومتجذرة في الواقع العراقي. ومع صعود حزب البعث، تم احتواء الخطاب النسوي السابق داخل مشروع قومي دعائي، أعاد تأميم جسد المرأة ضمن صور رمزية دعائية خاوية من المحتوى مثل (الأم المربية) و(المناضلة الوطنية) و (ام الشهيد) و(الماجدة)، دون منحها استقلالًا فكريًا أو تحرريًا حقيقيًا يرفع من مكانتها وفق القياس القيمي الأصيل، وكانت المرأة حاضرة بصريًا، وغائبة سياسيًا، فإما ان تقبل المرأة الخطاب الغربي بما يحمله من هوية ثقافية وقيمية دخيلة، او ان تبقى النساء رهائن لبنى الجهل القبلي– الحزبي والتي تعيد إنتاج العنف الرمزي والمادي ضد أجسادهن، باسم (الشرف) و(الهوية). وقد شكل الغزو الأميركي عام 2003 لحظة زلزالية، إذ فُتحت المساحات أمام دخول المنظمات النسوية المدنية الجديدة دون تمحيص لا من الهدف ولا من الخطاب المحمول معها، والأخطر من هذا كلها ان هذه المنظمات شاركت في صياغة الدستور والمشهد العام، مستعينة وبقوة بالدعم والتمويل الخارجي، وبدأت كذلك تُنتج خطابًا مستعارًا من النسوية الغربية النيو ليبرالية، منفصلًا عن حاجات المرأة العراقية الحقيقي. وتحولت مفاهيم (العدالة الجندرية) إلى شعار إعلامي، لا مشروع تحرري متجذر. كما وتم تسليع الجسد الأنثوي ضمن مقولات السوق الحر باطلاق شعارات تدعو ضمنا (الحرية الجنسية بدل الكرامة، والفردانية بدل الجماعة، والهُوية المعزولة بدل الموقع الاجتماعي المركب). فالنسوية بحركتها التي رُوّج لها بعد 2003، غالبًا ما سعت لتقويض البنى القيمية والدينية للمجتمع العراقي، دون مساءلة نقدية لها، مما ولّد تصادمًا لا تحررًا. ولم يكن الخطاب حواريًا بالمرة، بل تصادميًا مصمم خصيصا ضد الرجل، وضد الدين، وضد العائلة، وضد كل ما يشكّل بنية الانتماء الثقافي للمرأة. هكذا، استُخدمت المرأة كأداة لا كفاعل، وأُعيد إنتاجها كجسر عبور لأجندات عابرة للحدود، تفكك المجتمع باسم (التحرير)، دون أن تمنحه بديلًا أخلاقيًا أو قيميًا متماسكًا. ولهذا نرى إن أي نسوية عراقية حقيقية، لا يمكن أن تنبثق من (اجتماعات الخارج)، أو من (منابر المانحين)، بل من قاع التجربة النسائية اليومية والمتجلية بالأم التي تصارع الحياة دون معيل، والمعلمة التي تواجه الغزو القيمي لدى الجيل الجديد، والناشطة التي تحاور لا تهاجم. والنسوية الأصيلة لا تعني استيراد الصيغ الغربية، بل إعادة تأويل الهوية النسائية ضمن مشروع إنساني تحرري من القيود الجاهلية، والمبني على أساس أخلاقي، متجذر، ينشد العدالة لا القطيعة، والكرامة لا التسليع، والتكامل لا التناحر.
النسوية التحررية كأداة لاختراق البنى القيمية وإعادة تشكيل الجندر خارج السياق المحلي
اذن بعد العام 2003، شهد المشهد النسوي العراقي تحوّلات نوعية تجلّت في بروز تيارات نسوية تحررية اتخذت من الشعارات البراقة منطلقًا لخطابها العام. غير أنّ القراءة المنصفة والنقدية لهذا الخطاب تكشف عن طبيعته المتشظية، وارتباطه العميق بأجندات أيديولوجية تتقاطع مع التصورات الغربية للجندر والجسد والسلطة، وتتجاهل السياق العراقي المركّب، بما يتضمنه من مكونات دينية وثقافية وقيم عشائرية اصيلة. وعلى الرغم من أن هذه التيارات تُقدَّم باعتبارها مناصرة لحقوق المرأة، الا انها تنخرط في مشاريع تفكيك ممنهجة للبنى الرمزية والاجتماعية التي تشكّل عماد التوازن القيمي بين الجنسين. وتسعى هذه المقاربات النسوية إلى إعادة تعريف الأنوثة ضمن مفاهيم هجينة لا تنتمي إلى البيئة الثقافية المحلية، حيث تُصوَّر المرأة ككيان مكتفٍ بذاته، يُشجَّع على القطيعة مع الأسرة والزواج والدين والدور التربوي، لصالح نماذج سلوكية ووظيفية تستنسخ تصورات حداثية غربية حول الجندر، دون مراعاة الفروق البيولوجية والنفسية التي تميز المرأة عن الرجل. ويُلاحظ أن هذا التوجه لا ينشأ من تطور عضوي في الواقع الاجتماعي العراقي، بل يُعزى إلى تأثير مباشر وغير مباشر لمؤسسات دولية ومنظمات عابرة للحدود، تسعى إلى اختراق النسيج المحلي من خلال قضية المرأة. وفي هذا الإطار، تتجلى خطورة هذا التيار في تعاطيه مع الجسد الأنثوي بوصفه مجالًا للسيادة المطلقة، منفصلًا عن الأطر القيمية والدينية، مما يفضي إلى تسليع الجسد أو تسييسه تبعًا لمقتضيات خطاب لا يعكس الواقع العراقي، بل يستفزه ويصطدم به. وبهذا، تنزاح النسوية من كونها مشروعًا تحرريًا حقيقيًا إلى أداة تغريبية تُوظّف لتبرير التدخل الخارجي في البنية الاجتماعية، تحت شعار) تحسين وضع المرأة (.
نلاحظ في هذه القراءة النقدية أن هذه النسوية التحررية لا تشتبك فعليًا مع القيم السلبية السائدة في الواقع النسائي العراقي، بل تركز على نخب مدينية مرتبطة بشبكات تمويل خارجية، وتنشغل بقضايا نظرية مستوردة لا تلامس الجروح الواقعية للمرأة العراقية. إنها تعمل داخل فضاء رمزي مستورد، غالبًا ما يكون غريبًا عن السياق الاجتماعي المحلي، ما يجعلها حركة مفصولة عن الديناميات المجتمعية الحية، ومثيرة للشك في جذورها وخطابها وتمويلها. وإنّ اعتماد هذه التيارات على منطق الصراع المفتعل بين “المرأة” و”الرجل”، بدلًا من السعي إلى ترميم العلاقة الاجتماعية المتصدعة بين الطرفين، لا يؤدي إلى تحقيق العدالة، بل يكرّس التنافر، ويُقصي الخطاب النسوي الأصيل القائم على المرجعيات الثقافية المحلية. كما أن هذا التوجه يهدد استقرار البنية الاجتماعية من خلال تفكيك الروابط الأسرية ونقل سلطة التوجيه من العائلة إلى مؤسسات خارجية، مما يضاعف من هشاشة المجتمع بدل تمكين المرأة فعليًا ضمن سياقها الثقافي والاجتماعي.
الخطاب النسوي وتحديات الهوية الاجتماعية
يُعد تأثير الخطاب النسوي على الهوية الجماعية للمرأة قضية شائكة ومثيرة للجدل خصوصا في المجتمع العراقي والذي يمتاز بتركيبة ثقافية ودينية متجذرة، فبينما يهدف الخطاب النسوي إلى تمكين المرأة وتحقيق العدالة فإنه في كثير من الأحيان يتبنى نماذج تفكيكية تستند إلى مرجعيات غربية كما اوضحنا لا تتلاءم مع السياقات المحلية مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الطموح الفردي والانتماء الجماعي ويبدأ هذا الاختلال حين تَقدم المرأة على تبني خطاب لا يراعي شروط بيئتها الثقافية والاجتماعية مما يجعلها تنفصل تدريجيا عن واقعها وتفقد تدريجيا شعور الانتماء إلى جماعة تشكل هويتها الجماعية القائمة على التفاعل بين الدين واللغة والتقاليد والعلاقات الاجتماعية ويتفاقم هذا الانفصال عندما تُفسَّر رؤاها النسوية على أنها تمرد على القيم السائدة لا محاولة لتطويرها فيتحول موقعها الاجتماعي من حالة توافق إلى حالة اتهام ويغدو حضورها محل توجس لا شراكة ويتجلى هذا التحول في انفصال المرأة عن أسرتها ومجتمعها وظهور فجوة شعورية بين ما تطالب به من حريات وما تسمح به البيئة التي تنتمي إليها مما يضعها في منطقة توتر دائمة لا هي جزء من القديم ولا منسجمة مع الجديد.
ويُعيد هذا الخطاب بناء تصور المرأة لذاتها بوصفها كائنا كونيا بلا جذور وكأن الهوية لا تتطلب انتماءً ملموسًا بل تكفيها المعايير الحقوقية المطلقة، لكن هذا الطرح يهدد بفقدان الأسس التي تُشكّل تماسك الهوية إذ أن الانتماء الثقافي واللغوي والاجتماعي ليس عائقًا بل شرطًا لأي تمكين فعّال وهذا التصور المُفارق للواقع قد يؤدي إلى اغتراب لغوي وثقافي واجتماعي يظهر على شكل توتر نفسي وعزلة وقلق وجودي وشعور متزايد بعدم الانتماء وهو ما توثقه بعض الدراسات النفسية والاجتماعية خاصة في السير الذاتية النسائية العربية حيث تظهر حالات من الاكتئاب والعنوسة والشعور بالهجرة الداخلية بوصفها تداعيات لخطاب لا يوازن بين الحقوق والواقع ولا بين الفرد والمجتمع ويؤدي إلى تصدع في النسيج الاجتماعي والأسري، فالتمكين الحقيقي لا يتحقق بتفكيك الروابط الاجتماعية بل بإعادة تشكيلها ضمن أطر تراعي التقاليد دون أن تستسلم لها وتسعى للتغيير دون أن تهدم وهذا يفرض ضرورة مراجعة نقدية للخطاب النسوي السائد من داخل السياقات المحلية عبر أدوات معرفية واجتماعية تُعيد تعريف الحراك النسوي بما يتناسب مع تطلعات المرأة الواقعية وبما يسمح لها بالتعبير عن ذاتها دون أن تنسلخ عن انتمائها وبمفاهيم مصاغه محلياً لا مستوردة وجاهزة، ويبرز في هذا السياق دور الفضاءات الرقمية كمساحات ممكنة لمراجعة التصورات وتشكيل هوية نسوية متصالحة مع بيئتها قادرة على الجمع بين التمكين واحترام الخصوصية الثقافية مما يفتح أفقًا جديدًا لفهم النسوية ليس كحالة صدامية بل كأداة إصلاحية تسعى إلى تحقيق العدالة دون تهديد تماسك الهوية الجمعية.
الخاتمة
ليست معركة المرأة في العراق مع مجتمعها أو دينها أو تاريخها، بل مع الخطابات المفروضة التي تسعى إلى اجتثاثها من جذورها باسم التحرر. لقد حاولنا في هذا المقال ان نبين كيف يمكن للنسوية المستوردة أن تتحول إلى أداة تفكيك خفي تمسّ البنية الرمزية والثقافية للمجتمع، لا لتحرر المرأة بل لتُعيد تشكيلها وفق تصوّرات لا تُعبّر عنها. فالهوية النسائية ليست بناءً مجردًا، بل نسيج حيّ متداخل من الدين والعادات والانتماء والعلاقات، وكل محاولة لتجاوز هذا النسيج دون فهمه تُفضي إلى اغترابٍ نفسي واجتماعي، لا إلى تحررٍ أصيل. ومن منظور ديني– قيمي، فإن خطاب (الكونية) الذي يعزل المرأة عن أسرتها ومجتمعها، إنما يقدّم حرية بلا روح، وحقوقًا بلا مسؤولية، وتحررًا بلا انتماء. في المقابل، فإن النسوية التي تنبع من الداخل وتُصغي لصوت البيئة الثقافية، تُشكّل مسارًا إصلاحيًا لا تصادميًا، يُعيد التوازن بين الحق والواجب، بين الفرد والجماعة، وبين التقاليد والتجديد. إن الدعوة اليوم ليست إلى رفض كل خطاب نسوي، بل إلى غربلته وفق ميزان القيم الاجتماعية والدينية الأصيلة والحاجات الواقعية، حتى لا تُصبح المرأة العراقية مادة اختبار لأوهام مستوردة، بل فاعلة في مشروع تحرري حقيقي يُعيد المعنى والدور والكرامة. فكما لا يُبنى بيت بلا أساس، لا تُبنى حرية المرأة خارج سياقها الاجتماعي والديني والثقافي. وما نحتاجه اليوم ليس شعارات تمكين عابرة، بل نسوية حقيقية، ذات جذور، تعرف كيف تتحاور لا كيف تتصارع، وتعرف أن تحرير المرأة لا يعني فكّ ارتباطها بهويتها، بل إعادة تمكينها من داخلها.
المصادر
(1) مفهوم الفلسفة النسوية ومطلقاتها، لمياء شاكر مصطفي الحصري واخرون، المجلة العلمية بكلية الآداب جامعة طنطا، المجلد 2024، العدد 55، إبريل 2024، ص1.
(2) المصدر نفسه، ص12.
 Loading...
Loading...
 Loading...
Loading...